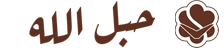بقلم الباحث الإسلامي:
عمرو الشاعر
قديمة –وقليلةٌ- هي الاعتراضات والإشكالات الفلسفية حول وجود الإله, وعلى رأس هذه الإشكاليات من حيث القوة والانتشار تأتي “إشكالية الشر”, فهي لا تقتصر على الفلاسفة, وإنما تتعدى إلى كل البشر تقريبا! كما أنها السبب الأكبر لإلحاد أكثر الملحدين أو لبُعد كثيرٍ من “المتدينين” عن الدين! ورغما عن أن العقل البشري لا يستطيع أن يتقبل بسهولة كون هذا الكون بلا خالق, إلا أنه مع هذه الإشكالية يتم قبول هذه الفرضية!! فما هذه الإشكالية؟
منذ قديم الزمان طرح أبيقور مجموعة من التساؤلات, والتي –من المفترض أنها- تفضي إلى القول بعدم وجود إله, فقال:
“هل يريد الله أن يمنع الشرّ لكنه لا يقدر؟ حينئذ هو ليس كلِّى القدرة!! هل يقدر لكنَّه لا يريد؟ حينئذ هو شرير!! هل يقدر ويريد؟ فمن أين يأتي الشر إذن؟ هل هو لا يقدر ولا يريد؟ فلماذا نطلق عليه الله إذن؟” اهـ
ولا يزال أكثر الملاحدة يتمسكون بهذه الصياغة الأبيقورية للإشكالية! وقبل أن أبدأ كلامي أقول: مبدئياً أميل إلى تسمية هذه الإشكالية ب “إشكالية العناية” وليس إشكالية الشر! وذلك لأن النصيب الأكبر من عامة البشرية ينظرون إلى المسألة من هذه الزاوية الخاصة, فهم لا ينظرون إليها بشكل عام كوني أصلي, وإنما ينظرون إليها من منظور “إنساني … شخصي”, وهو: بما أن “الرب/ الإله” خلقنا, وهو خير وقدير, فالمفترض أنه يرعانا ويحمينا ويُسلّمنا! (وإذا كان الوالدان قد يعجزان أحيانا عن حمايتنا أو تلبية احتياجاتنا, فالله القدير ليس كذلك حتماً), فلماذا يولد لي طفل معاق؟ ولماذا حدثت لي الحادثة الفلانية؟ نعم قد يعممون السؤال, فيتساءلون: “لماذا يرسل الله – أو يسمح ل- الأعاصير لتحطم بلداً بأكملها؟ ولماذا هذا العناء والبؤس في العالم؟” إلا أن الإشكالية لديهم ليست بالمقام الأول في وجود الأذى أو الضر في ذاته, وإنما في درجته وديمومته: لماذا يطول, لماذا يشتد, لماذا يعم؟ لماذا لا يتدخل الله لرفعه؟! وأبدأ ردي على الإشكالية الأبيقورية الشهيرة, فأقول: المنطق اليوناني منطق حدي ساذج! إن لم يكن كذا فسيكون كذا! إن لم يكن أبيضاً فهو أسود!!
وهذه الاستدلالات تبعاً لقواعد المنطق سليمة, ولكنها تبعاً للواقع غير سليمة, فهناك الكثير من الاحتمالات والإمكانيات بين الممكنَين, وهناك درجات كثيرة من الألوان بين الأبيض والأسود, بل إن الأبيض نفسه درجات!! ومن ثم فيمكن الرد على هذه الفرضية بإدراج درجة من الدرجات, وهي: الحكمة! فنقول: نعم الله كلي القدرة والعلم وهو خيرٌ محض, ولكن حكمته اقتضت أن يوجد “أذى وضر” في هذا العالم! وبما أن فرضيتي هذه “ممكنة ومعقولة” فإنها ترفع التناقض بين وجود الله و وجود “الشر”.
ومع احترامي لأبيقور فإن هذه الفرضية هي “فرضية طفولية”! وأعجب كيف لا تزال تُكرر حتى الآن, ويتمسك بها الملاحدة واضعين إياها في مرتبة مقدمة!! فهي لا تزال عن التفكير الطفولي: “أبي يمنع عني الشيكولاتة وغيرها من الأطعمة الطيبة (اللذائذ), أبي يسمح لشخص ما بشكل متكرر أن يعطيني إبرة/ (حقنة) (الألم), كما أنه يسقيني “أشربة” مريرة! لماذا يفعل هذا؟ لا أجد مبرراً لهذا سوى أن أبي شرير!!!” وقلّب فرضية أبيقور هذه كيفما شئت, لن تجدها تخرج قيد أنملة عن الفرضية الطفولية الساذجة هذه سوى أنها افترضت عدم وجود الإله وليس “شريريته”, لأن الإله لا يُقبل أن يكون شريراً! وطالما أنه قد وُجد الشر في الكون فليس ثمة إله!!! قد يقول قائل: لا, طبعاً هناك فارق كبير, وهو أن الأب “ناقص” محدود القدرات, فابنه تعرض للمرض ولم يستطع أن يجنبه هذا فاضطر إلى أن يأخذه للطبيب ليعالجه, بينما المفترض أن الإله مطلق القدرة, فهل عجز عن أن يوجد عالم خال من “الشر”؟!
فأقول: قبل أن أجيب هذا السؤال, أحب أن أتساءل: هل يوجد “شر” فعلاً في الكون؟ هل يوجد شيء اسمه “شر”؟ بطبيعة الحال لا يوجد, وإنما هو “نعت اعتباري” أطلقه الإنسان على أفعال أو أشياء بعينها صدرت بكيفية ما ليعطيها “وصفاً تأكيدياً” على خبثها وسوئها وأنها تخلو من الخير! والملاحظ أنه حتى هذه الأفعال لا يمكن الزعم دوماً أنها “شر”! فالقتل أو الحبس قد يكون عقاباً ولا يقال عنه أنه شر! والمجتمع يتقبل قتل السفاح الذي قتل عدداً من أفراده! وكذلك بتر الصدر أو أي جزء من أجزاء الإنسان قد يكون إنقاذاً لباقي أجزاء الجسم من مرض استشرى في هذا العضو, فلا يكون هذا البتر عقاباً ولا شراً بأي حال من الأحوال وإنما هو إنجاء للإنسان! (وعامة البشرية تفرق بين العديد من المصطلحات المتقاربة, مثل: الألم والأذى والضر والعقاب, … والشر).
فالعبرة عند عامة البشر ليس مجرد الفعل أو حدوث الشيء وإنما السبب أو الدافع والعاقبة, فقسوة المدرب على المتمرن مقبولة بل ومطلوبة, ليصبح اللاعب أقوى وأمرن, وطالما أنه عُدمت وسائل الإصلاح والتقويم إلا العقاب فهي مقبولة بل ومطلوبة, بينما قسوة صاحب العمل على العمال لديه وجعلهم يعملون في ظروف غير مناسبة ليوفر مالاً لنفسه وليربح أكثر يُمكن أن تُعد .. شرا! وكذلك إهانة المعلم طلبته لا ليعلمهم وإنما لينفس عن عقدة النقص بداخله يمكن أن تُنعت ب: الشر! إذا فالفعل نفسه كائناً ما كان لا يمكن أن يُعطى هذا النعت الإضافي “شر/ شرير”, إلا بعد معرفة أسبابه وعواقبه, (بينما بدون ذلك يُعطى نعوتا أخرى, فيمكن القول أن الإعدام “أذى وضر” للمجرم السفاح, وهو في عين الوقت “حماية وطمأنينة” للمجتمع, و “برد وسكينة” لأهالي الضحايا .. الخ النعوت).
بعد هذه المقدمة الضرورية أقول: ليس كل ما يفترضه العقل يكون صواباً أو حقاً, فقد يفترض العقل المحال, وقد يسأل أسئلة خاطئة من الأساس هي من باب التخليط ليس أكثر, فمن ذلك السؤال الشهير: هل يستطيع الله ألا يستطيع؟!! أو هل يستطيع أن يخلق صخرة جد عظيمة لدرجة أنه لا يستطيع رفعها؟!!!! هذه أسئلة متناقضة, فكل ما جاز في نفسه ولم يحله العقل, فهو ممكن ومن ثم يمكن أن تتسلط عليه القدرة الإلهية! بينما ما يحيله العقل, وليس له معنى في ذاته, فهو متناقض .. ومن ثم فلا مجال للسؤال عن قدرة أو عجز الإله عنه!! وبعد أن بيّنا أن الشر وصف إضافي اعتباري وبيّنا خطأ السؤال فينبغي علينا أن نعيد صياغة السؤال ليكون سليماً فيقال:
هل كان الله قادراً على أن يخلق كوناً خالياً من الأذى والضر؟ ومن ثم نقول بكل ثقة: نعم سبحانه كان قادراً على فعل هذا, ولكن: أي عالم سيكون ذاك؟ من منظوري سيكون عالماً فاقداً للمعنى .. وللطعم واللون والرائحة!! واسمح لي أن أعيد الكرة إلى ملعبك وأقول لك:
تخيل عالماً لا يمكن أن يحدث فيه أذى, من الأشخاص لبعضهم بعضاً أو من الأشخاص للأشياء والكائنات أو من الكائنات والأشياء للإنسان؟! ولا يقتصر الأمر على الأذى المباشر, فهناك الحمق وسوء التصرف والغفلة (وكم من نعمة رآها الإنسان نقمة, وكم من نعمة عمي عنها الإنسان فلم يرها أصلاً), الذين قد يؤدون إلى كوارث ونتائج أسوء من الأذى العمدي!! وأكثر ما يصيب الإنسان منها!! إن استطعت أن تتخيل مثل ذلك العالم فافعل وقدّمه لي وللبشرية جمعاء! إن ما يريده هؤلاء ليس ضرباً من العبث, وإنما هي “الشكل الأصيل” للعبث نفسه! وفيه يصدق قول الحكيم الخبير:
“وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ .. [المؤمنون : 71]”,
فهم يريدون الشيء ونقيضه! فهم يقرون بأن الإنسان “ناقص”, والنقص يترتب عليه –لامحالة- القابلية للخلل والأذى والفساد .. الخ! ولكنهم لا يتقبلون هذا! كما أنهم يقرون بأننا كبشر “متعددون متقاطعون”, ولسنا بشرياً واحداً أو لكل منا مسارات متوازية في الحياة لا تتقاطع, والتقاطع يقتضي التزاحم والتدافع لا محالة, ولكنهم في عين الوقت يريدون عالماً يخلو من التطاحن!! فالمفترض أن الناس في ذلك العالم الوهمي يتعايشون مع بعضهم, فإذا حاول أحدهم صفع أخيه, تتدخل “يد العناية” الإلهية لتمسك بيده وتردها بجوارها ويقول له الرب: لا تؤذ أخاك!! (وبطبيعة الحال لن يفهم الإنسان هذه الجملة, لأنه لا يعرف: الإيذاء, أصلاً, فلا يوجد في ذلك العالم إيذاء, ومن ثم لن تظهر مثل هذه المفردة ولا شبيهاتها!!) وإذا لم ينتبه الإنسان إلى النعمة, حولت “العناية الإلهية” رأسه إليها وقالت له: انتبه! هذه نعمة!! وإذا أساء الإنسان التصرف سمع صوتاً يقول: لا لا, هناك طرق أخرى يمكن أن يُفعل بها الشيء!! وإذا زاد الإنسان مثلاً من الطعام سيجد أن اللقيمات تتوقف فلا تدخل فاهه! مع تنبيهات: انتباه انتباه, أنت تتجاوز الحد المسموح به من الطعام!!
إن العالم الذي يريده هؤلاء هو “عالم الجبر”, حيث لا اختيار للإنسان, حيث الإنسان مجبور على التصرف بشكل معين, فيصبح مثل الآلة “الروبوت”, عالم يسوده القهر وينعدم فيه الاختيار!
ونذكرك عزيزي القارئ أنه –من المفترض- أن الكون كله –ما عدا الإنسان- مسير لا مخير, وشاءت إرادة الله أن يجعل الإنسان مخيراً وليس مسيرا! ومن ثم فإلغاء الأذى والضر لا يُتصور إلا بإلغاء الحرية الإنسانية, وهو ما لا يريده الله ولا نريده نحن!
فالاختيار الإنساني هو ما يعطي حياتنا معنى, وبدونه يضيع معنى الحياة!! فالإنسان باختياره الحر هو من يقرر أن يأكل حقوق إخوته البشر وهو من يحتكر البضائع بل ومن يرمي بها في البحر ليمتلئ “كرشه” وخزائنه, وهو باختياره من يقرر أن يتنازل عن ثرواته من أجل إخوته, وهو باختياره من يبيع مجتمعه بملاليم, وهو باختياره من يضحي بحياته من أجل المبادئ والحق! وهو من يقرر أن يُغرر بامرأة من أجل أن يصل لجسدها! وهي من تظل ترعى زوجها المريض القعيد … الخ! وهو المجنون الذي يقرر أن يحتل بلداً أو يضربها بالأسلحة الفتاكة, فتخوض الجيوش هنا وهناك الحروب المريرة! بينما تكتفي باقي شعوب الأرض, وخاصة الشعوب/ الحكومات الجيران بالصمت والمشاهدة وربما التدخل سرا للاستفادة والإجهاز على الجار لإضعافه أكثر وأكثر! وهو من يضع شروطاً في الاتفاقيات ويضع فوائد مضاعفة (ربا فاحش) على الدول الفقيرة, فتزداد فقراً على فقر, والحكام هم من يسرقون ثروات الشعوب حتى يوصلونها إلى المجاعات, وأصحاب المبادئ متفرقون ضعفاء بل ويتقاتلون فيما بينهم, بدلاً من أن يتحدوا ليزيحوا هذا الظلم المؤدي إلى الفقر والخراب!! وعامة البشر حولهم يشاهدون ويتقلبون في النعم والملذات!!
ومجدداً أعود فأقول: الإشكالية عند عامة البشر إشكالية “هوى العناية”, فهم يريدون الإله الذي يتدخل ليفعل لهم ويدافع عنهم, وإن لم يتخذوا هم خطوات, فتجد الملحد من هؤلاء يضع صورة أطفال في مجاعات ويتساءل بكل صلف: أين الله؟!! (ولا يريد هؤلاء أن يتخلوا عن تصوراتهم الطفولية للإله ودوره ويقتنعوا أن الله لن ينزل من عليائه ليغير الأحوال وإنما يغيرها بسننه وبخلقه وببني الإنسان! ولا بد أن يتخذوا هم من الخطوات ما يستحقون معه المدد الإلهي! فالرسول محمد مثلاً كان يدعو في بدر بالنصر بعد أن أعد العدة وجهز الجيش, وليس وهو جالس في بيته!! ويلخص هذا المقولة العامية الشهيرة التي تبين “فعل الرب”: “اسع يا عبد وأنا اسعى معاك) ومن ثم ففي مثل هذه المواقف ينبغي أن يكون السؤال: أين بنو الإنسان؟! ونُذكر في المقام بقول العليم الحكيم:
“… وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ [البقرة : 251]”,
فعندما يضعف التدافع يعم الفساد! قد يقول قائل: ربما يكون معك حق في “الشرور” التي يأتي بها الإنسان, ولكن لماذا أوجد الله “المرض” والألم أصلا, وماذا عن ما يصدر عنه هو, مثل الفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين, والتي يُهلك فيها الأعداد الكثيرة من البشر, بدون جريرة؟!! فأقول: شطر هذا السؤال إجابته في الإجابة السابقة, ولكن بشكل معكوس, فبدلاً من أن نجعل “يد العناية” هي التي تمنع الإنسان مباشرة, سنجعل الكون هو من يمنع الإنسان! فالكون غير قابل للفساد ولا للأذى! ومن ثم سيصل الإنسان إلى نتيجة من اثنتين: إما الجبر, فهو عندما يريد أن يفعل أشياء لا تستجيب, وإما العبثية, فهو يستطيع أن يفعل ما يشاء ولا يصيبه أذى أو ضر!! فيأكل ويشرب ما يشاء, فلن يصيبه أذى! ولن يحتاج إلى العمل ولا إلى التعاون, فلماذا يجد ويجتهد؟! فليأكل الحجر أو الصخر حتى! وليقفز من علٍ ولن يصيبه ضر .. الخ! وهكذا نصل إلى العبثية مرة أخرى! وبما أن وجود “القابلية للفساد” شرط ضروري لمنع العبثية, فإن المرض (كنوع من الخلل) سيظهر لا محالة, والمرض نفسه هو تنبيه على خطأ مسلك الإنسان, وإشارة له إلى ضلال سبيله وأن عليه الرجوع عنه, وكذلك الحال مع الفساد المجتمعي تنبيه إلى ضرورة تغيير المسلك:
“ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الروم : 41]””!!
والمرض إن لم يكن مصحوباً بمنبه ينبه إليه (ألمٍ أو ما شابه) ويدفعه إلى التداوي منه, فإنه سيستشري في جسد الإنسان حتى يهلكه (وعامة البشر لا يميلون إلى التداوي رغماً عن ذلك!!), وليس الله هو من جعل البشرية تنفق على السلاح أضعاف أضعاف ما تنفقه على اكتشاف علاجات للأمراض فيستمر ويتواصل الشقاء والعناء, ولك أن تتخيل كم من العلاجات التي ستظهر إلى الوجود, لو أُنفق على اكتشاف الأدوية فقط نصف ما يُنفق على السلاح! أما بخصوص مسألة الفيضانات والأعاصير … الخ, فأقول: نعم الله هو من يسير الطبيعة ولكن بقوانين وسنن, وليس أنه يعطي في كل لحظة أوامر متجددة لكل ذرة ريح وقطرة ماء أن تفعل كذا! وطالما أن المخلوقات الصغيرة قابلة للفساد والإيذاء فحتما ستكون الكبيرة كذلك, والإنسان يتعامل مع الطبيعة ويؤثر فيها منذ آلاف السنين, (وتأثيره هذا ليس منسجماً في الأعم الغالب مع سنن الله الكونية والتي لم يبدأ في الانتباه إلى بعضها إلا مؤخرا!) ونحن نكرر أن “حركة أجنحة فراشة في الصين قد تؤدي إلى إعصار مدمر في أمريكا بعد أسبوعين”, فما بالنا بالتدخل البشري الكاسح في الطبيعة والعبث بها من تلويث مياه وحرق غابات وتحويل مسارات أنهار وبناء سدود وتجريف أراضٍ وتقطيع غابات وإزالتها من الوجود ولا يتوقع أن يكون لهذا تأثير؟ وهذه الكوارث الكبيرة كانت بمثابة تحديات للبشر دفعتهم للتوحد للقدرة على مواجهتها, وأورثت هذه التحديات تقدماً علمياً .. بل وروحيا!! (وبالبلاء والفتن يُمحص الإيمان ويُجلى) وكم من “كوارث طبيعية” كانت سبباً في الهجرة من بلاد والانتقال إلى بلاد أخرى أرحب وأخصب ونشوء حضارات جديدة!
وكما يقال: كم من محنة في باطنها منحة! ولا يعني هذا أننا ننكر أن الرياح والفيضانات وغيرها قد تكون عقاباً من الله لبعض الأمم على فسادها وإفسادها فهذا ما كان ويكون بالتأكيد, ولكن لا يعني هذا أن يكون هذا هو التفسير الوحيد لها! (وبيّنت مسبقا في موضوع : لماذا الهلاك, على موقعي الشخصي, كيف أنه لا ظلم في هذا الإهلاك, وكيف أنه رحمة للبشرية, وكيف أنه حتمي لا محيص عنه, كما يمكن الرجوع كذلك إلى مقالي: سمارت كون, والذي بيّنت فيه كيف أن الله قد وضع قوانين ل “الطبيعة” لتدافع عن نفسها, ومن ذلك: القضاء على المجتمعات: الزومبية).
ولا يعني نزول العذاب بالأقوام أن الله غير رحيم, فالعذاب هو آخر الدواء بعدما لا تفلح كل السبل الأخرى ويستشري الفساد في المجتمع, وحتى في هذه اللحظة فإن الله لا يعاقب الناس على كل ما فعلوا ولو فعل ذلك لأهلكنا جميعا:
“وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ [النحل : 61]”,
وحتى عندما تنزل المصيبة فإنه يتم تلطيفها فإنه تنزل مسبوقة بالعفو:
“وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ [الشورى : 30]”
ولا يعني كلامنا هذا في عين الوقت أن الله يكتفي بموقف المشاهد أو المعاقِب –معاذ الله-, فالله تعالى يعمل على أن يُجنب الناس الهلاك وذلك بأن يرسل لهم الهداية, سواء بواسطة الرسل أو بغيرهم من المصلحين أو المنذرين, والأقوام إما تستجيب فتنجو أو تعرض وتصر على مواقفها واتباع المضلين فتهلك!
“قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام : 149]”,
والهداية الجمعية تعني إلغاء الإرادة الحرة للإنسان فلم تكن!! وقبل الختام أقول: مشكلة البشر أنهم استطاعوا أن يتقبلوا الموت واقعاً ولكنهم لم يستطيعوا أن يتقبلوه –بدرجة كبيرة- فكراً, وكذلك تقبلوا “النقص” واقعاً ولكنهم لا يزالون يحلمون بعوالم الكمال! ومن حق الإنسان أن يحلم, وعليه أن يسعى لتحقيق أحلامه, ولكن عليه كذلك أن يفرق بين الوهم والخيال! فنحن ناقصون وسنظل ناقصين ولن نصبح في يوم من الأيام آلهة ولا أنصاف آلهة, ولن نصبح خالدين وسنظل نحيا ونسعد ونتعلم كثيراً ونتألم ونمرض ونُصاب قليلاً … ونموت! وفي الختام أقول: هناك الكثير والكثير من وجوه الحكمة الأخرى, مثل أن الخير هو الغالب في الوجود وأن الأذى هو الاستثناء العارض, وأن الشعور بالضعف موقظ للإنسانية بينما القوة موقظ للإفساد:
“وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ [الشورى : 27]”
ومهما قلت أو كتبت أنا أو غيري ستظل في نفس الإنسان –صاحب المنظور القاصر المحدود- بعض التساؤلات وبعض التطلعات التي تقنع بمثل هذه الإجابات و “الحِكم”, بينما يختلف الحال مع المؤمن, الذي يؤمن بالله العليم الحكيم الخبير الذي له الأسماء الحسنى, كما يؤمن بأن علمه البشري قاصر, وأنه مهما علم فسيظل محدود العلم, وسيخفى عنه لا محالة من وجوه حكمة الله في فعله مثل ما ظهر له أو أكثر, فحكمة الله … عجيبة عالية, لذا فهو مقرٌ بمحدوديته, وأنه ستبدي لنا الأيام (والقرون) ما لم نكن نعلم, وستظهر لنا من وجوه الحكمة الربانية المتعالية ضروبٌ! فمثلاً بعد أن قص الله الحكيم أذى فرعون لبني إسرائيل قال:
“وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ [القصص : 5]”,
ويحقق الرب إرادته هذه بواسطة موسى بعد عشرات السنين, عندما ظهر النبي القائد الذي اجتمع حوله الشعب وأصبح يداً واحدة, وساعتها أصبح سائغاً أن يُهلك فرعون!! والله يفعل ما قد يخالف توقعات الإنسان كثيرا,
ف “إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ [البقرة : 26]”,
فقد يتساءل البعض: كيف يضرب الله في كتابه مثلاً بالبعوضة, بهذا الشيء التافه الحقير, معاذ الله أن يفعل هذا, بالتأكيد ليس هذا من كلام الله, وإنما هو من اختلاق ذلك الذي يدعي أنه رسول من عنده!! وفعل الله الواحد قد يكون هداية لأناس وضلالاً لآخرين! كما يؤمن المسلم أن هناك بعض الأقدار التي قدّرها الله على البشر –وإن لم تكن أبدية-, ومن ثم فعليهم التعايش تبعاً لها! مثل أنهم يوجدون في الحياة صغاراً ثم يكبرون ثم يموتون وأنهم يوجدون لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون! والبشرية كانت محدودة العلم وكان هناك من الأعمال ما يحتاج إلى الجهد الكبير لطائفة من البشر, أصبح يقوم به الآن عامل واحد على آلة, وربما كان هناك من الأمراض ما يُهلك الكثيرين وأصبح الآن يُصرف دواؤه بتلقائية من الصيدلية! وستأتي أجيال ترى أن ما كنا نراه عادياً ومقبولاً أنه كان شقاء وتعب!! (بينما نحن من نعيشه متقبلون له غير متضررين منه!) وفي هذا السياق أذكر بأن البشرية كلها قوبلت في مبتدئها بسؤال وجودي من الملائكة، والعجيب أنه كان مرتبطاً كذلك ب: الفساد!! (والذي ينبغي ربطه ب: الشر) وكلنا نعلم الموقف الشهير:
“وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة : 30]”,
فالملائكة تتساءل متعجبة: كيف يجعل الله من يفسد؟ كيف يصدر هذا منك يا رب؟! ونلاحظ أن الله العليم لم يخبرهم بالحكمة وإنما اكتفى بقول: إني أعلم ما لا تعلمون! وبعد موقف الأسماء والعرض ذكرهم:
“… قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ..”,
فهذا الكائن وإن كان ظاهره الفساد إلا أن له بواطن غابت عنكم يا ملائكة! ومن ثم فالفعل (أو الكارثة) قد يكون ظاهره الفساد, إلا أن له بواطن كثيرة نافعة تخفى عن المشاهد, ويستحق من أجلها الإيجاد والإبقاء! والله العليم يخلق بعلمه وحكمته ويظهر للبشر بعضاً منها في كلامه, ويترك غيرها ليكتشفه البشر بأنفسهم في رحلتهم! فمن رضي فله الرضى ومن تساءل فله إجابات, ومن اعترض فله العنت!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.