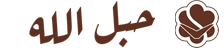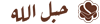الباحث: د.جمال نجم
هناك سورة كاملة تحمل هذا الاسم (الأنفال)، مـمَّا يدلِّل على أهميَّة هذا المصطلح، حيث يترتَّب على فهمه أحكام عظيمة تمسُّ حياة النَّاس العامَّة، ولا عجب إذن من اختلاف النَّاس بعد النَّبي فيما يتعلق بمصير الأراضي التي تمَّ فتحها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقصد هنا العراق وفارس ومصر والشام، حيث نشأ النقاش حادا حول كيفية التَّعامل مع تلك الأراضي الشَّاسعة، هل تُقسَّم أم تبقى في أيدي أهلها ويفرض عليها زكاة الأرض (الخراج)، ولا شكَّ أنَّ عمر قد تنبَّه إلى ما تفيده كلمة الأنفال وأنَّها غير الغنيمة والفيء، بينما تمسَّك بعض الصحابة كبلال بن رباح وعمار بن ياسر باعتبار الأنفال صنو الغنيمة فطالبوا بتقسيم الأراضي بين الفاتحين، لكنَّ عمر ومعه عدد من كبار الصحابة كعلي رأوا غير ذلك، وقد وافق رأيهم حكم الكتاب كما سيأتي بيانه.
أ_ معنى النفل لغة واصطلاحا
النفل من (نفل) النون والفاء واللام أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء. منه النَّافلة: عطيَّة الطَّوع من حيث لا تجب. ومنه نافلة الصلاة. والنَّوفل: الرَّجل الكثير العطاء ، والجميعُ: الأَنْفال[1].
و (النَّافِلَة) مَا زَاد على النَّصِيب أَو الْحق أَو الْفَرْض[2]. وَالنَّفْلُ: النَّفْيُ، والنّافِلُ: النّافِي، فَيُقالُ: نَفَلَ الرَّجُلَ عَنْ نَسَبِهِ: إِذا نَفَاهُ[3].
ويمكنني تعريف الأنفال اصطلاحا بأنها عموم الأراضي التي تدخل في حوزة الدولة الإسلامية نتيجة للفتح، سُميت أنفالا لكونا زائدة عن نصيب المحاربين والفاتحين، ونظرا لنفي صلتها بالدولة الخاسرة ولحوقها ببلاد المسلمين، فهي نافلة أضيفت لبلدان المسلمين على إثر هزيمة جيش العدو، وهكذا أمكن الربط بين معنى كلمة الأنفال لغة وبين الأراضي المفتوحة. وفي بعض البلدان العربية يُستخدم لفظ النَّفل للأرض التي يستصلحها الفلاحون من أراضي الدَّولة، وربما جاءت تلك التسمية بدلالة كلمة الأنفال الواردة في الآية.
ومن الواضح أنَّ الأنفال تشمل الأراضي العامة التي ليس فيها ملك خاص، ويطلق البعض عليها “الأراضي الأميرية”. أمّا الأراضي التي تدخل في الملكيات الخاصة لسكان البلدان المفتوحة فلا تدخل في مسمى الأنفال، فهي لأصحابها ولا يحقُّ للدَّولة وضع اليد عليها.
ب_ مصير الأراضي المفتوحة (الأنفال)
اختلف الفقهاء في تقرير مصير الأرض المفتوحة عنوة، ما بين قائل بتقسيمها وقائل بعدم تقسيمها، فذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين، أو يضرب على أهلها الخراج ويُقرِّها بأيديهم.
وذهب مالك إلى أنها لا تُقسَّم، وَإِنَّمَا يُقَسَّمُ مَا يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ . وذهب الشافعي إلى قسمها بين المقاتلين كما يقسم المنقول، يقول أبو عبيد في كتابه الأموال: “فقد توالت الأخبار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين، أما الأول منهما فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وذلك أنَّه جعلها غنيمة فخمَّسها وقسَّمها، وبهذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام، وأشار به الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر، وبهذا كان يأخذ مالك بن أنس، كذلك يروى عنه. وأما الحكم الآخر، فحكم عمر في السواد وغيره، وذلك أنه جعله فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا، لم يخمسه ولم يقسمه، وهو الذي أشار عليه علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل”
يقول ابن رشد: “وسبب اختلافهم ما يُظن من التعارض بين آية سورة الأنفال، وآية سورة الحشر؛ وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غُنم يُخمس، وهو قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}. وقوله تعالى في آية الحشر: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ، عطفًا على ذكر الذين أوجب لهم الفيء، يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء، كما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال- في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق، حتى الراعي بكداء”. أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تُقسم الأرض التي افتتحت عنوة في أيامه من أرض العراق ومصر” .
والحقُّ أنَّ الاختلاف نابع من عدم التَّفريق بين الغنيمة والفي والأنفال، وبالرغم من كونها كلمات ذات دلالات مختلفة، إلا أن جماعة من الفقهاء والمفسرين أعطوا لها معنى واحدا بالرغم من اختلاف الحكم فيها عندهم.
وينقل الراغب الأصفهاني الاختلاف في معنى كلمة الأنفال كما يلي: “والنفل: ما يحصل للإنسان قبل القسمة من جملة الغنيمة، وقيل: هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال، وهو الفيء. وقيل هو ما يفصل من المتاع ونحوه بعد ما تقسم الغنائم، وعلى ذلك حمل قوله تعالى: {يسئلونك عن الأنفال} (الأنفال، 1)، وأصل ذلك من النفل. أي: الزيادة على الواجب” (المفردات)
وبالرغم من أن الحكم الذي أطلقه الفقهاء فيما يخص الغنيمة والفيء كان صائبا إلا أنهم ارتبكت كلمتهم عندما تناولوا الأنفال، حيث قالوا إن الأنفال بمعنى الغنائم لكنها التي تعطى للمحاربين قبل القسمة دون تقديم دليل مقنع. وقد تبنى اللغويون هذا الخلط أيضا، يقول الزبيدي في تاج العروس: “وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيز: (يَسْئَلُوَنَكَ عَنِ الْأَنفَالِ) ، يُقَال: هِيَ الغَنائِمُ، سُمِّيَتْ بِها؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمين فُضِّلُوا بِها على سَائِرِ الأُمَمِ الَّذين لَم تَحِلَّ لَهُمُ الغَنائِم” . ثم اجتهدوا في تبرير هذا الخلط فقيل: “سميت الغنيمة نفلاً، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعيّة الجهاد وهو إعلاء كلمة الله وقهرُ أعدائه” .
كان من نتيجة هذا الخلط حصول خبط شديد عند تعامل المفسرين والفقهاء مع الآيتين الأولى و 41 من سورة الأنفال، وهما قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (الأنفال 8/ 1)
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (الأنفال 8/ 41)
وقد زعم البعض أن الآية الأولى مجملة فصلتها الآية 41. وهو ادعاء لا يمكن قبوله لما يلي:
1_ عرف اللغة يقضي بالتفريق بين كلمتين لا تجتمعان على أصل لغوي واحد كما أنهما مختلفتان في المعنى، فلا يمكن أن يكون السؤال عن الأنفال ويكون الجواب عن الغنيمة.
2_ في الآية الأولى ورد التساؤل والجواب عليه، وهو يقتضي تمام الموضوع، (يسألونك.. قل)
3_ اختلاف مصارف كليهما بحسب الآيتين، فبينما كانت الأنفال كلها لله والرسول، كان خمس الغنائم لله وللرسول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ويفهم من ذلك أن أربعة أخماسها للمقاتلين بدلالة قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم} فقد نسب الغنيمة إليهم لأنهم السبب المباشر في تحصيلها، فاقتضى أن تكون لهم، ويستثنى من ذلك ما نصت الآية عليه من الخمس الذي يذهب للمذكورين فيها.
وقد فطن البعض لاختلاف الحكم في الآيتين فزعموا نسخ آية الأنفال بآية الغنيمة ، وكان الأَوْلى أن ينظروا في معنى الآيتين ليتبيَّن الحقُّ النَّاطق بأنَّهما تبحثان مسألتين مختلفتين لا مسألة واحدة.
ج_ الأراضي المفتوحة لا تخلو أن تكون واحدة من ثلاثة:
الأولى: الأرض الخاصة بجيش العدو كالمعسكرات المقامة للتَّدريب وكذا الحصون والقلاع التي تتخذ نقاط انطلاق للجيش، وكذلك ما يتخذ كمقرات للدولة الفانية، وهذه الأرض يصح للدولة الإسلامية السيطرة عليها باعتبارها ميراث دولة فانية، وهي تشبه إلى حد كبير ما ورثه المسلمون بعد جلاء بني النضير عن المدينة، وما بعد المعركة مع بني قريظة، وقد تم تقسيم أرض بني قريظة وقلاعهم باعتباره ميراثا بنص الآية: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا} (الأحزاب 33/ 27)
الثانية: الأراضي الخاصة التي يمتلكها أصحاب الأراضي المفتوحة، سواء المأهولة أو المزروعة أو المراعي، فهذه تبقى في يد مالكيها ولا تنتزع منهم، ويؤدون ما يجب عليها من الصدقة، وهو العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالجهد البشري، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يأخذ الصدقة من مواطني دولته بغض النظر عن دينهم كما جاء في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة 9/ 103) والهاء في قوله: {أَمْوَالِهِمْ} يعود على المذكورين سابقا وهم جميع مواطني دولة النبي من المسلمين واليهود والمنافقين، لكن ما يدفعه المسلمون يسمى زكاة، وما يدفعه غيرهم يسمى خراجا، للتفريق بينه وبين ما يدفعه المسلم من زكاة زرعه، وتشترك كلتا التسميتين بكونهما صدقة، فالصدقة التي يؤديها المواطنون لدولتهم تظهر صدق ولائهم لها. يقول الأوزاعي: “أجمع رأي عمر وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين”
الثالثة: الأراضي المشاع أي جميع الأرض سوى ما ذكر في النقطتين الأولى والثانية، وقد يطلق عليها الأراضي الأميرية، وهذه الأرض هي الأنفال المذكورة في الآية بحيث لا يتم تقسيمها ولا يتم التصرف بها إلا للنفع العام، وهو مقتضى قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (الأنفال 8/ 1).
إن سلوك النبي والخلفاء الرَّاشدين من بعده يؤكِّد هذا التَّوجه القرآنيّ في التّعامل مع البلدان المفتوحة، فقد فُتحت مكّة والطّائف وتبوك وغالبية أقطار الجزيرة العربية في زمن النّبيّ صلّى الله عليه وسلم ولم يُقسَّم منها شيء على الفاتحين، ولم تضع الدّولة يدها على تلك الأراضي، وكذلك فعل عمر بن الخطاب بالأراضي المفتوحة في العراق وفارس والشام بعدما استشار كبار الصّحابة كعلي بن أبي طالب، وقد فعل ذلك بالرغم من اعتراض بعض الصحابة كبلال وعمار عليه واحتجاجهم بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لأرض خيبر، لعلمه أن تقسيم أرض خيبر لا يُقاس عليه لأنَّ له حالة خاصة شرعيَّة وموضوعيَّة، والعجيب أن الفقهاء يقبلون قسمة الأراضي المفتوحة من حيث المبدأ ويعتبرون فعل عمر بسواد العراق هو اجتهاد الامام، وكأن للإمام أن يخالف مقتضى النَّص.
لقد وقع الفقهاء في مأزق تخريج فعل عمر لما رأوا من التعارض بين أحقية الفاتحين بأربعة أخماس الأرض المفتوحة على اعتبار كونها غنيمة بحسب رأيهم وبين عدم تقسيم عمر للأراضي المفتوحة في زمانه فخرجوا بالرأي القائل أن الأمر متروك للإمام إن شاء قسَّم وإن شاء أبقى الأرض بيد أصحابها مع إجراء الخراج عليها، وهذا تخريج من لم ير الأسباب الحقيقية لتقسيم أرض خيبر والأراضي التي تركتها قبائل يهودية جلت عن المدينة، فذلك التقسيم لا يُقاس عليه للأسباب التالية:
1_ نص القرآن الكريم أن هذه الأراضي هي ميراث للمسلمين كما بيَّنه قوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا} (الأحزاب 33/ 27) هذه الآية متعلَّقة ببني قريظة الذين قُسِّمت أرضهم بعد غزوة بني قريظة، وكما تنص الآية فإن الله تعالى أورث المؤمنين أرضهم، كما تنصُّ الآية على أن الله تعالى أورث المؤمنين أرضا لم يطئوها بعد، وهي أرض خيبر، وقد ذكر المفسرون أنَّها فارس والروم، وقيل: مكة. وقيل: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة، لكنَّ مقاتل بن سليمان جزم أنَّها خيبر .
ورأي مقاتل هو الصواب إذا نظرنا إلى سياق الآية وطبيعة الخطاب وهوية المخاطَب، فسياق الآية يتحدَّث عن ميراث تمليكي تمثَّل بتقسيم أرض بني قريظة، وعليه فإنَّ الأرض التي لم يفتحها المسلمون بعدُ ستواجه نفس المصير، فالخطاب يتحدَّث عن ميراث تملكي وليس ميراث حكمي فحسب، وهو ما ينطبق على خيبر ولا ينطبق على غيرها من الأماكن، والتاريخ يؤكِّد ذلك فقد تمَّ تقسيم أرض خيبر عند فتحها في عهد عمر، لكنَّ مكَّة والطَّائف وغيرها من أراضي الجزيرة العربية المفتوحة زمن النبي لم تُقسَّم.
2_ الأراضي التي قسَّمها النَّبي كأراضي بني قريظة وبني النضير هي أراض زال ساكنوها عنها، وانتهى وجودهم ككيان يمثل قوما يملك أرضا محدَّدة يمارس سيادة محدودة عليها، وهذه الأرض إذ أصبحت بلا ساكنين اقتضى تقسيمها كأرض غير مملوكة. وهذا بخلاف بقاء أهلها عليها.
د_ الفرق بين الغنيمة والفيء والأنفال:
الغنيمة ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، والفيء ما أخذ من أهل الحرب بغير قتال ولا إيجاف خيل. وثمة فرق آخر بين الغنيمة والفيء، هو أن الفيء لا يخمس كما تخمس الغنيمة . أما الأنفال فهي ما رده الله على أهل دينه من غير جنس الغنيمة والفيء، وهو هنا الأرض المفتوحة التي لا يغادرها أهلها، وما حولها من الأراضي غير المأهولة.
والله تعالى أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ابن فارس ، مقاييس اللغة، مادة نفل
[2] «المعجم الوسيط» مادة نفل (2/ 942)
[3] الزبيدي، تاج العروس، مادة نفل