33. الاجتهاد
الاجتهادُ في اللُّغة: مُشتقٌّ من مادة: (ج هـ د) بمعنى: بذل الجهد (بضم الجيم) (وهو الطَّاقة) أو تحمُّل الجهد (بفتح الجيم) وهو المشقَّة. وصيغة “الافتعال” تدلُّ على المبالغة في الفعل. وعلى هذا فالاجتهادُ هو استفراغُ الوسع في أيِّ فعلٍ كان، ولا يُستعملُ إلَّا فيما فيه كلفةٌ وجهدٌ.
وفي اصطلاح الأصولييِّن، فقد عبَّروا عنه بعباراتٍ متفاوتةٍ، لعلَّ أقربَها ما نقله الإمامُ الشَّوكاني في كتابه “إرشاد الفحول” في تعريفه بقوله: “بذلُ الوسع في نيل حكمٍ شرعيٍّ عمليٍّ بطريق الاستنباط”.
المُريد : المذاهب لم تتركْ شيئاً إلَّا وبيّنته، وما علينا إلَّا فهمُه والعمل به.
بايندر : كانت هذه الفكرةُ منتشرةً جدَّاً حتى قبل سنين ، يُدافَعُ عنها بالنّفَس والنفيس، وما زال إلى الآن مَنْ يحنُّ إليها، ولكنَّها حين لم تجد مُعتَمَداً صحيحاً لها أخذت في الضَّعف والانقراض.
والمذاهب تعرَّضتْ لكلِّ شيءٍ، وعلماءُ المذاهب أفتوا في المسائل التي يترددون فيها ورأوا الحاجة إليها على ضوء القرآن والسُّنَّة، وهذا بالنظر إلى الظروف الطبيعيَّة المحيطة بهم من أسباب ونتائج، فاستنبطوا أحكامَها الشَّرعيَّةَ من القرآن والسُّنَّة.
وهنا تبدو أهميَّةُ معرفة الظُّروف المحيطة، ومدى الثقة بمصادر العلماء المستنبطين والظروف الخاصَّة التي تُحيطُ بالمجتهد، لذا تجدون أنَّ العالم يقولُ في مسألةٍ واحدةٍ بحكمين مختلفين لاختلاف الظروف، وهذا أمرٌ سويٌّ، فإذا تغيَّرت الأحوال تغيرت معها أحكامُها، لذا أوْلت المذاهب شأناً كبيراً لتغيُّر الزَّمان والمكان.
ولم يكن يخطرُ ببال أحدٍ نسجُ القماش أو البناء أو المواصلات في ظروف مئة سنة من قبل، ولكن قد يطلع علينا من يدافع عن اجتهاداتٍ صدرت قبل ثلاثمئة وألف عام (1300) في ملابسات مدينتي الكوفة وبغداد، فقولُكم إنَّ المذاهب لم تتركْ شيئاً إلَّا وبيَّنتْه لا يعني شيئاً سوى أنَّ الحياةَ قد جمدت منذ ظهور تلك الفكرة إلى يومنا هذا.
المُريد : هل يعقل أن يظهرَ اليوم مثلُ أبي حنيفة ومالك والشَّافعي؟ أبو حنيفة يُروى عنه أنه صلَّى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة!
بايندر : أصلُ المصيبة هنا، في تقديس الرجال، فهل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صلَّى الفجرَ بوضوء العشاء؟ وهل عندكم حديثٌ واحدٌ عن أبي حنيفة أنَّه رأى فضيلة السَّهر بالليلِ؟ الليلِ الذي جعله الله للسُّكون والرَّاحة؟ فلماذا تريدون أن تُظهِروا هؤلاء العلماءَ بمظهرٍ وكأنهم فوق طبيعة البشر، خارقون للعادة، والواقع أنَّهم عاشوا حياةً بشريَّةً خاليةً من أيِّ وصفٍ يُجاوزُ حدود طبيعة الإنسان. وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طبيعيَّةً وسويَّةً، يستطيع كلُّ النَّاس أن يقتدوا به فيها ويعيشوها، بل إنَّ الشُّيوخ الذين ظنُّوا بأنفسهم الخوارق قد جعلوا حياة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه رضي الله عنهم عسيرةَ المنال، أعلى من مستوى حياة البشر، ولم يدخروا جهداً لمنع النَّاس من اتخاذهم أُسوةً وقدوةً في حياتهم، ولكن الحمد لله الذي جعل بين أيدينا القرآن الكريم وصحيحَ الحديث لنقاومَ بهما ما تفترون.
المُريد: ما شاءَ الله! لقد فرغتَ من الطُّرق ومن المذاهب أيضاً، فما هو مرادُكَ بعد ذلك سوى أن تُبعدَ الإسلامَ عن واقع الحياة؟ !
بايندر : بل أريدُ أن أُدخِلَ المسلمين في الحياة التي أخرجوا أنفسَهم منها، أمَّا أنتم فستُعمِلون كلَّ طاقتكم لتُعطِّلوا عقولَكم، واللهُ تعالى قال: «وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (يونس، 10/100).
المُريد: أيُعقَلُ إسلامٌ دون مذاهب؟
بايندر : حيثما كان الإنسانُ الذي يستخدم عقلَه ويأتي بالعمل العلميِّ كان معه المذهب، وإغلاقُ باب الاجتهاد يعني تجميدَ العمل العلميِّ، بل ويعني تجميدَ الحياة كلِّها، ولن تجمد الحياة، والضَّررُ واقعٌ عليكم حين لا تواكبون التَّطوُّرات وتُحاولون أن تعيشوا بعيداً عن واقع عصركم.
والمسلمون قد نسَوا منذ عصورٍ مضت أن يتدبَّروا القرآنَ ويعملوا بأحكامه، فنشأ عن ذلك أن ينظروا إليه فقط من باب القداسة بحيثُ لا يستطيعون فهمَه ولا العملَ به، حتَّى صار كتاباً لا يُقرأُ إلَّا للتبرُّك، ولا تُفسَّرُ إلَّا بعضُ آياته وعظاً وتذكيراً. قال تعالى:
– « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» (محمد، 47/24).
– « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» (القمر، 54/17، 22، 32، 40).
– « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ» (الأنفال، 8/20-21).
المُريد : والمذاهب الموجودةُ منذ القديم إلى يومنا هذا وما استُنبِطَ فيها من اجتهادات، أين نضعه؟ أنجعلُه وكأنَّه لم يكن؟
بايندر: انظروا ! في القرآن والسُّنَّة موضعٌ واضحٌ وواسعٌ للعقيدة وللأحكام العمليَّة، ويبقى منه قسمٌ كبيرٌ ضيِّقٌ للاجتهاد، أمَّا الشُّؤونُ الدُّنيويَّة فتُرِكَت للإنسان وعلمه داخل ضوابط بُيِّنَتْ له، وقد جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: “العلماء ورثةُ الأنبياء”[1].
لهذا كان العلماءُ يجتهدون على ضوء القرآن والسُّنَّة في الحدود التي حُدِّدَتْ لهم، ويستفيدون مما سَبَقَ من اجتهادات العلماء، فهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكم بالقرآن، وعليهم أن يستمروا في وظيفته التي كلَّفه اللهُ تعالى بها وبيَّنها في قوله: « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (المائدة، 5/48-50).
فالعلماءُ إذاً يُوجِّهون النَّاسَ إلى القرآن والسُّنَّة، وعليهم أن يواظبوا على هذا العمل، أمَّا إذا منعتم الحُريَّةَ العلميَّةَ، وجمَّدتُم المذاهب الفقهيَّةَ في حيِّزٍ ما، ونظرتم إلى الأئمَّة الفقهاء على أنَّهم فوق البشر، فلن تصلوا إذاً إلى مخرجٍ من مشكلاتكم.
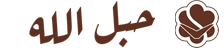


أضف تعليقا