الختم على القلب
قال الله تعالى: «خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ » (البقرة، 2/7).
فمثل هذه الآيات تبين الآثار السلبية والتي تنتج عن الأعمال السيئة. فإن كثرة المعاصي تأتي على القلب فتفسده، كما يصدأ الحديد ويبلى الخشب، وتتسخ المرآة. فإن الفساد في الإنسان كالفساد في الطبيعة.
ويبين القرآن الكريم الفطرة، قال الله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، 30/30).
والفطرة، هي الخلقة والبنية الأساسية التي تكونت عليها الموجودات، كما أنها تعني مبادئ وقوانين التطور والتغير، وعليها يجري نظام كل شيء؛ السموات، والأرض، والناس، والحيوانات… الخ. ومن يتبع القرآن وهديه فإن تحركاته وإيقاع حياته سيكون موافقا ومنسجما مع تلك الفطرة. وهو بذلك يستفيد مما أودعه الله في السماوات والأرض على الوجه الأكمل، وسيدخل الجنة بعد الموت إن شاء الله تعالى ويفوز بسعادة خالدة.
ومن خالف الفطرة فقد خالف الحق وأفسد الميزان، لأن القرآن الكريم يدعو إلى الفطرة. والفساد يبدأ أولا في ذات الإنسان، والسبب في ذلك هو المنافع والأمنيات والرغبات. فعليه أن يعرض عن تلك الأمنيات الفارغة وإلا صدأ قلبه كما يصدأ الحديد ويكسب بذلك طبيعة جديدة تكون بعيدة كل البعد عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله تعالى في وصف هؤلاء: « كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ » (المطففين، 83/14).
ويتعود الإنسان على العادات السيئة ثم يبدأ يتلذذ بها.كالمدخن فإنه يحس في بداية تدخينه برائحة كريهة كرائحة الجيفة. وفي المرة الثانية كذلك ولكن بدرجة أقل من الأولى. وإذا طال به الأمر في التدخين فإنه يكتسب سجية جديدة تجعله يتلذذ به. وكذلك الكذاب؛ فهو ينزعج في البداية حين يكذب. ولكنه عندما يعتاد الكذب فإنه يكسب طبيعة جديدة، وبالتالي يصبح الكذب بالنسبة له كحاجة أصلية لا مفر منه.
والقلب هو مركز التحكم في الإنسان، وبالعقل يعرف ما هو الصحيح. فيقبله القلب أو يرفضه حسب المصالح والرغبات أو الطموحات. لأن اتباع ما قرره العقل يتطلب دفع الثمن.
والذي لا يريد دفع الثمن يرفض امتثال كثير من الأعمال الصالحة بالرغم من معرفته أنها صحيحة، ومن هنا يبدأ الفساد، فتصبح العين لا ترى بعض الأشياء، والأذن لا تسمع. فيأخذ بذلك آراءه الشخصية مكان الحقائق العامة. فيتكون له بيئة جديدة. ويجد فيها أصدقاء جدد ليعضدوه. قال الله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» (الجاثية، 45/23).
وحصول هذا التأثير على الأذن والقلب، ونزول الغشاوة على البصر، ما هو إلا نتيجة طبيعة حاصلة من اتباع هوى القلب. وهذا ما بينته الآية السابعة من سورة البقرة. وهذه الآية تعطي للموضوع وضوحا أكبر؛ قال الله تعالى: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون» (النحل، 16/106-108).
ومعنى كلمتي الختم والطبع المذكورتين في الآية، هي ترك الأثر على شيء أو هي الأثر نفسه. وقيل في كثير من معاني القرآن الكريم أنها ترك الأثر على شيء. واْستُشهِدَ على صحة هذا المعنى بالآية السابعة من سورة البقرة. فقيل في معنى الآية: “جعل الله تعالى أسماعهم وقلوبهم مختومة.[1]
إلا أننا نرى أنّ هذا المعنى مخالف لعموم القرآن الكريم، إذا كان الله تعالى قد ختم أي طبع الختم على قلب الكافر وسمعه وغطى بصره بستار، فأصبح الكافر بذلك لا يستطيع فعل أي شيء فيكون تعذيبه على كفره ظلما. وإنما قصد بالختم المجاز وليس الحقيقة وهذا من قبيل الإستعارة التمثيلية.
يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية: “فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثَمَّ على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الإستعارة والتمثيل. أما الإستعارة فأن تجعل قلوبهم لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده، وأسماعهم لأنها تمجُّه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين كأنما غطي عليها وحجبت، وحيل بينها وبين الإدراك. وأمّا التمثيل فأن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من أجلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الإستنفاع بها بالختم والتغطية. وقد جعل بعض المازنيين الحبسة في اللسان والعيّ ختماً عليه فقال:
خَتَمَ الإله عَلى لِسَانِ عُذَافِرٍ… خَتْماً فلَيْسَ عَلى الكلامِ بقَادِرِ
وإذا أَرَادَ النَّطْقَ خِلْتَ لِسَانَهُ… لَحْماً يُحَرِّكُهُ لِصَقْرٍ نَاقِرِ
فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالى وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح علواً كبيراً لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه. وقد نص على تنزيه ذاته بقوله: «وَمَا أَنَاْ بظلام لّلْعَبِيدِ» (ق، 50 / 29)، «وَمَا ظلمناهم ولكن كَانُواْ هُمُ الظالمين» (الزخرف، 43 / 76 )، «إِنَّ الله لاَ يَأْمُرُ بالفحشاء» ( الأعراف، 7 / 28). ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل؟ قلت: القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها. وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل، فلينبه على أنّ هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير العرضي. ألا ترى إلى قولهم: فلان مجبول على كذا ومفطور عليه، يريدون أنه بليغ في الثبات عليه. وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهم، ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم؟ ويجوز أن تضرب الجملة كما هي، وهي ختم الله على قلوبهم مثلاً كقولهم: سال به الوادي، إذا هلك. وطارت به العنقاء، إذا أطال الغيبة، وليس للوادي ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا في طول غيبته؛ وإنما هو تمثيل مثلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي، وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء؛ فكذلك مثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها نحو قلوب الأغتام التي هي في خلوّها عن الفطن كقلوب البهائم، أو بحال قلوب البهائم أنفسها، أو بحال قلوب مقدّر ختم الله عليها حتى لا تعي شيئاً ولا تفقه، وليس له عزّ وجلّ فعل في تجافيها عن الحق ونبوّها عن قبوله، وهو متعال عن ذلك. (الكشاف، الزمخشري1/29).
ويؤيد البيضاوي هذا التفسير بقوله: “وإنما المراد بهما ( أي الطبع والختم ) أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي، واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم، وانهماكهم في التقليد، وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق، وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين، فتصير كأنها غُطي عليها. وحيل بينها وبين الإبصار، وسمّاه على الإستعارة ختماً وتغشية” ( تفسير البيضاوي، 1 / 26). قال تعالى في سورة الصف: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين» (الصف، 61 / 5) وتتحدث هذه الآية وأمثالها عن أن الأعمال السيئة تتولد عن العادات السيئة وهذا من قبيل سنة الله في الأشياء، وهكذا يكون الصلاح والفساد جنبا إلى جنب في عالم الإمتحان.
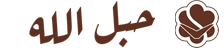


معلومات جيدة ومفيدة جدا أجزل الله لكم جزاءه