أ.د عبد العزيز بايندر
الحكمة في القرآن والعرف التقليدي
لقد أنزل الله تعالى على جميع الأنبياء والرسل كتبا؛ خلافا لما تعارف عليه العلماء. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى بعد أن ذكر 18 من الأنبياء والرسل: «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ » (الأنعام، 6 / 89).
أمّا العرف التقليدي فيقول إنّ الكتب المنزلة أربعة. وهي التوراة، والانجيل، الزبور، والقرآن الكريم. عن أبي ذر الغفاري، قال: قلت: يا رسول الله، كم كتاب أنزله الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله عز وجل على آدم عشر صحائف، وعلى شيث خمسين صحيفة، وأنزل على أخنوخ (إدريس) ثلاثين صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل جل وعز التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. وهذا يدلّ على نزول الكتب على ثمانية عشر نبيا. ولكننا نفهم من الآية 83 إلى الآية 89 من سورة الأنعام أنّ الله قد أنزل على جميع الأنبياء الكتاب والحكم والنبوة. وقد جاءت “الحكمة” في آية أخرى مكان الحكم. كما قال الله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» (آل عمران، 3 / 81).
كما بيّن الله تعالى في آية أخرى وظيفة الأنبياء؛ ألا وهي تبليغ ما أُنزل إليهم من الكتاب. فقال تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (البقرة، 2 / 213).
وقد أمر الله الذين أُنزل عليهم الكتاب أن يحفظوه في صدورهم ويدرسوه بألسنتهم، وأن ينفذوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه، ولا يهملوا شرائعه وأن يحكموا بأحكامه، لأنّ الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، فالذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه، فيكتمونه ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه فأولئك هم الكافرون. قال الله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (المائدة، 5 / 44).
وتعني كلمة “الحكمة” الحكم الصحيح الذي لا نزاع فيه. وكان النّبي صلى الله عليه وسلم يستنبط من القرآن الكريم أحكاما ويطبقها بين أصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك علمنا أساليب استنباط الأحكام من القرآن الكريم. وحين نتتبع هذه الأساليب نجد بين الكتاب والسنة النبوية توافقا تاما.
وآيات الله تنقسم إلى قسمين؛ الأول: الآيات الكونية التي هي مصدر كل العلوم. فيمكن للعلماء الوصول إلى الحِكم الموجودة في الكون إذا ما درسوا العلوم الكونية، وتتبعوا فيها الأساليب الصحيحة المتينة.
إنّ كلمة “الأحبار” في الآية السابقة، هي جمع كلمة “الحبر”. ويقال للعالم حبرا لما يبقى من أثر علمه في قلوب الناس، ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها.[1] لو أنهم درسوا الآيات المنثورة في الكون مع الآيات المنزلة المسطورة في الكتاب لسهل عليهم الوصول إلى الحكمة. لأن الحكمة هي الساحة المشتركة بين الدين والعلم. وقد أخبرنا الله تعالى بأن دينه هو الفطرة فقال: « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، 30 / 30).
إنّ أول آيات الكتاب نزولا قد لفتت الإنتباه إلى الفطرة، قال الله تعالى: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (العلق، 96 / 1 – 5).
إنّ كثيراً من الآيات القرآنية لتلفت الإنتباه إلى الآيات الكونية. وقد رأينا من خلال البحوث التي أجرينا حول موضوعات شتى مع المتخصصين بها وبعلوم القرآن الكريم واللغة العربية، أنّ هذه الأساليب تتلاقى وتنسجم مع العلوم الحديثة و توصلنا إلى الأهداف المنشودة.
وقد علّم الله آدم الفطرة أولاً ثمّ ما يلزمه من أسرار هذا الكون. كما قال الله تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا» والضمير “ها” في “كلها” يدلّ على الأشياء غير العاقلة. وحين عُلِّم آدمُ المعرفةَ الموجودة في الأشياء التي لا يعرفها الملائكة، كان الإلتفات في الكلام من الضمير “ها” الذي يدلّ على الأشياء غير العاقلة، إلى الضمير “هم” الذي يدلّ على العقلاء، فقال تعالى: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ». ذلك لأن العقل يعني المعلومات التي يستفيد منها الإنسان.[2] أي أنّ الأشياء التي يظنّها الملائكة غير عاقلة تحتوي علوما لا يعلمونها، وقد سمّاها الله تعالى غيبا، لأنّه لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فقال مخاطبا ملائكته الكرام: « أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» (البقرة، 2 / 33).
وقد فضّل الله آدم بهذا العلم على الملائكة، فسجدوا لآدم. وهذا العلم جعل البشر يستطيعون تعلم الفنون المختلفة التي تمكنهم من بناء الحضارة. وكان تعليم الله إياهم هذا العلم بالكتابة. كما أخبرنا الله تعالى بقوله: «الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » (العلق، 96 / 4 – 5).
ملَكة عقلية بها تصدر الأحكام الصحيحة
الحكمة هي قدرة عقلية في الإنسان يستطيع بها أن يصدر حكما صحيحا. قال الله تعالى: « يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ» (البقرة، 2 / 269).
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ” لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.”[3] وعن ابن عباس، قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال: «اللهم علمه الحكمة».[4]
ونفهم من الآيات والأحاديث السابقة بأنّ الحكمة يمكن اكتسابها. وجاء بهذا المعنى قول إبراهيم عليه السلام حين قال: « رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (البقرة، 2 / 129).
وقد أخبرنا الله تعالى أنّ دعاء إبراهيم قد أجيبت فقال: « لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» (آل عمران، 3 / 164).
وفي استنباط الأحكام من القرآن الكريم قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا» (النساء، 4 / 105).
فجميع أقواله وتطبيقاته وتقريراته المتعلقة بتليغ الرسالة حكمة مستنبطة من القرآن الكريم. “ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه”.[5]
والحكمة في القرآن كالمعادن في الأرض. فلا بد لاستخراج المعادن من الأرض من الوسائل اللازمة من المعرفة والآلات وفرقة العمل، كذلك استنباط الحكمة من القرآن فلا بد من الأساليب اللازمة لها. ونرى أنّ هذه الأساليب المبيَّنة في القرآن قد ضاعت بمكر الليل والنهار. لأن المسلمين الأوائل كانوا يقدمون حلولا للمشاكل، ونقلوا إلى البلدان التي ذهبوا إليها العلوم والحضارة، وجعلوا قلوب أهلها تهوي إليهم بالمودة والمحبة؛ ولكن حلَّ محلهم مسلمون لا يأتون بأي حل لمشاكلهم فضلا عن مشاكل غيرهم، والبلدان التي ذهب إليها الأصحاب الذين علمهم النبيُّ الحكمةَ ما زال فيها أثر الإسلام واضحا، والعناصر الإسلامية فيها سمة أساسية. ولكن البلدان التي فُتحت بعد عصر الصحابة كان أثر الإسلام فيها لا يكاد يرى، لأنّ المسلمين فتحوها وقد غابت عنهم الحكمة، معتمدين على التقليد بعيدا عن فهم الكتاب كما فهمه النّبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.
علاقة الحكمة بالسنة وعلاقة السنة بالوحي
قال الشافعي: إنّ الحكمة هي سنة رسول الله. كما جاء عنه قوله: “فذكر الله الكتاب، وهو القُرَآن، وذكر الحِكْمَة، فسمعتُ مَنْ أرْضى من أهل العلم بالقُرَآن يقول: الحكمة سنة رسول الله. لأن القُرَآن ذُكر وأُتْبِعَتْه الحكمة، وذكرَ الله منَّه على خَلْقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يَجُزْ – والله أعلم – أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنةُ رسول الله”.[6]
وهذا الكلام لا يمكن رفضه. لأن الله تعالى قد علَّم رسوله صلى الله عليه وسلم شيئين: الأول؛ الكتاب، والآخر؛ السنة، فلا بد من أن تكون السنة هي الحكمة.
في المقابل لا يمكن أن نقبل كلام الشافعي التالي، حيث يقول: “وسنة رسول الله مُبَيِّنَة عن الله معنى ما أراد، دليلاً على خاصِّه وعامِّه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه، فاتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله”.[7] ونحن نرفض هذا الكلام لأنّه مخالف لما بيَّن الله تعالى من إعطاء الحكمة لكل الأنبياء والرسل في كثير من الآيات ومنها قوله تعالى: « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» (آل عمران، 3 / 81).
كما أنّه لو كانت السنة مُبَيِّنَة عن الله معنى ما أراد، لما أخطأ النّبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه. لأنه لا يمكن التصور في هذه الحالة وقوعه في الخطأ.
خرجت عيرٌ في قافلة كبيرة لقريش مع أبي سفيان بن حرب إلى الشام، ، فلما سمعوا برجوعها من الشام، ندب النّبي صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج معه ثلاثمائة، وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا، يعتقبون عليها، ويحملون عليها متاعهم. فسمعت بخبرهم قريش، فخرجوا لمنع عيرهم، في عَدَدٍ كثير وعُدَّةٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من الألف. فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين، إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير. فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات شوكة،. ولكنّ الله تعالى أحبَّ لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا. كما أخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله:
«وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ» (الأنفال، 8 / 7-8).
وفات العير ولم يبق للمسلمين إلا لقاء أهل مكة، فدارت المعارك بينهم وبين أهل مكة في بدر، ولم يراع المسلمون الضوابط التي وضعها الله تعالى؛ وهي كما أخبر الله تعالى بقوله: « فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ» (محمد، 47 / 4).
«فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» (الأنفال، 8 / 57).
«وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» (النساء، 4 / 14).
وقاتل المسلمون ببسالة فائقة، وبذلوا النّفس والمال في سبيل الله وألحقوا بالعدو ضربة قاسية، ولكنهم لم يتابعوا العدو حين تراجعوا، وعادوا إلى المدينة بمن أسروا من المشركين وبما حصلوا عليه من الغنائم، وتركوا المشركين يذهبون إلى مكة. يقول الله تعالى معاتبا نبيه: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (الأنفال، 8 / 67-68).
وقد خالف النّبي صلى الله عليه وسلم هنا الحكمة؛ وهي؛ “أن يحقّ الله الحقّ ويقطع دابر الكافرين”.[8] وقد ضاعت فرصة لفتح مكة بمخالتهم الحكمة، أي أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين لو لم يخطئوا في استنباط الحكم من الآيات، لاستمروا في ملاحقة المشركين حتى وصلوا مكة وفتحوها.
وقد اتيحت لهم تلك الفرصة مرة ثانية في صلح الحديبية في العام السادس الهجري. كما قال الله تعالى في أول سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من مكة: « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا؛ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» (الفتح، 48 / 1-2).
وقد نفهم من سورة عبس أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قد صدر منه خطأ آخر؛ قال الله تعالى: «عَبَسَ وَتَوَلَّى؛ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى؛ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى؛ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى؛ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى؛ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى؛ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى؛ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى؛ وَهُوَ يَخْشَى؛ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى» (عبس، 80 1-10). وفي ذات السياق ورد قوله تعالى: «وأمّا السّائل فلا تَنهر»، فقد أُمر عليه الصلاة والسلام أن لا يُهمل من يسأل عن أمر دينه.
وقد تكرر هذا الأمر في قوله تعالى: «وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ» (الأنعام، 6 / 52).
من الممكن أن تكون هذه الخطايا هي المفهومة من قوله تعالى: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» ووقت الإستغفار المذكور في سورة الفتح قد ورد تفصيله في سورة النصر، حيث قال الله تعالى: « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ؛ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا؛ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» (النصر، 110 / 1-3).
“تصحيح الأخطاء أولا ثمّ الإستغفار” مهم للغاية. والآيات السابقة يمكنُ لها أن تُحدِث ثورة في حياة المسلمين. لكن إهمال المناسبات بين الآيات أدّى إلى استنباط خاطئ حال دون فهم الحكمة من هذه الآيات، وبالتالي عدم حدوث هذه الثورة في حياة المسلمين. وعلى سبيل المثال فقد جاء في تفسير قوله تعالى: « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا؛ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا؛ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا» (الفتح، 48 / 1-3)، إنها نعمة إلهية تمت على النبي المغفور ذنوبه السابقة واللاحقة، تجلّت بفتح مكة والطائف وبما جعله الله تعالى لنبيه من الشرف العلي في الدنيا والنّصر على العدو وإخضاع العصاة له.[9] وقد ورد هذا التفسير في كتاب معاني القرآن الذي ساهم في طبعه المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وقد تم طبع ملايين النسخ منه،
وحين يخبرنا الله تعالى “أنّه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر” يقولون: إنّه بعيد عن الذنوب في الماضي والمستقبل. وهذا قول عجيب، فهل يريدون بقولهم هذا أن ينبئوا الله بما لا يعلم؟ ألا يفكرون عند قولهم هذا في قوله تعالى: « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ» (الأحقاف، 46 / 9).
ومن المؤسف أنّ الأخطاء ليست منحصرة بهذا القدر بل هي كثيرة؛ نذكر بعضا منها:
السعي بين الصفا والمروة في الكتاب والسنة معا
قال الشافعي: “فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سُنن النّبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين.
والوجهان يجْتَمِعان ويتفرَّعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبَيَّنَ رسول الله مثلَ ما نصَّ الكتاب، والآخر: مما أنزل الله فيه جملةَ كتاب، فبيَّن عن الله معنى ما أراد؛ وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما.
والوجه الثالث: ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب.
فمنهم من قال: جعل الله له، بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه، أن يَسُنَّ فيما ليس فيه نص كتاب.
ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سُنَّته لتبيين عدد الصلاة وعملها، على أصل جملة فرض الصلاة…
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالةُ الله، فأثبتتْ سنَّتَه.
ومنهم من قال: أُلْقِيَ في رُوعه كلُّ ما سَنَّ، وسنَّتُه الحكمةُ: الذي أُلقي في رُوعه عن الله، فكان ما ألقي في روعه سنتَه.”[10]
ولا يمكن الكلام عن معية السنة بالكتاب إذا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أحكاما لم ترد في الكتاب. وكان التطبيق في العرف الفقهي التقليدي قد تجاوز هذا الحد، حتى تركت الأحكام الواضحة المستنبطة من الكتاب وأُخذ بالأحاديث المخالفة له. وأحيانا تركوا الكتاب والأحاديث وسلكوا مسلكا جديدا. والأمثلة على ذلك كثيرة يجدها من يقرأ البحوث التي أجرينا بنظر المحقق. ونأخذ موضوع “السعي بين الصفا والمروة” ليظهر لنا حالة الفقهاء التي آلوا إليها بسبب عدم استيعابهم الحكمة. قال الله تعالى:
«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» (البقرة، 2 / 158).
وقوله تعالى: « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» لا يدل على فرضية السعي، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْي”.[11]
قال النّووي في شرحه لصحيح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصحُّ إلا به ولا يُجبَر بدم ولا غيره. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال بعض السلف هو تطوع. وقال أبو حنيفة هو واجب فإن تركه عصى وجبره الدم وصحّ حجه.[12]
وقال النووي في مجموعه: “وَقَالَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَنَسٌ وَابْنُ سِيرِينَ هُوَ تطوع ليس بركن ولا واجب ولا دم فِي تَرْكِهِ”. وأردف يقول: “مَذْهَبُنَا أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَا يَتِمُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا بِهِ وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ خُطْوَةٌ لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ إحْرَامِهِ وَبِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَمَالِكٌ واسحق وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إنْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ الذى قدمناه أنها سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ) فَهُوَ رُكْنٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعٌ. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عليه أن يطوف بهما) وَفِي الشَّوَاذِّ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» وَرَفْعُ الْجُنَاحِ فِي الطَّوَافِ بِهِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُبَاحٌ لَا وَاجِبٌ.[13]
وفي معرض حديثه عن رأي الحنفية رادا على الشافية ما ذهبوا إليه، قال السرخسي: وعند الشافعي – رحمه الله تعالى – السعي ركن لا يتم لأحد حج ولا عمرة إلا به، واحتج في ذلك بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه سعى بين الصفا والمروة، وقال لأصحابه – رضي الله عنهم – إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا، والمكتوب ركن» ، وقال – صلى الله عليه وسلم – «ما أتمّ الله تعالى لامرئ حجة ولا عمرة لا يطوف لها بين الصفا، والمروة».
وجحتنا في ذلك قوله تعالى «فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُناح عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» (البقرة، 2 / 158)، ومثل هذا اللفظ للإباحة لا للإيجاب فيقتضي ظاهر الآية أن لا يكون واجبا، ولكنا تركنا هذا الظاهر في حكم الإيجاب بدليل الإجماع.[14]
كما رأينا في المثال السابق فإنّ جميع المذاهب الأربعة ترى وجود التضاد بين الآية والحديث المتعلقين بالسعي بين الصفا والمروة. فمذهب الشافعي ومالك وكذلك ابن حنبل في أحد الروايتين عنه يأخذون الحديث ويتركون الآية. أما الحنفية فيقولون نأخذ الآية ونترك الحديث، ولكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل تركوا الآية كذلك، وقالوا بوجوب السعي استنادا على الإجماع المزعوم، والمعنى المراد بالوجوب عند الحنفية لا يوجد عند المذاهب الأخرى. فلا يمكن قبول دعوى الإجماع والحال هكذا.
وإذا نظرنا إلى الموضوع في ظل الكتاب والسنة معا يتبين لنا أنه كان صنم بالصفا يدعى إساف، ووثن بالمروة يدعى نائلة، فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام رُمي بهما، وقيل: إنّما كان يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم، فأمسكوا عن السعي بينهما.[15] فأُنزلت الآية تبين أن السعي بين الصفا والمروة ليس للصنم بل هو لله تعالى لأنهما من شعائره تعالى.
وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْي” حكمة مستنبطة من القرآن الكريم؛ ولكن علينا أن نجد الآية الثانية التي تفسر الآية الأولى، وهو نسميه المبدأ الثنائي في فهم الآيات القرآنية. قال الله تعالى: « الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِير؛ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ؛ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ» (هود، 11 1-3).
والآية الثانية التي تتعلق بموضوع السعي وجدنانها في قوله تعالى: « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » (البقرة، 2 / 196) وهي تشير إلى أنّ السعي في الحج والعمرة ركن ناقص.
والسعي هو ركن مشترك في الحج والعمرة. وقوله تعالى في الآية «فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلاَ جُناح عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» يدل على أنه ليس هنالك نقص في الطواف بالبيت؛ وعليه فالنقص هو السعي بين الصفا والمروة؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” ما أتمّ الله تعالى لامرئ حجة ولا عمرة لا يطوف لها بين الصفا والمروة ” وقال” اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْي”؛ لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة.
وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم المسالة، كما دل عليه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: ” لعمري ما أتم الله حج من لم يسع بين الصفا والمروة ولا عمرته”.[16]
وهكذا يظهر التوافق التام بين الكتاب والسنة وقول الصحابة. فهذا الموضوع مثال للحكمة الموجودة في القرآن الكريم، التي علَّمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
ولم يفهم قوله تعالى: «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه» الآية 196 من سورة البقرة؛ لأن النّاس قد نسوا طريق فهم القرآن بالقرآن الذي هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحكمة المستنبطة من القرآن الكريم.
وهذا النسيان قد تسبب في ظهور المشاكل الأخطاء في فهم كثير من الآيات القرآنية وتطبيقها في الحياة اليوميّة. إنّ اعتبار السنة وحيا غير متلو ومصدرا مستقلا عن القرآن الكريم وقاضية على الكتاب من تلك الأخطاء الجسيمة.
الفرق بين الحكمة التي استنبطها النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة التي استنبطها الناس
كما رأينا في الآيات التي تتحدث عن غزوة البدر، فإنّ الله تعالى لا يدع نبيه صلى الله عليه وسلم يخطئ في فهم حكمة الكتاب إلا صوبه ، فإذا ما صدر منه خطأ في الحكم نبهه الله عليه وبيَّن له الصحيح منه. فالأحكام التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن تنبيه على خطأ فيها من الله تعالى فكلها حكمة يجب على المسلمين اتباعها. قال الله تعالى:
«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (النساء، 4 / 65).
والأحكام التي يستنبطها علماء المسلمين لا بد من عرضها على الكتاب والسنة، لأنّهم ليسوا كالنّبي صلى الله عليه وسلم الذي يراقبه الله تعالى وينبهه على خطئه. قال الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (النساء، 4 / 59).
فالآية تشير إلى وجوب وجود هيئة من العلماء يُلجأ إليها حين الإختلاف؛ حيث تقوم بإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض حياة المسلمين حكاما ومحكومين، وتُصدر أحكامها على ضوء الكتاب والسنة. ولكن لم تر مثل هذه الهيئة في التاريخ الإسلامي.
فخلاصة القول إنه يجب على المسلمين أن يبادروا بالعودة إلى الكتاب والسنة من جديد، على اعتبار أنّهما مصدر واحد غير منفصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، كتاب الحاء.
[2] مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، باب العين.
[3] صحيح البخاري، باب الاغتباط في العلم والحكمة.
[4] صحيح البخاري، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما.
[5] سنن أبي داود، باب في لزوم السنة.
[6] الرسالة للشافعية، صـ . 78.
[7] الرسالة للشافعية، صـ . 79.
[8] أنظر: الأنفال، 8 / 7.
[9] Hayrettin KARAMAN, Ali ÖZEK, İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Mustafa ÇAĞIRICI, Sadrettin GÜMÜŞ, Ali TURGUT, Kur’anı Kerim ve Açıklamalı Meâli, TDV yayınları, Ankara 2005.
[10] الرسالة للشافعي، صـ . 91-93.
[11] أحمد بن حنبل، ج . 6 / ص . 421؛ ابن حزيمة، 2765.
[12] صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، ج. 9 / ص. 20-21.
[13] كتاب المجموع للنووي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، بيروت، ج. 8 / ص. 65-66.
[14] المبسوط لشمس الدين السرخسي، ج. 4 / ص. 50.
[15] أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، بيروت ج. 3 / ص. 500، كتاب الحج وجوب السعي بين الصفا والمروة.
[16] مسلم، الحج، 260 (1277).
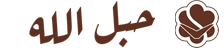


اذا الكتاب بمعنى الوحي المنزل فما معنى الكتاب في الآبتين الكرمتين؟
﴿وَیُعَلِّمُهُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِیلَ ٤٩﴾ [آل عمران ٤٨]
﴿ إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ یَـٰعِیسَى ٱبۡنَ مَرۡیَمَ ٱذۡكُرۡ نِعۡمَتِی عَلَیۡكَ وَعَلَىٰ وَ ٰلِدَتِكَ إِذۡ أَیَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِی ٱلۡمَهۡدِ وَكَهۡلࣰاۖ وَإِذۡ عَلَّمۡتُكَ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِیلَۖ وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّینِ كَهَیۡـَٔةِ ٱلطَّیۡرِ بِإِذۡنِی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَكُونُ طَیۡرَۢا بِإِذۡنِیۖ وَتُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ بِإِذۡنِیۖ وَإِذۡ تُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِیۖ وَإِذۡ كَفَفۡتُ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ عَنكَ إِذۡ جِئۡتَهُم بِٱلۡبَیِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡهُمۡ إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّا سِحۡرࣱ مُّبِینࣱ ١١٠﴾ [المائدة ١١٠]