الدين والدولة
تمهيد
نحن مدينون بكل ما نملك لله تعالى، ولا نملك سوى ما آتانا الله؛ قال تعالى «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ».[1]
وكل إنسان يؤمن بذلك، ويعبر عن إيمانه بطريقة ما. كما يؤمن به الوثنيون الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله، لأنهم يعتبرون الأصنام رموزا لبعض الأشخاص المعنويين القريبين من الله تعالى. وهي عقيدة باطلة لا يقبلها العقل، لأنها تقوم على الأساطير ولا تستند على الأدلة الصحيحة. وهي وما شابهها من العقائد شرك يجب تجنبه.
الملاحدة الذين يُعرفون اليوم بأنهم لا يؤمنون بإله قط، هم في الحقيقة يؤمنون بالله. وتسميتهم إياه بـ "الطبيعة أو إله السماء أو بأي شيء آخر" فهذا لا يغير من طبيعة الأمر، فلا يمكن انكار وجود الله الذي خلق الموجودات كلها وهو الحاكم الوحيد لهذا الكون. إذن فمثال من ينكر وجود الله تعالى بمثابة من ينكر أباه. فالملحد يلجأ إلى الله إذا ألجأته الضرورة وتراكمت عليه المشكلات، كما يعود الابن الهارب من أبيه إليه عند تراكم المشاكلات عليه. فالملاحدة يرويدون أن يعطيهم الله كل شيء سوى الأمر أو النهي. وهناك فريق آخر من الناس يقبلون أن يكون الله مشرعا، ولكنهم يذهبون إلى تصنيف الأوامر والنواهي، فيقبلون ما وافق هواهم ويرفضون ما يخالفه. فهم أمثال الشيطان الذي رفض أمرا من أوامر الله تعالى فأصبح مطرودا. على الرغم من أنه كان يؤمن بالله وباليوم الآخر ويؤمن بكل ما يجب الإيمان به، ولكن عدم موافقته على أمر واحد من أوامر الله تعالى جعله مطرودا.
ومن المعلوم أنّ العقيدة تؤثر في جميع شؤون الإنسان، أي يظهر أثر العقيدة فيه سواء في حياته الخاصة أو الإجتماعية. والعقيدة قابلة للتغيير، أي أن الإنسان يمكن أن يغير عقيدته، بقبول دين جديد مثلا، ولكنه لا يستطيع أن يخرج من البيئة التي عاش فيها بتغيير عقيدته. ومن أجل ذلك على كل مجتمع أن يكون مستعدا أن يقبل التايعش مع أصحاب العقائد المختلفة في بيئة واحدة. وفي العصر الذي تطورت فيه وسائل النقل والاتصالات، وكثرت الهجرة من البلدان المختلفة وإليها، وجدنا أنفسنا مضطرين أن نعيش مع أصحاب العقائد المختلفة. لأن المهاجر يترك البيئة التي عاش فيها، ولكنه يهاجر بعقيدته. والمنطق السليم يمنع إكراه الآخر لقبول عقيدة ما.
ولكن الكثيرين بعيدون عن المنطق. لذا تكثر المشكلات في البيئات التي يعيش فيها أصحاب العقائد المختلفة. وللخروج من حالة الإحتقان التي تحكم علاقات أصحاب العقائد المختلفة فلا بد أن يسود في المجتمع الرأي الصحيح، المتمثل في توفير المناخ المناسب لأفراد المجتمع بأن يعيشوا حسب معتقداتهم.
إنّ من المؤسف حقا أن نرى أصحاب النفوذ والصدارة في المجتمعات يحرصون على أن تكون القوة هي المهيمنة وليس الرأي الصحيح. وهو مما يؤدي إلى الظلم والإضطهاد.
والذي يريد أن تكون القوة هي المهيمنة بدلا من الرأي الصحيح، هو في الحقيقة يريد أن يكون الناس عبادا له. ويلجأ البعض إلى قوته المادية والبعض إلى سلطة الدولة والبعض الآخر يجعل من الدين وسيلة لنيل مرادهم. ومن أجل ذلك فإنّ قضية الحرية _على مر التاريخ_ كانت من أهم القضايا البشرية.
إنّ كثيرا ممن قاموا بالنضال من أجل الحرية قد حاولوا استعباد الآخرين عندما صاروا أصحاب نفوذ وسلطة، وهذه حقيقة يشاهدها ويدركها كل الناس. إنّ الديانة السماوية ترفض الإكراه على الدخول في الدين؛ ولا يصح الإلجاء والقهر بعد أن بانت الأدلة والآيات الواضحة الدالة على صدق النّبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلّغه عن ربه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن أجل ذلك جاهد الأنبياء جميعا. وكان هدفهم الأساسي هو إنقاذ الأمم والأفراد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وتلك هي المهمة المشتركة لجميع الأنبياء والمرسلين.
العبادة في اللغة؛ تعني العبودية المطلقة، أي الإنقياد الكامل المطلق. وعلى هذا فالإنقياد المطلق لغير الله تعالى عبادة له. ولكن الذين يريدون جعل الدين وسيلة من وسائل القهر والجبر، يبعدونه أولا عن سنن الأنبياء، ويجعلونه مبهما. ويستولون على أمور الدّين بإنشاء مؤسسات دينية رسمية، مع أن الدين أمر فردي، وتتعلق عملية قبول الدين أو رفضه لدى هؤلاء بمراسم رسمية، كالحال في الديانة المسيحية، حيث تحتكر الكنيسة الدّين على اعتبار أنّ لها لها الحق الحصري في إدخال الناس إلى الدين أو إخراجهم منه. كما أنهم حققوا في ظل تلك المؤسسات الدينية آملهم في السيطرة على الدولة وإدارتها باسم الله. وحين سيطروا على الدولة باسم الله استفادوا من جميع امكانيات الدولة، ولكنهم حملوا المسؤولية على الله في المشاكل الإجتماعية والاقتصادية، من فقر وظلم وقهر؛ قائلين: هذا مما قدر الله عليكم.. وهم بفعلهم هذا قد تركوا المسؤولية وهربوا من تحملها، لأنه لا يمكن لأحد أن يحاسب الله، لأنه سبحانه لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.
وهكذا النظام في الدولة الثيوقراطية. والثيوقراطية، تعني دخول الدولة تحت أمر الكنيسة. كما توجد التنظيمات المناسبة لها في الديانة المسيحية. وهو أمر مرفوض قطعيا، لذا كان الكفاح ضد الثيوقراطية كفاحا محقا. وقد سُمي هذا الكفاح بـ "العلمانية". و العلمانية التي كانت رمز الثورة ضد الثيوقراطية أصبحت من سائل القهر والإضطهاد على المعتقدات. حتى أصبح من يريد استعباد الناس وسحب الحرية منهم يعتمد إمّا على الدين أي الثيوقراطية وإمّا على العلمانية.
إن الظروف الخاصة التي أدت إلى ظهور الحكم الكنسي (الثيوقراطية) في الغرب ومن ثم الثورة العلمانية لم تتوفر في العالم الإسلامي. وكان وجود القرآن الكريم مانعا دون ذلك؛ حيث وضع القرآن الكريم المبادئ المثالية للعلاقات بين الدّين والدولة. وهي مبادئ يقبلها كل من تجنب التصرفات العاطفية والأحكام المسبقة.
لقد بحثنا في هذه الدراسة الهيكل الذي يجب أن تبنى عله العلاقة بين الدين والدولة في ضوء القرآن الكريم، وهو كتاب الله الأخير الذي وصل إلينا بدون أن يعتريه التغيير أو التبديل، ويبقى هكذا حتى تقوم الساعة. ثم وقفنا على موضوعي الثيوقراطية والعلمانية، وحاولنا دراستهما بالتفصيل في ضوء الكتاب المقدس والقرآن الكريم.
وقد كان أسلوبنا في معالجة الموضوع هو الإعتدال وعدم التطرف. وبذلنا الجهد في إظهار المآزق التي وقع فيها من أراد السيطرة على الناس عن طريق الثيوقراطية أو العلمانية. وأردنا بذلك إظهار الحقائق، التي يعرفها الكثيرون منا ولكن التطبيق لا يخدم مصالح البعض، كما هو بين.
ويسرنا أن يستفيد المنصفون من هذه الدراسة وهذا مقياس نجاحنا.. وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب.
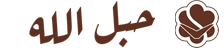


بارك الله فيكم وجعل عملكم في ميزان حسناتكم