الدولة والأحزاب السياسية
ينصّ الدستور التركي على حظر إقامة أي حزب سياسي يهدف إلى جعل الدولة تحت سيطرة شخص أو مجموعة معينة، كما ينصّ على ضمان عدم هيمنة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات، أو تمييز طبقة معينة على غيرها حسب اللغة أو العرق أو الدّين، أو إقامة نظام سياسي يعتمد على تلك المفاهيم.[1] هكذا أُقر الدستور، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعضا من الحكام يتصدرون المشهد العام جاعلين من أفكارهم أساسا في تصريف شؤون الدولة ويجبرون الناس على قبولها، وهذا التفرد السلطوي لهؤلاء الحكام مهّد الطريق لإقامة أحزاب تتمايز بالعرق واللغة والدين.
ثم ما يلبث إلا أن تقام أحزاب أخرى مخالفة للأحزاب الأولى فتتكاثر الأحزاب، ولكل واحد منها أتباع يشكلون القاعدة الخاصة لكل حزب، ويتسلح الأتباع بالأفكار والرؤى الخاصة بحزبهم، ويعملون جميعا على تحقيق هذه الأفكار. يترتب على كثرة الأحزاب واختلاف مشاربها ورؤاها وبرامجها عواقب وخيمة على المجتمع، تتمثل في الإحتكاكات بين الأحزاب، وانقسام المواطنين إلى فرق وجماعات، فتتلاشى الطاقات وتهدر امكانيات البلد بسرعة غير متوقعة .
إنّ محاولة الحكام فرض أفكارهم على الآخرين سبب في توتر الجو العام، مما يسمح بقيام معارضة قوية غير سلمية تحاول بكل قوة خلع هؤلاء الحكام؛ وهذا يعني حدوث صراعات طائفية أو عرقية أو مذهبية، حيث تتنافس كل طائفة على الوصول إلى الحكم. ولذلك يناضل كثير من الأحزاب السياسية حتى يجعل من أفكاره حكما بدلا من أن تتنافس في تقديم الخدمات للمواطنين. وفي مثل هذه البيئة لا مفر من حدوث صراعات مستمرة.
ولا يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية إلا بإزالة الأسباب الإجتماعية والحقوقية التي مهدت لتلك البيئة. كما أنّ محاولة وضع حد لعدد الأحزاب السياسية في 12/9/1980 م باءت بالفشل. فتكاثرت الأحزاب السياسية فلم يعد بمقدور أحدها تحقيق أغلبية برلمانية، فأصبح الحزب الذي يحظى بـ 20% من أصوات الناخبين يُكلف بتشكيل الحكومة. ولا يمكن للأحزاب السياسية أن تتنافس في خدمة المواطنين إلا إذا ابتعدت عن مواقفها الأيديولوجية.
إنّ تأسيس الأحزاب القائمة على أساس الدين قضية في غاية الأهمية؛ لأن جُلَّ الصراع الموجود في تركيا موجه ضد الدين الإسلامي؛ وإليك تفصيل ذلك:
أ. الحزب القائم على أساس الدين
نرى أن مصطلح "الحزب الإسلامي" مصطلح غير صحيح. فليس هنالك حزب إسلامي, ولكن يمكننا أن نسميه بـ "حزب المسلمين". وبين التسميتين بون شاسع؛ فالإسلام دين هدفه هداية الناس إلى طريق السعادة في الدارين. فلا يجوز أن يكون وسيلة لنيل المنافع الدنيوية، وقد قال كل واحد من الأنبياء والرسل: «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الشعراء، 26 / 180).
الذين يعارضون الدين قد خلطوا بين الأمرين؛ تبليغ الدين والصراع على السلطة. ومن هنا نعرف أهمية الحوار الذي جرى بين موسى عليه السلام وفرعون مصر، قال الله تعالى: «وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (الأعراف، 7 / 104-105). وقال: « أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؛ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ؛ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ؛ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ؛ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ؛ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» (الشعراء، 26 / 17-26).
نرى في هذه الآيات بوضوح أنّ فرعون يحاول تقديم موسى كمن يصارع على السلطة، بالرغم من وضوح ما يريد وهو أن يرسل معه بني إسرائيل، فيقول: «فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ». أما الملأ من قوم فرعون: «قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى» (طه، 20 / 63). وفرعون يعرف جيدا أنّ موسى عليه السلام لا يريد منه غير أن يرسل معه بني إسرائيل، لأن قول الحق ليس من مصلحته، لذلك تصرف كأنه لمس أنّ لموسى أهدافا أخرى، فبدأ بتغرير شعبه وتأليبهم عليه.
لذا ليس من الصحيح أن يكون الإسلام وسيلة للوصول إلى الحكم، لأن هذا يؤدي أن يتخذ الحكام مواقف تلقائية تتميز بالسلبية تجاه الإسلام ؛ لكي لا يفقدوا ما في أيديهم من السلطة السياسية. كما أن استخدام الإسلام وسيلة للوصول إلى الحكم يحرك وينشط المولعين الطامحين إلى السلطة. وفي نهاية المطاف يعلن البعض عداءه للإسلام ليحفظ عرشه هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى يجعل البعض الآخر من الدين الإسلامي وسيلة لتحقيق الأهداف في الوصول إلى الحكم. والنتيجة أنّ كلا الطرفين شكلّ مانعا من التفكير الصحيح حول الإسلام.
لا يوجد حزب للإسلام، ولكن من الممكن أن يكون للمسلمين حزب أو أحزاب كثيرة. وهم يطرحون برامجهم، حيث يثبتون من خلالها أنهم على قدر المسؤولية، ويشتركون مع الأحزاب الأخرى في المنافسة ليصبحوا حزبا حاكما. والحزب الفائز له الحق في تشكيل الحكومة، يحكم بإسم نفسه وليس بإسم الدين. فإن أحسنوا في الحكم فلهم أجرهم، وإن أساؤوا فعليهم وزرهم. ذلك أنه لا يصدر من الإسلام خطأ، أما المسلم فمن الممكن أن يخطئ.
حرية الدين قضية مهمة للغاية، والإعتراف بحرية الإعتقاد دون حرية الدين لا يعني شيئا، لأنّ الإعتقاد من عمل القلب، أما الدين فليس كذلك. وعند اطلاق كلمة "الدين" يفهم منها جميع أوامره ونواهيه. فالحرية الدينية تعني أن يحيى الإنسان حسب ما يعتقد. والإسلام يوفر للإنسان أن يحيى حسب ما يعتقد، ويحرم الضغوط على دينٍ ما أو تحقيره أو إهانته. وفي ظل هذا الفهم أذنت الدولة العثمانية بفتح الخمارة وتربية الخنازير لغير المسلمين. ومنعت المسلمين عن ذلك. وقد وجد غير المسلمين حريتهم الدينية في ظل الدولة العثمانية، لذا لجأ إليها اليهود الذين هربوا من أسبانيا وعاشوا أسعد حياتهم في ظلها، وقد أنشأ اليهود مؤسسة خيرية بإسم (المئة الخامسة) لتكون ذكرى لتلك الأحداث.
أما اليوم فلم يبق من ذلك الجو المتسامح شيئا؛ لأن الملاحدة وغير المتدينين من أصحاب الصدارة في الحياة الإجتماعية والإقتصادية قد نبذوا التسامح وسلكوا طريق التطرف والتشدد. وقد تظاهر البعض من الملاحدة كأنه مسلم، فازدادت المشاكل تعقيدا. والأحزاب السياسية التي أسست منذ العام 1946 م أصبحت تتنافس في استغلال الشعور الديني عند الشعب للحصول على مزيد من الأصوات الإنتخابية. ليسوا سواء فمنهم أصحاب النوايا الحسنة، كما أنّ منهم من يريد استغلال الشعور الديني للوصول إلى مبتغاه.
وقد جاء في المادة 24 من الدستور التركي ما يلي: ليس من حق أحد أن يستغل الدّين أو الشعور الديني أو الأماكن الدينية. فاستغلال الدّين نفاق، ومن الصعب أن يُفرق النفاق من التدين الحقيقي، لا سيما حينما يحدث الإختلاف والتنازع في الأمور الدينية فتسنح الفرصة أمام المنافقين للطعن في الدين والإساءة إليه؛ حتى إنّهم ليتهمون المؤمنين الحقيقيين بأنهم يستغلون الدين، وهذا قلب للحقيقة رأسا على عقب. وهو ما يحدث الآن في تركيا. كما أن هناك من يعادي كل ظاهرة دينية باسم العلمانية، ويعمل جاهدا على إبعاد الناس عن الدين بمنع التعليم الديني باسم الحداثة والمعاصرة، وقد يبرر فعله بأنه ضد الإستغلال الديني متظاهرا أنه يحترم الدين، ظنّا منه أنّ هذا الموقف سيقلل من ردود الفعل الغاضبة عليه، ولكن العاقبة تأتي بعكس ما يريد، حيث تزداد ردود الفعل حدة كلما شعر المسلمون نفاقه واستهزاءه بهم. وقد كان النفاق مشكلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم. قال الله تعالى: «وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» (النساء، 4 / 81).
ومن المعلوم أنّ الدّين عالمي لا يقف عند حدود الزمان والمكان. وبعبارة أخرى فإنّ للدّين قواعد لا تتغير وإن تغيرت الأماكن والأزمنة، أمّا سياسات الدول وقوانينها فإنّها تتغير حسب الزمن والمكان وفقا للاحتياجات والظروف الطارئة. والدولة المعترِفة بحرية الدين فإنّها تنظم قوانينها وفقا لما يتطلبه مفهوم الحرية الدينية. فليس من المنطقي أن تفرض الدولة قانونا يلغي شعيرة دينية، لأنه من المستحيل أن يقبل المتدين التعديل في دينه.
ولمزيد من التوضيح نضرب هذا المثال: ورد في الآية 31 من سورة النور الأمر للمؤمنات بتغطية رؤوسهن، وهو أمر قد لقي قبولا عند كل المؤمنين والمؤمنات منذ نزول الآية حتى يومنا هذا بدون أدنى خلاف. وجلُّ المسلمات في تركيا والبلدان الأخرى يغطين رؤوسهن. ومنع المسلمات من غطاء رؤوسهن هو تعد على الحرية الدينية، وقد أحدث ذلك احتجاجات واسعة في بعض البلدان. ولا تزال تلك الاحتجاجات وستبقى ما دام القرآن الكريم موجودا. كما لا يزال من يستغل هذه القضية ما دامت الإحتجاجات موجودة. حيث يدافع حزبٌ عن غطاء المسلمات رؤوسهن والآخر يخالف.
كما أن محاولة الملاحدة وغير الملتزمين حصرَ الدين في الضمائر هو لإيجاد بيئة مناسبة تُطبّق فيها العلمانية كنظام لاديني معادٍ للدين. فلا يبقى بعدئذ مجال للعقل أن يفكر إلا وفقا لما تهوى الأنفس. وفي هذه الحالة المشوشة تعقد الإنتخاباتُ، ويصوت المناخبون للأحزاب حسب الشعور والعاطفه. ولا يهمهم ما تقدمه الأحزاب من الخدمات للمواطنين لتطوير البلد؛ إلا ما يوفر للمتدينين من الإمكانيات لأداء شعائر الدين فقط. أما الملاحدة ومن معهم من المنافقين فأكبر همهم منع الناس وإبعادهم عن الدين. وبهذا يفوز النوعان من الأحزاب ويدخلون البرلمان ويترتب على ذلك فساد سياسي عريض. أما المخلص من الساسيين إما أن يختفي كليا بسبب مواصلته خدمة المواطنين بإخلاص، أو يغير موفقه السياسي حسب المصالح.
ولكن حسب مفهومنا التقليدي للدولة، لا يمكن إستغلال الدّين ما دامت الدولة لا تتدخل في أمور الدين. وبهذا لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وفي حال كهذا يُفتح الطريق أمام المخلصين من السياسيين لخدمة الدولة، ويقل عدد الأحزاب السياسية، لأنه لا يبقى هناك شعور ديني ليُستغل. كما تتولد الحاجة لتدريب السياسيين المخلصين، وهو أمر ليس بسهل؛ إذ إنه يحتاج إلى المعرفة الكافية والخلفيات الثقافية والكوادر المؤهلة. أما استغلال الشعور الديني فليس بأمر صعب، فيلجأ إليه العابثون فيفوز فيه أصحاب الأصوات العالية والمتفننون في الكذب.
ب. الجمهورية الإسلامية مثل إيران
لا يقبل الدين الإسلامي الرهبنة. جميع الناس متساوون عند الله تعالى، إلا عند المذهب الشيعي، فهم مختلفون فيمن يتولى حكم الدولة. فالرأي السائد عندهم أن الإمام أي رئيس الدولة لا بد من أن يُعيَّن من قبل النّبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معصوما من جميع الذنوب. وقد اتفق الشيعة على أن هذا الشخص هو علي رضي الله عنه، وبناء على هذا فإن رئاسة الدولة عندهم ليست وظيفة سياسية بل هي مقام ديني. وإليك رأيهم في الإمام أي رئيس الدولة:
"إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله . وليست هي بالإختيار والإنتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه."[2]
والخصائص التي يمتاز بها الإمام عند الشيعة كالتالي:
" أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت، عمدا وسهواكما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة، بلا فرق."[3]
ويعبر الشيعة في إيران عن صفات الإمام ومعارفه على النحو التالي:
" إن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام . . . أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. وإذا استجد شئ لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي، لا يخطئ فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلا للزيادة والإشتداد. رغم أنهم لم يتربوا على أحد، ولم يتعلموا على يد معلم، من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى. وما سئلوا عن شئ إلا أجابوا عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة ( لا أدري )، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك."[4]
أما عقيدة الشيعة في طاعة الإمام فهي كالتالي:
"أن أمرَهم أمرُ الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله تعالى. فيجب التسليم لهم والإنقياد لأمرهم والأخذ بقولهم."[5]
إنّ هذا الرأي لا يمكن أن يقبل عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب السائد في تركيا. لأن رئاسة الدولة عندهم مقام سياسي؛ لأنّه لا يوجد آية ولا حديث تنص على غير ذلك. وما يقول الشيعة في حق أئمتهم لا يقوله أهل السنة والجماعة في حق الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ» (آل عمران، 3 / 144). والرسول في اللغة العربية يقال لمتحمل القول والرسالة.[6] يعني الرسول هو من كلف بتبليغ قول شخص إلى شخص آخر بدون زيادة ولا نقصان.[7] وفي الإصطلاح الديني: من إختاره الله تعالى لتبليغ أحكامه إلى الناس.[8] وقد بين الله تعالى أن وظائف الرسل على ثلاثة أنواع؛ الأولى: التبليغ. يقول الله تعالى: «فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» (النحل، 16 / 35)؛ « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (المائدة، 5 / 67). والثانية: بيان أوامر الله تعالى قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (إبراهيم، 14 / 4). والثالثة: التبشير والإنذار؛ يقول الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (سبأ، 34 / 28).
فليس من حق الرسول أن يكره الناس على قبول رسالته وقد أعطى الله تعالى للناس الحرية التامة في قبول دينه قال الله تعالى: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ؛ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» (الغاشية، 88 / 21-22).
ولا يُعطى للرسل شخصية فوق العادة، فهم بشر مصطفَون. وقد أيّدهم الله تعالى بالمعجزات، ومعجزة كل رسول تثبت أنه مرسل من الله تعالى، كما أن شخصا ذا سمعة قال يوما إني سفيرٌ لأمريكا لدى أنقرة، فمن الطبيعي أن تطلب دولة تركيا منه وثيقة تثبت أنه مرسل من قبل الإدارة الأمريكية الرسمية. وهكذا معجزة الرسول، وثيقة تدلّ على أن الله تعالى أرسله إلى الناس، فسميت معجزة لأن الناس يعجزون عن ترتيب مثل هذه الوثيقة.
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا. والفرق الوحيد كونه رسول الله. قال الله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (الكهف، 18 / 110).
وهكذا وجد فريقان مختلفان؛ أحدُهما الشيعة الذين يقدسون أئمتهم. والآخر أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الرسول بشر كأي بشر إلا أنه يوحى إليه. الأول يرى أنّ رئاسة الدول مقام ديني؛ أما الثاني فيرى أنها وظيفة سياسية. كما أنّ أهل السنة والجماعة لم يسموا الدولة بالدولة الإسلامية، بل سموها بالدولة العباسية والدولة السلجوقية والدولة العثمانية. وفي عهد الخلفاء الراشدين لم يكن للدولة اسم، وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل على أن تسمية الدولة بالدولة الإسلامية ليست من الدين. ومن الخطأ البين إعتبار الشيعة مثل أهل السنة والجماعة في النظرة إلى الدولة ورئيسها مع وجود هذا الفرق الشاسع. ومن لا يعرف هذا الفرق في تركيا فإنه يدعو إلى إقامة دولة إسلامية مثل إيران.
[1] المادة: 14 و 69 من الدستور التركي
[2] العقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ص. 65.
[3] العقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ص. 66.
[4] العقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ص. 66.
[5] العقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ص. 66.
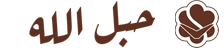


أضف تعليقا