الباب الأوَّل: العلاقةُ بين الدِّين والدَّولة
1. موقعُ الدِّين من الدَّولة :
الدَّولةُ هي مُؤسَّسةٌ، ولا يُقالُ عن المُؤسَّسةِ إنَّها مُتديِّنةٌ أو غيرُ مُتديِّنةٍ، فالدَّولةُ لا تُصلِّي ولا تصومُ ولا تهتمُّ بالآخرة، وكذلك المُؤسَّساتُ الأُخرى أيضاً، فهي ليستْ ذاتَ عقلٍ كي تدينَ، لذلك لا يصحُّ أن تُوصَفَ بالتَّديُّنِ أو عدمه، أمَّا الإنسانُ فهو خليقٌ بهذا الوصف إنْ كان مُتديِّناً، والأشخاصُ الذين يُديرون الدَّولة أو المُؤسَّسة يُظهرون أثَرَ معتقداتِهم في شؤون إدارتهم لتلك المؤسَّسات، وهو أمرٌ طبيعيٌّ.
ويُطلقُ على الدَّولة التي يحكمُها المُسلمون “دولة إسلاميَّة”، ومن هنا سُمِّيتْ الدَّولةُ التي يحكمها المسيحيُّون “دولة مسيحية”.
ليسَ منَ الطَّبيعيِّ أن يُجبِرَ الحُكَّامُ الشَّعبَ على قبول معتقدٍ ما؛ لأنَّ ذلك مخالفٌ للمنطق السَّليم ،كما أنَّه مُخالفٌ للمبدأ الأساسيِّ الذي يقوم عليه الدِّينُ الحقُّ وهو عدمُ الإكراه في الدِّين.
وبسبب تلك المُخالفات تنشأُ الدَّولةُ الدِّينيَّةُ أو الإيديولوجيَّة، وكثيراً ما تحدث الصِّراعاتُ الدَّاخليَّةُ بسب الاضطهاد والظُّلم النَّاتج عن الإكراه في أمور العقيدة، لأنَّ المُعتقدات لا يمكنُ تغييرُها بالقوَّة.
أصلُ الدِّين هو الإيمان الذي يعني التَّصديقَ بالقلب، وهو كامنٌ في أعماق الإنسان، حيثُ حُريَّتُه المُطلقةُ في القَبول أو الرَّدِّ، وهذا يعني أنَّ القلبَ خارجٌ عن قوانين الإكراه والإجبار، لذا لن يقبَلَ الإكراهَ على قَبول أيِّ عقيدةٍ.
قال الله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (البقرة، 2 / 256).
ومن أجلِ ذلك فإنَّ الإسلامَ لا يُجبرُ أحداً على أن يُصبحَ مُسلماً أو أن يكونَ سلوكُه كسلوك المسلمين، بل يُعطي لكلِّ واحدٍ الحُريَّةَ ليستطيعَ أن يعيشَ حسبَ إيمانه ومُعتقداته، لذا ليس في الإسلام دولةٌ ثيوقراطيَّةٌ أي (دولة دينيَّة).
فالإدارةُ في الإسلام ليستْ باسم الله بل باسم الشَّعب، فمَنْ أحسَنَ في الحُكم فإنَّه يُثابُ، أمَّا المُسيءُ فيتحمَّل المسؤوليَّة.
وعندما نُطلِقُ كلمةَ الدِّين في تركيا أو في أيِّ بلدٍ مسلمٍ فإنَّه يُفهَمُ منها الدِّين الإسلاميُّ ونبيُّ الإسلام والكتابُ الذي أنزلَه اللهُ تعالى عليه، ومَنْ أرَادَ أنْ يدخلَ في الإسلام فعليه أن يُؤمنَ وفقاً لما بيَّنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب؛ أي أنَّه يجبُ أن يلتزمَ القُرآنَ الكريم ويتَّبعَ أوامره.
هناك مَنْ يجعلُ القرآنَ تابعاً لهواه، فيتظاهرُ بالإسلام ولكنَّه يتَّبعُ الهوى، وحتَّى يستقيمَ له ذلك فهو يعمل جاهداً لإلغاء العمل ببعض الآيات والأحاديث التي لا تتوافقُ مع أهوائه، أو بتأويلِها حسب الهوى فيزعمُ مثلاً أنَّها محصورةٌ بفترةٍ مُعيَّنةٍ من التاريخ، وهكذا يزعمون أنَّهم قد جاءوا بالمفاهيم الحديثة للدِّين وبالتوفيق بينه وبين الحياة مع علمهم أنَّ جَعْلَ القرآنَ تابعاً للهوى عملٌ غيرُ صحيحٍ، ولكي يخرجوا من حَرجهم وضيق صُدورهم النَّاتجين عمَّا اقترفوه فإنَّهم يبحثون عن المُؤيِّدين لأفكارهم ليُريحوا بهم أنفسَهم، ظنَّاً منهم أنَّ الكثرةَ قد تُغني عنهم من الله شيئاً، فأمَّا القريبُ منهم والموافقُ لأهوائهم فيلقى الاهتمامَ ، وأمَّا الآخَرُ فيُستبعَدُ !
يتظاهرُ هؤلاء بالقوَّة، وذلك بالتَّلميح إلى أنَّهم يتكلَّمون باسم الدَّولة أو المؤسَّسة أو المُنظَّمة، وهو أسلوبٌ خاطئٌ لأنَّ المُتحدِّثَ في أمور الدِّين عليه أن يتحدَّثَ باسمه دون أن يخلطَ ذلك بمؤسَّسات الدَّولة، فلا يصحُّ أن يُقالَ “دولة مُتديِّنة” كما لا يصحُّ أن يُقال “دولة مُلحِدة”.
إنَّ التَّديُّنَ أو الإلحاد يصحُّ وصفاً للنَّاس فقط، وليس للدَّولة، لذا لا حقَّ لأيِّ شخصٍ أن يتحدَّثَ باسم الدَّولة أو المؤسَّسة أو المُنظَّمة من مُنطلق الدِّين، لأنَّ الدَّولةَ ليستْ جماعةً دينيَّةً مُشكَّلةً من أفرادٍ يتقاسمون نفسَ المُعتقدات والأفكار، بل يتواجدُ فيها المُنتسبون إلى الدِّيانات والمؤسَّسات والمُنظَّمات المختلفة.
والذي يتحدَّثُ باسم الدَّولة أو المؤسَّسة من مُنطلق الدِّين فلا بُدَّ أن يتظاهرَ بأنَّ أفكارَه هي نفسُ أفكار الأفراد المُنتسبين إلى تلك الدَّولة أو المؤسَّسة، وهذا غيرُ صحيحٍ، ومن الواجبِ ديناً على كلِّ مُسلمٍ أن يلتزمَ بالآيات والأحاديث الصَّحيحة.
إنَّ القُرآنَ الكريم هو ضمانُ حُريَّة الدِّين كما قالَ الله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» (يونس، 10 / 99). فلا بُدَّ أن يكونَ الإنسانُ حُرَّاً في الظَّاهر كما يكونُ حرَّاً في الباطن، وبهذا تتحقَّقُ الشَّخصيَّةُ الحقيقيَّةُ له.
إنَّ علاقةَ الدَّولة بمواطنيها لا يجبُ أن تعتمدَ على البُعد الدِّيني أو الفكري، بل يجبُ أن ترتكزَ على العَدالة، فالمهمَّةُ الأساسيَّةُ للدَّولة هي ضمانُ العدالة والأمن الدَّاخليِّ والخارجيِّ، والقضاءُ على العوائق التي تمنعُ تحقيقَ الحُريَّة الفكريَّة لدى المواطن.
إنَّ مَنْ يتظاهرُ بالإيمان بضغوطٍ من الدَّولة يكونُ مثلَ جرثومةٍ تُصيبُ الجسمَ بالمرض، أمَّا الذي يحظى بالحُريَّةِ الدِّينيَّة والفكريَّة، فإنّه يتولَّى مهمَّة حماية البلد.
إنَّ الحُريَّةَ الفكريَّةَ المُتمثِّلةَ بحريَّة الاعتقاد تمنحُ المجتمع حصانةً وحمايةً من الآفات التي يمكن أن تفتكَ به، تماماً كعمل المصل المضاد (التَّطعيم) الذي يقوم بتقوية جهاز المناعة في الجسم.
ومن الحقِّ القولُ بأنَّ الدَّولةَ العُثمانيَّةَ قد أنصفتْ عندما اعتبرتِ الأقليَّاتِ جُزءاً من مواطني الدَّولة، ونتيجةً لهذه السِّياسة كانَ مواطنوا تلك الأقلِّيَّاتُ يشعرون بالعزَّةِ فلا فرقَ بينهم وبين غيرهم من المواطنين، وكان هذا أمراً مُهمَّاً للغاية.
ينبغي أن تكونَ الدَّولةُ كالشَّمس، فكما أنَّ الشَّمسَ لا تُفرِّقُ بين المُسلمين والنَّصارى واليهود، ولا تُفرِّقُ بين الغنيِّ والفقير، ولا تُفاضِلُ بين الأقوام، كذلك يجبُ على الدَّولة أن تهتمَّ بالمواطنين على حدٍّ سَواء.
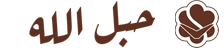


أضف تعليقا