النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام رئيسُ الدَّولة المثالي
أ.د عبد العزيز بايندر
مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رسولُ الله وخاتَمُ النبيِّين. ومَنْ لمْ يُفرِّقْ بين مُصطلحي النَّبيِّ والرَّسول جعَلَه خاتَمَ المُرسلين أيضاً، فعامَّة العُلماء يرون أنَّ الرَّسولَ هو مَنْ أُرسِلَ بكتابٍ وشريعةٍ جديدين، أمَّا النَّبيُّ فهو المبعوث بشريعةِ رسولٍ قبله. وعلى ذلك فبموتِ خاتم النَّبيِّين فلم يبقَ هناك رسولٌ مُكلَّفٌ بتبليغِ رسالة الله إلى النَّاس.
وبحسب التَّعريف التَّقليديِّ للنَّبيِّ والرَّسول فإنَّ إسماعيلَ عليه السَّلامُ هو نبيٌّ وليس برسول؛ لأنَّه لم يُبعثْ بكتابٍ وشريعةٍ جديدين. لكنَّ الآية 83 من سورة الأنعام وما يليها تُبيِّنُ أنَّ إسماعيلَ عليه السَّلام قد أُوتي الكتاب والحكمة[1]، وبحسب الآية التَّالية فإنَّه نبيٌّ ورسول :
{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا} (مريم، 54)
التَّفريق بين النَّبيِّ والرَّسول مُهمٌّ للغاية، الرَّسول: المُبلِّغُ عن آخر كلاماً دون زيادةٍ منه أو نقصانٍ، أمَّا النَّبيُّ فبحسب الآية 83 من سورة الأنعام وما بعدها فإنَّه الشَّخصُ المُصطفى الذي يُوحى إليه الكتابُ والحكمةُ.
الرَّسولُ قسمان: الأوَّل الرَّسول النَّبيُّ؛ فكلُّ نبيٍّ مُكلَّفٌ بتبليغ ما يُوحى إليه من الكتاب فهو بذلك رسولٌ ضمناً. فلا يوجد نبيٌّ لم يُرسلْ إليه كتاب، لكنَّ هناك من الرُّسل مَنْ لم يُرسَل له أيُّ كتاب. فقد بَعَثَ ملكُ مصر الى يوسف عليه السَّلام رسولاً وهو في سجنه : {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ} (يوسف،50)
وكذلك فعلتْ بلقيسُ حيثُ أَرسلتْ المرسلين إلى سليمان عليه السَّلام. {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} (النمل، 35)
وإذا لم يكن الشَّخصُ مُختاراً للنُّبوَّة فلا يُمكن أن نطلقَ عليه لفظ النَّبيِّ بحالٍ من الأحوال.
لقد خُتمتْ النَّبوَّة بمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، لذا لا كتاب بعد القرآن الكريم، يقول الله تعالى : {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (الأحزاب، 40)
وقد نصَّتْ الآيةُ على كونه خاتم النَّبيين وهذا يعني بالضَّرورة أن لا يكون خاتم المرسلين. لأنَّ عدم وجود نبيٍّ بعده يقتضي أن يكون هناك مَنْ يقوم بمهمَّة تبليغ القُرآن إلى النَّاس كافَّة.
يبقى مُبلِّغُ القُرآن رسولاً لحظة تبليغه إيَّاه إلَّا أنْ يُضيفَ تفسيراً أو شرحاً من لدنه فينتهي وصفُه بالرَّسول. ولو كان مُبلِّغُ الوحي نبيَّاً وزاد في التَّبليغ عمَّا هو مُكلَّفٌ به فجزاؤه الموتُ لا محالة. يقولُ الله تعالى :
{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (الحاقة، 44_47)
الرَّسولُ هو الذي يُبلِّغ عن الله كلامَه دون زيادةٍ أو نُقصان، لذا كانتْ طاعتُه واجبةً دون قيدٍ أو شرط، وطاعتُه لا لشخصه وإنَّما لما يُبلِّغه عن ربِّه. قال الله تعالى :
{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (النساء، 80)
وقد كان نبيُّنا مُحمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم يُبلِّغُ القُرآنَ بصفته رسولاً، ويُعلِّمه للنَّاس ويُطبِّقه بينهم بصفته نبيَّاً. يقول اللهُ تعالى :
{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} (النساء، 105)
وعندما يستخرجُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الأحكامَ من القرآن الكريم فإنَّ إمكانيَّة وقوعه في خطأ الاستنباط واردةٌ، لذا فإنَّ أيَّ كلامٍ للنَّبيِّ خارج إطار تبليغه للقرآن لم يُطلبْ من المؤمنين طاعتُه دون قيدٍ أو شرط، وإنَّما يجبُ طاعتُه في حدود المعروف. يقول الله تعالى :
{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنة، 12)
وقد كانت هذه النِّساءُ اللَّاتي جِئْنَ يُبايعن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الشَّريحةَ الاجتماعية الأضعف في المدينة، لأنهنَّ كُّنَّ مُهاجراتٍ من مكَّة فراراً بدينهنَّ، فلم يعد لهنَّ عوائل في المدينة ولا مُعيل. وبالرَّغم من حالة الضَّعف الظاهرة في هؤلاء المهاجرات إلَّا أنَّه لم يُطلب منهنَّ البيعةُ على الطَّاعة المُطلقة لرئيس الدَّولة وهو نبيٌّ كريم، وإنَّما طُلِبَ منهنُّ البيعةُ على الطَّاعة بالمعروف[2].
إنَّ الأخطاءَ التي يقع فيها المسؤولون ورجالُ الدَّولة يجب أن تُردَّ إلى حُكم الله ورسوله. قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (النساء، 59)
المؤمنُ لا يمكن أن يقعَ في نزاعٍ مع الله ورسوله، لكنَّه قد يقع في النزاع مع ولي الأمر من الحُكَّام والمسؤولين، والحلُّ يكمنُ في الاحتكام إلى كتاب الله تعالى. لقد كان مُحمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم يبلِّغُ القُرآن بصفته رسولاً، وطاعتُه إذ ذاك واجبةٌ قطعاً، لكنَّه كان يُطبِّقه على أرض الواقع بصفته نبيَّاً. ولمَّا كان عليه الصَّلاة والسَّلام رئيساً وقائداً للدولة فلا بُدَّ من أنَّه كان يعرض أفعالَه على كتاب الله ليراها موافقةً أو غيرَ موافقة. ولأنَّه لم يفعل ذلك في اتخاذه الأسرى يوم بدر كان عُرضةً للتهديد والوعيد. كما ورد في قوله تعالى:
{لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (الأنفال، 68)
في معركة بدر اتَّخذَ نبيُّنا صلَّى الله عليه وسلَّم قراراً خاطئاً بشأن الأسرى، وقد أيَّده جملةُ المسلمين في هذا القرار، لذا نزل العتاب الإلهيُّ للنَّبيِّ والمؤمنين شديداً:
{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (الأنفال، 67_68)
وبحسب الآية فإنَّ الدَّافع لهذا الخطأ الذي وقع فيه النَّبيُّ والمؤمنون كان تفضيلهم الحياة الدُّنيا على الآخرة: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ}
والسَّبب في نزول هذه الكلمات القاسية هو عدمُ الاحتكام الى آياتٍ نزلتْ سابقاً بخصوص الأسرى[3] :
{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} (محمد، 4)
وأمَّا قولُه تعالى في الآية 86 من سورة الأنفال {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فله ما يُبرره كما يلي:
قبل هجرة المسلمين من مكَّة حدثتْ حربٌ ضروس بين الرُّوم والفرس انتهت بهزيمة الرُّوم وانتصار الفرس، وقد نزلتْ سورةُ الرُّوم لِتُخبر أنَّ الرُّوم سينتصرون على الفُرس في الحرب القادمة التي ستحصل في بضع سنين (3-9). وانتصارُ الرُّوم على الفرس يحمل بشارةً بانتصار المسلمين على عدوِّهم. قال الله تعالى:
{الم .غُلِبَتِ الرُّومُ .فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (الرُّوم، 1_6)
وبسبب هذا الوعد الإلهيِّ فإنَّ كُلَّاً من المسلمين والمشركين من أهل مكَّة كانوا ينتظرون أخبارَ المعركة بين فارس والرُّوم. وفي السَّنة الثانية من الهجرة بينما كان أبو سفيان عائداً من الشَّام على رأس قافلةٍ تجاريَّةٍ تواردتْ الأخبارُ بانتصار الرُّوم على الفُرس انتصاراً ساحقاً، وقد كان ذلك حافزاً للمسلمين للخروج للقتال استعجالاً لوعد الله بالنَّصر، فخرجوا لاعتراض قافلة أبي سفيان والسَّيطرة عليها تعويضاً عن الأضرار الهائلة نتيجة هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم في مكَّة، لكن أبا سفيان علم بذلك فسلك طريقاً بعيداً على جهة البحر الاحمر واستطاع النَّجاة في القافلة، لكنَّ أهلَ مكَّة كانوا قد خرجوا لملاقاة المسلمين في بدر بقيادة أبي جهل، فوجد المسلمون أنفسَهم أمام جيش المشركين ولا بدَّ من المواجهة.
وهذا ما تُفيد به هذه الآيات:
{وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُون}. {الأنفال، 7)
لقد فاتتْ القافلةُ على المسلمين لكنَّهم واجهوا جيشَ المشركين في بدر، ولو تصرَّفوا بحسب القواعد الصَّحيحة لما اكتفوا بالانتصار الموضعي في أرض المعركة بل لواصلوا الطريق نحو مكَّةَ فاتحين، فقد كانت تلك إرادة الله تعالى: {وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ}
لقد حقَّقَ المسلمون انتصاراً مُستحقَّاً في بدر وألحقوا بالعدوِّ هزيمةً نكراء، لكنَّه كان انتصاراً موضعيَّاً، فبدلاً من متابعة فلول المهزمين حتى فتح مكَّة اكتفى المسلمون بالقبض على الأسارى طمعاً في الفداء، وقد حصل ذلك بموافقة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. وقد كان على الصَّحابة تذكيرُ النَّبيِّ بالآيات التي تنهى عن اتخاذ الأسرى قبل اثخان العدو لكنَّهم لم يفعلوا، لذلك كان الصَّحابة بحسب القرآن مخطئين تماماً كالنَّبي:
{تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ}
وقد أخذ النَّبيُّ من كلِّ أسيرٍ قادرٍ 4000 درهم فدية[4]. وقد ذكر الشَّافعيُّ أنَّه أخذ من بعضهم أقلَّ من ذلك وأطلق البعض دون فدية[5]. ولمَّا تحرّجَ الصَّحابةُ ممَّا أخذوه من الفدية نظراً للآية الأولى النازلة بحقِّ الأسرى وأرادوا التخلُّصَ من هذه الأموال باعتبار أصلها غيرَ صحيح نزل قولُه تعالى[6] :
{فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الأنفال، 89)
لقد كان السَّببُ في معاقبة الله تعالى آدم وحواء ترجيحهما الدُّنيا على الآخرة، فكان إخراجهما من الجنَّة نتيجةً حتميَّةً للمعصية. ولولا كتابٌ من الله تعالى سبق في نصرة النَّبيِّ وأصحابه لهُزموا شرّ هزيمةٍ في بدر، وبالرغم من تحقيقهم الانتصار إلَّا أنَّهم عادوا دون فتح مكة، لذا بقي ما اقترفوه من ذنبٍ عالقاً في رقابهم حتى فتح مكَّة في السَّنة الثامنة من الهجرة، وقد كان صُلحُ الحديبية في السَّنة السَّادسة من الهجرة قد مهَّدَ الطريق لقبول توبة النَّبيِّ وأصحابه ومن ثم فتح الطريق أمام مكة وفي ذلك يقول الله تعالى:
{إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} (الفتح، 1_2)
وقد أشارتْ سورةُ النَّصر التي نزلت بعد فتح مكَّة أنَّ توبةَ النَّبيِّ والمؤمنين قد شُرِّعت دونها الأبواب:
{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} (النصر،1_3)
وبحسب الآيات التي ذكرنا فإنَّ الحُكَّام وذوي النفوذ قد لا يستطيع أحدُهم مقاومةَ مغريات الدُّنيا حتى لو كان الواحدُ منهم نبيَّاً ، لذا يجب عدمُ تقديس أفعالهم لإمكانية وقوعهم في الخطأ، بل لا بدَّ من متابعة قراراتهم ومراقبة أدائهم وتصويب أخطائهم.
لا يقبلُ اللهُ _جلَّ شأنُه_ أن يَعبُدَ النَّاسُ غيرَه حتَّى لو كان المعبودُ نبيَّاً مُرسلاً أو ملكاً مُقرَّباً. والعبادة في اللُّغة تعني الخضوع التامَّ للمعبود دون قيودٍ أو شروط. والطَّاعةُ المُطلقة لا تصحُّ لغير الله تعالى. أمَّا مَنْ اختار الخضوعَ المُطلقَ لغير الله فقد رضي لنفسه العبوديَّة لمخلوقٍ مثله. والعبوديَّة لله ولغيره معاً لا يلتقيان أبداً. يقول اللهُ تعالى:
{قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ[7] فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً} (الإسراء، 84)
الذين يُفضِّلون الحياةَ الدُّنيا على الآخرة لهم طرائقُ شتَّى في الاحتيال على دين الله تعالى، وأبرزُ تلك الطُّرق الرَّفعُ من مكانة الأنبياء وأئمَّة العلم إلى مستوى لا يليق إلَّا بالله تعالى، وهم بذلك يجعلون منهم شركاءَ لله في دينه، فيعطونهم أحقيَّة الأمر والنَّهي، وعلى النَّاس واجبُ الطَّاعة. وكلُّ ذلك للقفز على كتاب الله تعالى وإيجاد مصادر أخرى لفهم الدين تتناسب مع رغباتهم وأمنياتهم. وقد شكَّلَ هذا الفريقُ ديناً جديداً موازياً لدين الله الحقِّ، ولمَّا كان هذا الدِّينُ الموازي مُفصَّلاً على مقاس الحُكَّام وأصحاب القرار فإنَّهم لم يُعطوا لأحدٍ من الرعيَّة الحقَّ في النَّقد والتصويب، وانتهى الأمر بقبول النَّاس للدِّين المُفترى_طواعيةً أو كرهاً_ طمعاً في التقرُّب من الحُكَّام أو تجنُّباً لقسوتهم أو خوفاً من الإقصاء، لينتهيَ الأمرُ بتوراث النَّاس هذا الدِّين المُفترى الذي يُنسبُ إلى الله زوراً.
بعد أن تشرَّفَ إبراهيمُ عليه السَّلام بمقام النُّبوَّة قال لقومه:
{وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ } (العنكبوت، 25)
فقد كان كثيرٌ من قوم إبراهيم يعلمون بُطلانَ عبادتهم للأوثان، لكنَّهم استمرُّوا على عبادتها مُحافَظَةً على علاقتهم بحُكَّامهم وقيادتهم الدِّينيَّة، وهذا شأنُ كُلِّ مَنْ رَفَضَ الإصغاءَ إلى داعي الإيمان في كلِّ زمانٍ ومكان، ولكن عندما تحين لحظةُ الحقيقة بين يدي الله تعالى يتنكَّر بعضُهم لبعضٍ ويتَّهمُ بعضُهم بعضاً أنَّه كان السَّببَ في ضلالتهم ويلعن بعضُهم بعضاً.
إنَّ الإعراضَ عن دين الله الحقِّ والتمسُّكَ بالدِّين الموازي هو الطريقُ السَّهل نحو تأليه الحُكَّام واعتبارِ أفعالهم مُقدَّسةً لا يجوز المساسُ بها أو انتقادُها. فالقولُ بأنَّ طاعةَ وليِّ الأمر هي طاعةٌ لله تعالى، وعصيانُه عصيانٌ لله تعالى هو ما يطمحُ إليه أربابُ الدِّين الموازي، وهم بذلك يُقدِّمون طاعةَ وليِّ الأمر على طاعة الله سبحانه، بل يزعمون أنَّه الوسيلةُ لطاعة الله، تعالى عمَّا يقول الظالمون عُلوَّاً كبيراً.
للمزيد حول الموضع ننصح بقراءة مقالة أ.د عبد العزيز بايندر المعنونة بـ (مقام الخليفة والكهنوت) على الرابط التالي:
http://www.hablullah.com/?p=2657
[1] انظر الآيات 83_89 من سورة الأنعام.
[2] المعروف، وهو ما عُرِفَ بالشَّرع أو العقل حسَّنه وكان موافقاً للفطرة وجرت عليه عادةُ كرام النَّاس. ومن البديهي أن لا تتعارضَ العادةُ الحسنةُ مع نصوص الكتاب والحكمة. ومن طبيعة العادات الحسنة أن تكون عالميَّة القبول.
[3] نقل ابن هبة الله عن الضحَّاك وسعيد بن جبير أنَّ سورة محمَّد قد نزلت في مكَّة. انظر تفسير القرطبي، طبعة القاهرة 1964، 14/223
[4] أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن العظامي، بيروت 1403 حديث رقم 9782
[5] محمد بن ادريس الشافعي، اختلاف الحديث (حاشية على كتاب الام للشافعي) بيروت 1410هـ ، 8/606
[6] ابو محمد الحسين الفرا البغوي الشافعي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، بيروت 1420هـ ، 2/310
[7] يقول عزّ وجلّ لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس: كلكم يعمل على شاكلته: على ناحيته وطريقته( فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ ) هو منكم( أَهْدَى سَبِيلا ) يقول: ربكم أعلم بمن هو منكم أهدى طريقا إلى الحقّ من غيره. (تفسير الطبري على الاية)
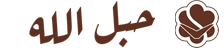


أضف تعليقا