كيف النجاة من ضعف التكوين المعرفي ؟
وكيف نُحْكِم أمرَ بِنَائِنَا المعرفي ؟
مقاربة معرفية أولية/ جنينية
يحيى رضا جاد
طبيب بشري وباحث وكاتب مصري
مستقل فكرياً وسياسياً
كثيراً ما تتردد هذه الأسئلةُ وأشباهُها (سواء من المهتمين بـ ، والخائضين في، الحقولِ المعرفيةِ المختلفةِ عامةً، أو الحقولِ المعرفيةِ الدينيةِ خاصةً، أو مِن الحريصين عامةً على تَكَوُّنٍ وتكوينٍ ثقافيٍّ فكري معرفي رصين) :
كيف النجاة من ضعف التكوين المعرفي (سواء بشكل عام أو في الحقل التخصصي المعين) ؟
وكيف نُحْكِم أمر بنائنا المعرفي؛ ليصير مُؤَسَّساً على أسس راسخة متينة ؟ .. إلخ.
وأرى أنَّ هذه “النَّجَاةَ”، وأنَّ هذا “التأسيسَ”، من الوِجهةِ الكلية الإجمالية العامة (لا الجزئية التفصيلية الخاصة)، يكون بأمور، من أهمها :
1- الأخلاقية والقيمية،
2- المقاصدية،
3- العربية،
4- الواقعية،
5- القرآنية،
6- الكتب التأسيسية/ الكتب المحورية/ كتب الفتوحات،
7- الانفتاحية والمُقَارَنية،
8- التوسعية،
9- الحافزية المعرفية/ الإشكالية المعرفية/ الهم المعرفي،
10- التدرجية،
11- التاريخية،
12- التراكمية.
وتفصيلاً لهذا الإجمال، نقول :
***
* أولاً :
التنشئة/ التربية “الأخلاقية والقيمية” (بالمعنى الواسع العميق الشامل لـ “الأخلاق” و”القيم”) في المنزل والأسرة؛ فهي لُبُّ الأمر كله (وفي الصميم من التربية الأخلاقية القيمية أن يَنشأ النَّشْءُ ومِن حولِهِم أمثلةٌ حيةٌ لهذه “الأخلاقية” و”القيمية”، تُمارَسُ أمامهم، فعلاً وواقعاً، قبل أن تكون كلاماً ومواعظ).
إذ بها يَخرُجُ المرءُ – على سبيل المثال- :
– عارفاً بأهمية “العلم والمعرفة”.
– وعارفاً بمحوريتهما في النهضة المنشودة.
– وعارفاً بكونهما من أهم أدوات “عمران النفس الإنسانية” و”عمران الواقع المادي”.
– وعارفاً بكونهما من أهم “القربات” إلى الله تعالى ومن أهم “العبادات” التي يُتَعَبَّدُ اللهُ سبحانه بها.
– وعارفاً بوجوب الإتقان فيهما، وبذل الجُهد المخلص في سبيلهما.
– وعارفاً بأهمية اتقاء/ تقوى الله فيهما؛ تلك التقوى التي تحفزه دوماً على طلب الكمال، وعلى الإتقان والتعمق والغوص، وعلى الحفر الدقيق من أجل البحث وإيجاد الحلول والاقتراب من الحق أو الصواب .. إلخ.
– ومُحَصَّناً ضد “الغرور المعرفي”، وضد “القنوط واليأس المعرفي”، معاً وفي ذات الوقت.
– ومحجوزاً عن أنْ يَتَقَحَّمَ الخوضَ في، أو الجوابَ عن، موضوعٍ لا يُحْسِنه أو لم يَسْبِر أغوارَه بعدُ.
***
* ثانياً :
التنشئة على “المقاصدية” :
إذ بها (والمقاصدُ : أرواحُ الأعمالِ وقِبْلَةُ العقلاء والعارفين) :
– يُحَدِّدُ المرءُ المقصودَ بـ ، وفي، ومِن، حركته في الحياة (وفي القلب منها حركته المعرفية والفكرية والثقافية)، ويُقَدِّرُ مدى جدوى هذا المقصود ومشروعيته، ومدى أولويته وملاءمته، ومدى فاعليته وثمرته وأثره، فكراً ونظراً، تحليلاً وتقويماً، استنتاجاً وتركيباً، وأيضاً : واقعاً وسلوكاً وفعلاً،
– ومن ثم، تَكُونُ تقديراتُهُ وقراراتُهُ وتحركاتُهُ (وخاصةً ما يتعلق منها بحركته المعرفية والفكرية والثقافية) :
- مُرَتَّبَةً، ومُمَنْهَجَةً، وعلى بصيرةٍ،
- ومن ثم، متميزةً – قدر الطاقة البشرية- بالشمول والتكامل والتناسق والمرونة،
- ومن ثم، مُبْتَعِدَةً عن المعالجات والمقاربات : التجزيئية التعضوية، واللفظية الشكلية، والجَدَلية العقيمة .. إلخ.
– وبها يُزيلُ المرءُ ما قد يصيبُه من كَلَلٍ أو مضلَلٍ أو ضَجَرٍ أو انقطاعٍ في مسيرة حَرَكَتِهِ المُقَصَّدَةِ في الحياة (وفي القلب منها حركته المعرفية والفكرية والثقافية)؛ إذْ مَن عَرَف ما قَصَدَ : هان عليه ما وَجَدَ؛ إذ التقصيدُ من المُحَفِّزات والمُنَشِّطات؛ لأنه يُصَيِّرُكَ عالِماً بما تقوم به : لِمَ تقومُ به ؟
– وبها يُسَدِّدُ ويُحْسِنُ المرءُ حَرَكته تلك – قولاً وفعلاً- ؛ إذ مَن لا يعرف مقاصدَ حَرَكته في الحياة (وفي القلب منها حركته المرفية والفكرية والثقافية كما ذكرنا) : يُوشِكُ أنْ يَزِلَّ فيها، أو أنْ ينحرفَ بها أو عنها.
***
* ثالثاً :
التنشئة على “العربية”؛ أي على الاعتناء بلسان العرب/ بلغتنا العربية؛ حتى يَخرُجَ المرءُ مُقِيماً لِسانَه بها، يُحسن التحدث بها والتعبيرَ عن نفسه من خلالها، ويُحسن قراءة النتاج (القديم والمعاصر) المكتوب بها، ويألَفُ إياه .. إلخ.
إذ بهذا يَخرُجُ المرءُ :
– صاحبَ لسانٍ، وصاحبَ شخصية، وصاحبَ هوية، وصاحبَ إطارٍ،
– وبهذا يستطيع أنْ يكونَ له “كيانٌ” قائمٌ بذاته، كيانٌ غيرُ إِمَّعِيٍّ، كيانٌ ذو جذورٍ لها طَلْعٌ نضيد وأزهارٌ مورِقة .. إلخ.
***
* رابعاً :
التنشئة على “الواقعية”؛ أي :
– على الاعتناء بـ “الواقع” و”فقه/ فهم الواقع” المحيط بنا، والذي نحيا فيه، ونتنفس من خلاله، ونحتك به، ونأمل في تغييره إلى الأفضل.
– وعلى الاعتناء بـ “النتاج المعرفي المعاصر”؛ اتصالاً به، وقراءةً له، واستفادةً منه، وبناءً عليه، وجدلاً معه .. إذ نحنُ أبناءُ عصرنا هذا (القرن الحادي والعشرين الميلادي، والقرن الخامس عشر الهجري)، لا عصر الأمويين ولا عصر العباسيين ولا عصر المماليك ولا عصر العثمانيين !
إذ بهذا كله يَخرُجُ المرءُ :
– مُلماً بأركانِ ومهماتِ أمورِ مجتمعه،
– عارفاً بشواغله، ومدركاً لهمومه ومشاغله،
– ومُحَصِّلاً – قدر الطاقة- للسقف المعرفي المحيط به (سواء السقف المعرفي العام، أو السقف الخاص بتخصصه المعين).
مما به – بهذا كله- :
– يستطيع أنْ يكتسبَ، وتتكون لديه، “حساسية خاصة” يَسبر بها غور هذا الواقع؛ ليضعَ اليد على أهم “إيجابياته” و”سلبياته”، أهم “إنجازاته” و”إخفاقاته”، أهم “مميزاته” و”عيوبه ونَوَاقِصه”؛ مِن أجلِ “تشخيصٍ” دقيقٍ لهذا الواقع، به يستطيع أن يساهمَ في وضعِ “علاجٍ مناسبٍ/ ملائمٍ وفعالٍ له” .. إلخ.
– ومما به يستطيعُ أنْ يضعَ اليدَ :
- على أهم مميزات وميزات السقف المعرفي المحيط به (بما به يمكن أن يؤكد عليها وينميها ويعززها ويزيدها كفاءةً وإبداعاً .. إلخ)،
- وعلى أهم ثغراته الواجبِ أن تتم معالجتها (بما به يهتم بها، ويحاول علاجها أو تجاوُزَها وإيجادَ بدائل معرفية لها .. إلخ).
وبهذا كله، يصيرُ المرءُ “فاعلاً” في مجتمعه، ويصيرُ الكاتبُ/ الباحثُ/ العالِم/ المفكر/ الفيلسوف “عضواً حَيَّاً وحيوياً” فيه.
***
* خامساً :
التنشئة على “القرآنية”؛ أي على الاتصال بالقرآن، والوصل بالقرآن، بل الانطراح الدائم على أعتابه، والطَّرْقِ المستمر لأبوابه :
– ليس عبر “الترديد البَبَّغَائِي” لآياته وسوره (فما أكثر الحُفاظ !، ولن يعدو الأمرُ حينئذ أن تكون نُسَخُ القرآن الكريم قد زادت نُسخةً أخرى !)،
– بل عبر “الجلوس الدائم” في رحابه؛ لاستنطاقه ومساءلته ومحاورته، في ما يَعِنُّ للمرءِ من أمورٍ (فلسفيةِ، أو فكريةٍ، أو لغوية، أو فقهية، أو كلامية، أو حياتية معيشية واقعية، تمس صميمَ كيانِ الإنسان .. إلخ) يُريد لها جواباً.
وبهذا يَخرُجُ المرءُ – في تفاعله مع ما يحيط به من أفكار ومفاهيم واجتهادات وآراء- :
– متشبعاً – حقاً وصدقاً- بالقرآن.
– وحاملاً لترسانةٍ معرفيةٍ ومفاهيميةٍ وفكريةٍ ونفسيةٍ :
- تؤهله للخوض، بقوةٍ وعلى هُدَىً وبصيرةٍ، في لُجة الإبداع والاجتهاد والتجديد والإصلاح الحق،
- وتؤهله للخوض، بقوةٍ وعلى هُدَىً وبصيرةٍ، في بحار التصديق والهيمنة القرآنِيَّيْن على التراث (القديم منه والحديث)،
- وتؤهله : لمجابهة أعتى الأمواج، وللتصدي لأعتى الهجمات.
***
* سادساً :
التنشئة على “الكتب التأسيسية/ الكتب المحورية/ الكتب الفتوحات” (سواءٌ كانت “تراثية” أو “حديثة” أو “معاصرة”؛ فليس “التأسيس/ المحورية/ الفَتْح” قاصراً على السابقين والأموات فقط !).
أي التنشئة على “الاتصال المباشر” بأهم “الكتب التأسيسية/ المحورية/ الفَتْحِية” في مختلف الميادين والحقول المعرفية (سواء العامة، أو الخاصة محل التخصص المعين)، بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع بعض – أو حتى كل- مضامين هذه الكتب التأسيسية.
إذ من أهم مشاكلنا الفكرية – في الحقل المعرفي الديني خاصةً- شيوعُ الاتصال المباشر بـ “كتبِ عصور/ مناخات/ بيئات التراجع والانحطاط والجمود الفكري”، فـ :
أين – مثلاً- يتم تدريسُ طلابِ الشريعة أو الفقه أو الأصول أو اللغة كتباً مثل : المغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، والاستذكار لابن عبد البر، وفقه الزكاة للقرضاوي (.. إلخ) .. أو موطأ مالك، وصحيح البخاري (.. إلخ) .. أو الرسالة للشافعي، ومستصفى الغزالي، وموافقات الشاطبي، والأدلة الاجتهادية المختلف فيها لصلاح سلطان (.. إلخ) .. أو إحياء علوم الدين للغزالي، ومجموع الفتاوى لابن تيمية، ومجلة المنار لرشيد رضا (.. إلخ) .. أو فصل المقال لابن رشد، مقدمة ابن خلدون، معالم المنهج الإسلامي لعمارة (.. إلخ) .. أو الرسالة القشيرية للقشيري، والإيمان والحياة للقرضاوي، وكيمياء الصلاة لأحمد خيري العُمَري (.. إلخ) .. أو دراسات في فقه العربية لصبحي الصالح، واللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان (.. إلخ) .. أو البيان والتَّبَيُّن/ التبيين للجاحظ، والعقد الفريد لابن عبد ربه، والمُسْتَطْرَف في كل فن مُسْتَظْرَف للأبشيهي (.. إلخ) ؟! .. في حين أن ما يتم تدريسه للطلاب مِن كتب : يدور حاله، وحال مُدَرِّسيه، في الأغلب، بين المتَرَدِّيَة والنَّطِيحة وما أكل السبع !
وأين – مثلاً- يتم تدريسُ طلابِ الفلسفةِ النتاجَ الفكري المباشر : لأفلاطون وأرسطو .. وتوما الأكويني .. وديكارت .. وكانط .. وفتجنشتاين .. وكارل بوبر .. وهابرماس .. وطه عبد الرحمن .. وأبو يعرب المرزوقي .. وناصيف نصار .. والمسيري .. إلخ .. إلخ ؟! .. في حين أن ما يتم تدريسه للطلاب : يكون، ومَن يُدَرِّسُهُ، في الأغلب، أقرب إلى ما ذَكَرنا قبل قليل.
إذ بهذا (أي بالتنشئة على “الكتب التأسيسية/ المحورية/ الفَتْحِية”) يَخرُجُ المرءُ :
– ملماً بـ “الأسس” و”المرتكزات” و”المفاصل المعرفية” الكبرى التي تأسس عليها “التراث” و”الواقع” الفكرِيَّيْن المحيطَيْن به.
– وبهذا – كذلك- “يتصل بكبار العقول العبقرية” من خلال أنضج ثمراتها.
– كما “يتصل ببعض أهم وألمع وأبدع الأساليب التعبيرية” التي كُتبت بها هذه الكتب؛ فيرتقِيَ بهذا لسانُه، ويُصْقِلَ هو تعبيرَه.
– وبهذا – كذلك- يستطيعُ وضعَ اليد :
- على “أهم ما في هذه الكتب من إيجابيات وإبداعات”، يمكنه أن يستثمرها و/ أو يكملها ويبني عليها،
- وعلى “أهم ما فيها من نواقص أو ثغرات أو عثرات” (قد تكون أسهمت في خلق بعض المآزق المعرفية، في التراث أو في واقعنا المعاصر) يمكنه أن ينتقدها ويفندها ويتجاوزها، آتياً ببدائل أكثر نَجاعةً وإقناعاً وموثوقيةً وإبداعاً واستقامةً منها.
***
* سابعاً :
التنشئة على “الانفتاحية” و”المُقَارَنية”؛ أي :
– على “الانفتاح” (في القراءة والبحث والاطلاع، وفي الحياة والواقع والاحتكاك الاجتماعي) على “مختلف التوجهات والتجارب” الفكرية والواقعية البشرية، بإطلاقٍ وتعميم، قَدْرَ الطاقة البشرية.
– وعلى “المقارنة” (في القراءة والبحث والاطلاع، وفي الحياة والواقع والاحتكاك الاجتماعي) بين “مختلف الآراء والتوجهات والوجهات والتجارب” البشرية، بإطلاقٍ وتعميم، قَدْرَ الطاقة البشرية.
إذا بهذا (في القراءة والبحث والاطلاع، وفي الحياة والواقع والاحتكاك الاجتماعي) يَخرُجُ المرءُ :
– مُدركاً لـ “سننية الاختلاف”، وأنه “سنة كونية” أزلية ودائمة.
– ومدركاً لأبعادِ مختلف ما يشغله من قضايا – فكرة أو واقعية-.
– ومدركاً لأهم ما يعتورها من تيارات واتجاهات وتوجهات.
– متسعاً بذلك صَدْرُهُ، متفتحاً عَقْلُهُ، حساساً تفقُّهُهُ وتدبُّرُه،
– ومستفيداً – بذكائه وتوليفه الخاص- مما عند كل واحدٍ مِن هذه التوجهات والوِجْهات مِن خيرٍ (بإعمال مِبْضَعَيْ “الاستيعاب النقدي” و”الانتقاء التكاملي”) .. إلخ.
***
* ثامناً :
التنشئة على “التوسعية” :
– ولا نقصد بها أن يتحول المرءُ إلى “دائرةِ معارفَ متحركةٍ”،
– وإنما أنْ “يُطِلَّ المرءُ، قدر طاقته، على حقولٍ وميادينَ معرفية جديدة لم يَطَأْها فِكْرُهُ ولا اهتمامُهُ مِن قبلُ” (أدبيةً كانت أو فنيةً أو رياضية أو تاريخية أو اجتماعية أو سياسية أو قانونية أو دينية أو فلسفية أو نفسية أو تِقَنية أو فلكية أو فيزيائية أو كيميائية أو طبيةً أو هندسيةً .. إلخ).
إذ بهذه “التوسعية” :
– يكتسبُ المرءُ تعميقاً لأغوار نَفْسِهِ وعقله وشخصيته،
– ويكتسبُ تعميقاً لأبعاد ما يشتغل عليه من موضوعات/ قضايا، مما يَكْتَسِبُ به حَاسَّةَ وميزة “التكاملية” في المقاربة والمعالجة،
– وتتكشفُ أمامَه مساحات جديدة لِمَا يسمونه بـ “الحقول المعرفية البَيْنِيَّة”، تلك التي : تقف على الأعرافِ (أعرافِ التخصصاتِ بعضِها وبعضٍ)، وتَشْتَرِكُ وتشتبكُ مع أكثر من تخصص، مما يتعمق به اكتسابُهُ لِحَاسَّةِ وميزة “التكاملية” سابقة الذكر،
– وتَنْفَتِحُ أَمَامَه آفاقٌ جديدةٌ.
ومن ثم، وبناءً على هذا كله : تَتَخَلَقُ أمامَه مُمْكِناتٌ جديدةٌ.
***
* تاسعاً :
وجود “الحافزية المعرفية/ الإشكالية المعرفية/ الهم المعرفي” :
أي وجودُ أمرٍ يُؤَرِّقُ المرءَ، دافعاً إياه للبحثِ عن جوابٍ/ مَخْرَجٍ/ أفقٍ جديدٍ يتجاوز به هذا “التأرق”؛ فهذا الوجود لهذا “التأريق” هو “الباب الأكبر” و”المُحَفِّز الكيميائي الأكفأ” على التفكير والبحث والحفر، وعلى الإبداع وانقداح شرارة الاجتهاد والتجديد؛
إذ بهذا يصبح المرءُ واقفاً على أطراف أصابعه، متحفزاً، يقظاً، منتبهاً، يستولي على كيانه أمرٌ يبحث له عن علاجٍ/ مَخْرَجٍ/ أفقٍ جديد يُحرره مِن تَأَرُّقِهِ هذا وأزمته تلك (.. إلخ)، إذ :
– في رحاب هذا “التأرق/ الهم” : يُولَد “السؤال”،
– وبه : يُولَدُ الإبداعُ والاجتهاد والتجديد والإصلاح :
- مُحَاوَلَةً للجواب عن هذا “السؤال”،
- ومحاولةً لاكتساب “الطمأنينة المعرفية” التي تُعالِجُ هذا “الأَرَق/ التوتر/ الهم” أو تُجاوِزُهُ.
***
* عاشراً :
التنشئة على “التدرجية”؛ أي على “التدرج في ارتقاء سلم المعارف” :
– من المُخْتَصَرات المُعتَصَرات، إلى المتوسطات، إلى المَبْسُوطات المُطَوَّلات،
– ومن المداخل المُخْتَصَرة، إلى المداخل المتوسطة، إلى المداخل والتناولات النقدية.
إذ بهذه “التدرجية” يَكتسبُ المرءُ، خطوةً خطوةً، “التعمقَ المطلوبَ” و”الحساسيةَ المعرفية” في الميدان المُسْتَهْدَف خاصةً، أو في الميدان الثقافي والمعرفي عامةً.
***
* حادي عشر :
التنشئة على “التاريخية”؛ أي على سبر أغوار “المسار التاريخي” الذي سار فيه الفن/ العلم/ الميدان المراد دراسته.
إذ بهذه “التاريخية” :
– يتلمس معالمَ الطريق الذي سارَ فيه هذا الفنُّ،
– ويضع اليد على أهم تطوراته ومنعطفاته ومعارجه،
– كما يضع اليد على مناخ ولحظات ميلاد إشكالياته وتوتراته.
وهذا كله يؤهله للقيام بـ “رؤية نقدية” لمجمل هذا الفن بمداخله ومخارجه وممراته.
والرؤية النقدية المقصودَةُ هنا :
– تشمل رصد الإيجابيات لتعظيمها واستثمارها والبناء عليها،
– كما تشمل رصد السلبيات لعلاجها و/ أو لاستئصالها وإبداع بدائل/ مخارج/ آفاق جديدة، كلياً أو جزئياً؛
مما يُعَبِّدُ الطريقَ – في الحالين- للإبداع والاجتهاد والتجديد والإصلاح الحق.
***
* ثاني عشر :
“التراكمية”؛ أي “التعمقُ” و”الغوصُ بعيداً” في دراسة الحقل المعين المراد التضلع/ الإبداع/ الاجتهاد والتجديد/ الإصلاح فيه.
إذ بهذه “التراكمية/ التعمق” :
– يزداد الوعي بمختلف أنحاء هذا الحقل،
– ويزداد التمكن من مسائله ومداخله ومخارجه،
– ويزداد احتمال تفتح آفاق جديدة فيه.
هذا ما حضرني هذه الساعة،
فأكتفي بهذا القدر،
وهو سبحانه أعلى وأعلم
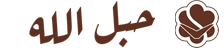


أضف تعليقا