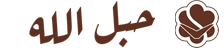الباحث د. عبد الله القيسي
*ملاحظة: المعلومات الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
يقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ﴾ [آل عمران:7].
استقر لدى الأذهان أنَّ المقصودَ بالآيات المُحكَمات في هذه الآية هي تلك الآيات التي لا تتعدد دلالتها فهي محُكَمَة على معنى واحد، وأنّ الآياتِ المتشابهاتِ هي التي تتعدد دلالتها فيمكن فهمها على أكثر من وجه، فتكون الأولى مجالاً للاتفاق والثانية مساحة للاختلاف المقبول، كون الخالق أرادها كذلك لتكونَ في المساحة المرنة من التشريع.
ومع أن هذا المعنى قد يكون موجودًا في الآيات إلا أن لفظتي المُحكَمات والمتشابهات في الآية حين تأملها وربطها بآيات أخرى يوصلنا لمفهوم آخر هو الأقرب -برأيي- لمقصود الآية، يأتي هذا المعنى إذا حررنا المقصودَ من قوله: (تأويله) باعتبار ذلك مفتاح فهم بقية الآية، فما المقصود بالتأويل في الآية؟
يذكرُ أهلُ اللغة ثلاثة معانٍ للتأويل، وحين نقف قليلاً عند تلك المعاني نجدْ أنها أخذت ثلاث مراحل، ففي المرحلة الأولى (أي وقت نزول) النص كان التأويل بمعنى: الموجودُ الذي يؤول إليه الكلامُ، أي ظهورُ المُتكلمِ به إلى الواقعِ المحسوسِ. ثم جاءت مرحلة ثانية وبدأوا يطلقون لفظ التأويل على: بيان مرادِ المتكلِّمِ، وهذا هو التَّفسيرُ. ثم جاء معنى آخر متأخر فأطلقوا التأويل كذلك على: صرف اللَّفظِ عن ظاهرِه إلى معنى مرجوحٍ لقرينةٍ تدلُّ عليه.
والمستعرض لآيات القرآن يجد أن لفظ التأويل جاء بالمعنى الأول الأساسي في كل الآيات التي ذكرت التأويل. فالتأويل هو: الموجودُ الذي يؤول إليه الكلامُ، أي ظهورُ المُتكلمِ به إلى الواقعِ المحسوسِ. فإن كانَ خبرًا، كان تأويلُه وقوعُ المُخبَرِ به، كمن يقولُ: جاء محمَّدٌ، فتأويلُ هذا الكلامِ مجيءُ محمَّدٍ بنفسِه. وإذا كانَ طلبًا (أي: أمرًا أو نهيًا)، كان تأويلُه أن يفعلَ هذا الطلبُ.
فالتأويل في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف:53] ، يعني يوم يأتي ما يؤول إليه الأمر من الحساب والثواب والعقاب يوم القيامة كما جاء في التفسير الميسر[1]. ومثله قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه﴾ [يونس:39]، أي ولم يأتهم بعدُ حقيقة ما وُعِدوا به في الكتاب من الثوابِ والعقابِ، كما في التفسير الميسر.
وما جاء في سورة يوسف في ستة مواضع ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيث﴾، أي: ويعلمك تأويل الرّؤيا أي: بما تؤول إليه في الوجود. وهكذا حين نتتبع لفظ التأويل في كل الآيات.
وما وردَ كذلك في سورةِ الكهفِ في قصَّةِ العبد الصالح وموسى عليهما السَّلامُ، وهما قوله تعالى: ﴿َأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٨]، والمعنى: سأخبرك بعاقبة هذه الأفعال التي صدرت مني [2].
وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف:82]، ذلك بيان ما تؤول إليه الأفعال التي ضقت بها ذرعًا، ولم تصبر حتى أخبرك بها ابتداءً[3].
وقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59] ، وقوله تعالى: ﴿وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [الإسراء:35]. أي أحسن عاقبةً ومآلاً[4].
يؤيد ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبحمدك، اللهمَّ اغفر لي، يتأوَّلُ القرآن. أي يطبق ويعمل ما أمر به، وتقصد قوله تعالى ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر:3]. وهناك الكثير من الروايات التي تؤيد ذلك[5].
ورُوي عن الثَّوري: أنه بلغه أنَّ أمَّ ولدِ الرَّبيعِ بن خُثَيم قالت: كان إذ جاءه السَّائل، يقول لي: يا فلانة، أعطي السَّائل سُكَّرًا، فإن الرَّبيعَ يُحِبُّ السُّكَّرَ. قال سفيان: يتأوَّل قوله عزَّ وجل: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّون﴾ [آل عمران:92][6].
قال الطبري: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة ﴿جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الأَحْزَابِ﴾ [ص:11]، قال: (وعده الله وهو بمكة يومئذٍ أنه سيهزم جندًا من المشركين، فجاء تأويلها يوم بدر)[7].
فإذا اتفقنا على هذا المعنى للتأويل، فما هو المتشابه الذي يقصده من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟
وحين نستعرضُ حالةَ دعوة نبينا مع قومه كما استعرضها القرآنَ نجد أنه كان في حالة سجال مستمر، يدعوهم إلى الله وينذرهم اليومَ الآخر ولكنهم كانوا يكذبونه ويطالبونه بتأويل اليوم الآخر والبعث والقيامة وكل ما هو غيبي، أي يطلبون مجيئه وتحققه في الواقع كي يفتنوا الناسَ عنه ويتهموه بالكذب. فكان القرآنُ يرد عليهم بشأن اليوم الآخر بقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف:53]، فتلك الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر والقيامة والغيب هي الآيات المتشابهات التي كان يطعن فيها المشركون الذين في قلوبهم زيغ بقصد تشكيك من آمن بالنبي، ولا يلجأون للآيات التي تدعو للرحمة والصدق ومكارم الأخلاق وحسن العمل، لأن هذه الآيات يدرك العقلُ مدى حسنها ومدى حسن الدعوة إليها، وهذه هي الآيات المحكمات التي يستطيع العقلُ وحدُه أنْ يعرفَ حسنَها، أما الآيات التي تتحدث عن الغيب فلا مجال للعقل في الحكم عليها إلا الإيمان بعد أن يؤمن بالنبي إجمالاً.
وسيكون معنى الآية باختصار: أي هو الذي أنزل عليك الكتابَ فيه آيات محكمات، بعيدة عن الاشتباه، وآيات متشابهات وهو ما استأثر الله بعلم تحققه من أحوال الآخرة وغيرها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيقصدون المتشابه كي ينفّروا الناسَ عن النبي ويطلبوا تحقق ما أبلغهم عن الغيب على الواقع، لعلمهم أنَّ غرائزَ الناس وطبائعَهم تميل إلى إنكار ما لم يصل إليه علمُهم ولا يناله حسُهم كالإحياء بعد الموت وجميع شئون العالم الأخروي.
قوله تعالى: ﴿وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ * وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا﴾. والراجح كما يتبين من سياق الآية هو الوقوف على لفظ الجلالة، وجعل قوله: والراسخون في العلم كلام مُستأنَف؛ لأننا لو وقفنا على ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ فإننا سنبتر الجملةَ التي تليها، وعلى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. كما أن ذم الله سبحانه للتأويل يرجح ذلك، وكذا قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا﴾ ظاهر في التسليم المحض لله تعالى، ومَن عرف الشيءَ وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم المحض. والقولُ بالوقوف على لفظ الجلالة وجعل ما بعده مُستأنفًا هو رأى كثير من الصحابة كأبي بن كعب وعائشة وكثير من السلف[8].
ووجود المتشابه الذي يستأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة ضروري؛ لأن من مقاصد الدين الإخبار بأحوالها، فيجب الإيمان بما جاء به الرسولُ من ذلك، وهو من عالم الغيب نؤمن به كما نؤمن بالملائكة والجن، ولا يعلم تأويل ذلك: أي حقيقة ما تؤول إليه هذه الألفاظ إلا الله. أما الراسخون في العلم فيعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا لعقلهم فيه، إنما سبيله التسليم، فيقولون آمنا به كل من عند ربنا.
يقول الأزهري: وأما قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يأتي تَأْوِيلُهُ﴾ قال أبو إسحاق: معناه هل ينظرون إلاّ ما يَؤول إليه أمرهم مِن البَعث، قيل وهذا التَّأويل هو قوله جلّ وعزّ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ﴾ [آل عمران:7]، أي لا يعلم متى يكون أمر البعث وما يؤول إليه الأمر عند قيام الساعة إلا الله ﴿وَالرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران:7]، أي آمنّا بالبَعث. والله أعلم قلت (أي الأزهري) وهذا الذي قاله حَسن[9].
قوله تعالى: ﴿وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ﴾، أي وما يعقل ذلك ويفقه حكمته إلا ذوو البصائر المستنيرة، والعقول الراجحة التي امتازت بالتدبر والتفكر في جميع الآيات المحكمة التي هي الأصول، حتى إذا عرض المتشابه الذي هو نبأ عالم الغيب قالوا آمنا وصدقنا واطمأنت نفوسنا بذلك.
ثم ذكر ما يدعون به ليهبهم الثبات على إيمانهم ذلك فقال: ﴿رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾، أي إن أولئك الراسخين في العلم مع إيمانهم بالمتشابه يطلبون إلى الله أن يحفظَهم من الزيغ بعد الهداية. ﴿رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ﴾، أي ربنا إنك تجمع الناس للجزاء في يوم لا شك فيه وإنا موقنون به، لأنك أخبرت به وقولك الحق، ووعدت وأوعدت بالجزاء فيه، وأنت لا تخلف وعدك. وقد جاءوا بهذا الدعاء بعد الإيمان بالمتشابه، ليستشعروا الخوف من تسرّب الزيغ الذي يسلبهم الرحمةَ في ذلك اليوم، وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوقّي منه.
والخلاصة أن:
التأويل في الآية هو: ما تؤول إليه حقيقة الشيء، أي ظهورُ المُتكلمِ به إلى الواقعِ المحسوسِ.
والمُحكمات: هي الآيات التي تتكلم عن عالم الشهادة (أصول الأخلاق والفضائل وأصول الشرائع وغيرها وهي ما يمكن أن تؤول حقيقة في الواقع، ويستطيع العقل أن يقبلَها بعد فحصها لما فيها من مصلحة ظاهرة بينة فهي مما يتفق عليه العقل البشري)، ولذا سُمِّيت مُحكَمَة؛ لأن العقل يدرك إحكامَها أي مدى مصلحتها من مفسدتها.
والمتشابهات: هي الآيات التي تتكلم عن عالم الغيب ولا يكون تأويلُها وتحققها إلا في الآخرة، ولا يستطيع العقلُ إدراكَها وإنما يكتفي فقط فيها بالإيمان، كالإيمان بالله واليوم الآخر. ولذا سميت متشابهة؛ لأن المطلوب فيها الإيمان.
والراسخون في العلم يدركون إحكام المُحكَم بعقولهم، ويدركه مثلُهم صاحبُ كل عقل، ولكنهم في المتشابه الذي لا تستطيع عقولهُم إدراكَه يكتفون بالإيمان. أما غير الراسخين في العلم فيريدون أن يدركوا المتشابه متحققًا في الواقع بعقولهم، وهذا بعيد، ولو أنهم وصلوا إلى الرسوخ في العلم لعرفوا أين ينتهي دور العقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التفسير الميسر لمجموعة من المؤلفين.
[6] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج4ص133.
[9] انظر تهذيب اللغة ج15/ص329، ومثله قال ابن منظور في لسان العرب ج11/ص34.