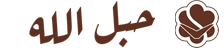الباحث: د. عبدالله القيسي
جاء ذكر الزكاة في اثنين وثلاثين موضعا في القرآن الكريم، اقترنت فيها مع الصلاة في سبع وعشرين موضعا، “أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة”. والزكاة هي إحدى الشعائر التعبدية الأربع في الإسلام (الصلاة والزكاة والصوم والحج) وارتباطها بالصلاة بشكل شبه دائم في الآيات يدل على أهميتها أولا وتشابهها مع الصلاة في كونها عبادة مستمرة طوال العام ثانيا، فهما عبادتان مستمرتان، وليسا كالصيام عبادة سنوية، ولا كالحج عبادة عمرية، ولذا لم يقترنا معهما، ولم يتكرر الحديث عنهما كما الصلاة والزكاة.
ولما ضاق مفهوم الزكاة وخرج منه الفقراء وصار عبادة سنوية ارتبطت برمضان فقط كان لا بد من إعادة مفهوم الزكاة بصورته الأشمل في القرآن كعبادة مستمرة طوال العام.
إذا كانت الصلاة هي العبادة اللازمة المستمرة التي تربط وتصل الإنسان بربه، فإن الزكاة هي العبادة المتعدية المستمرة التي تربط الإنسان بمجتمعه والناس من حوله، فيكون المسلم متنقلا طوال عمره بين عبادة لازمة هي حق الله الخالص، وعبادة متعدية هي حق الناس وحق الله أيضا، فلا ينسى حق الله ولا ينسى حق الناس.
والسؤال المنسي في قضية الزكاة هو: هل يمكن أن يكون ذلك الخطاب المتكرر للزكاة واقترانها بالصلاة خاصا بإنفاق المال فقط وفي فترة واحدة طوال العام؟
إن كان كذلك فكيف سيزكي الفقراء والمساكين الذين لا يمتلكون مالا؟ وهل سيبقون طوال عمرهم دون أن يؤتوا الزكاة؟ ودون أن يكونوا للزكاة فاعلين؟ وهل ستكون عبادة مهمة كالزكاة مخصوصة بالأغنياء فقط؟ وكيف ستكون الزكاة كالصلاة شعيرة وركنا واجبا على كل مؤمن؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه.
إن المتأمل في الآيات التي أمرت بإيتاء الزكاة سيجد أنها أشمل وأعم من تلك الآيات التي حثت على الإنفاق، إذ التوجيه في الزكاة خطاب لكل مسلم فقيرا كان أم غنيا، أما خطاب الإنفاق فإنه خاص بمن لديه المال فقط، وهذا يدل على أن الإنفاق هو أحد أنواع الزكاة لا كلها، إذ الزكاة هي تزكية النفس، والتزكية تتحقق حين تقدم تلك النفس عطاء للآخرين بلا مقابل مادي وإنما ابتغاء وجه الله فقط، والنفس تعطي مما أعطاها الله، وعطاء الله من النعم والمواهب متنوع ومتعدد، وكل إنسان لا يخلو من نعمة أو موهبة أو خبرة يستطيع بها خدمة أو مساعدة من حوله، وبهذا تكون الزكاة من جنس ما أنعم الله به على الإنسان وأعطاه من مواهب أو ما اكتسب من خبرات في الحياة، فيعطي الآخرين تطوعا منه بلا مقابل كي يزكي نفسه، فبالعطاء تزداد الرحمة بداخله ويمنح الحب لمن حوله، والحب والرحمة هما خلاصة الإنسانية، فإن حرص على العطاء زادت إنسانيته واستمرت، وإن لم يحرص فإنها تتناقص ويفقدها مع السنين.
وبهذا المفهوم الشامل للزكاة فإن العامل البسيط يمكن أن يزكي بعمله لمساعدة الآخرين المحتاجين في فترات ما طوال العام، والفنّي يمكن أن يصلح للفقراء ما احتاجوه في فترات ما طوال العام، وصاحب السيارة يحمل الناس عليها ممن يحتاجون لذلك، والتاجر يعطي مما أعطاه الله من مال، وهكذا المحامي والمهندس والطبيب …الخ، فيكون المجتمع كله مزكيا عن نفسه في كل المجالات، ومغطيا كل الاحتياجات، ولا يوجد مجال إلا ونستطيع أن نخدم المجتمع فيه أو نخدم الفقراء والمساكين وذوي الاحتياج، وأعمال التطوع كثيرة جدا، ولربما لأن المال صار بإمكانه سد كل حاجة عند الناس اشتهر وصار بديلا لكل فعل تطوعي، إلا أن ذلك -برأيي- لا يكفي، فالإنسان الذي يخدم مجتمعه في حرفته يجد ذلك بسيطا عليه ويستطيع الاستمرار عليه طوال العام.. وكل هؤلاء يتحقق فيهم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ وهذه الآية تشير إلى أن الزكاة فعل أيضاً.
إن هذا يعني ببساطة أن كل فرد عليه أن يقوم بعمل تطوعي أو يشترك في عمل تطوعي من جنس ما يعمله كي يزكي نفسه، وبهذا تكون الزكاة كالصلاة عبادة مستمرة متكررة من الفرد طوال العام وليست مخصوصة بيوم واحد في العام كما انتشر بين الناس حين حصروها في الإنفاق فقط. إذ الإنفاق خاص بمن لديه المال الذي يزيد عن حاجته فينفق منه.
ولعل ذلك الفهم القاصر في حصر الزكاة في إنفاق المال قد جاء عبر دول حكمت -في تاريخنا- وركزت فقط على المال كونه سيجمع إلى أيدي حكامها مباشرة فيحقق ما يبقيهم على رأس السلطة، مغفلين بذلك تزكية النفس في مجالات أخرى.
بالتأمل في آيات القرآن التي حثت على الإنفاق نجد أن الحث عليه كان كثيرا وهذا يعني أنه العنصر الأول في تحقيق مقاصد الزكاة ذلك أنه بجمعه إلى سلطة واحدة -هي سلطة ولي الأمر الذي اختاره الناس والذي يدير أمرهم بالشورى لا بالاستبداد- ليتوزع بشكل منظم ومرتب على احتياجات المجتمع ومحتاجيه، فيكون التوزيع عادلا وشاملا يعطي كل ذي حق حقه، ويحقق مجتمعا متوازنا لا يكون المال فيه دولة بين الأغنياء فقط، بعكس ما لو كان توزيعها عائدا إلى اجتهاد كل فرد بنفسه فيوزع الكثير في مكان والقليل في مكان آخر وربما تكون هناك أماكن محتاجة لم يصلها شيء.
إلا أن استبداد الحكام والذي اقترن بفسادهم في كثير من البلاد طوال العقود الماضية جعل التجار في خوف من دفع تلك الأموال إليهم خوفا من عدم تقسيمها لمستحقيها ونهبها فلا تحقق غايتها ومقصدها في المجتمع ويكون غير متحقق في تزكية نفسه، لذا صار بعضهم أو أكثرهم يوزعها بطريقته الخاصة، وهذا لا يحقق مقصودها تماما كما ذكرت سابقا وإنما سيحقق بعض مقصودها أو أكثره، من باب جلب أكبر المصلحتين أو درء أكبر المفسدتين.
أما السؤال حول ماذا ينفقون؟ فقد أجابت عليه الآية في قوله تعالى:
﴿وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو كذلك يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾[البقرة: 219].
فبعد أن جاءت الآيات بالحث على الإنفاق والترغيب فيه، لسد حاجات الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الإنفاق، جاء السؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فكانت الإجابة “العفو” أي أنفقوا العفو.
وأصل العفو في اللغة الزيادة، يقول ابن عاشور: العفو مصدر عَفَا يعفو إذا زاد ونَمَا قال تعالى: ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا﴾[الأعراف: 95]، وهو هنا ما زاد على حاجة المرء من المال أي فَضلَ بعد نفقته ونفقة عياله بمعتاد أمثاله. فالإنفاق يكون من العفو بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار.
فالآية هنا تحدد المقدار في الإنفاق بما زاد عن حاجة الإنسان، في قصد واعتدال، بلا سرف ولا تقتير، وحيث كفى الإنسان حاجته فإن واجبا عليه أن يسمح بما زاد عن هذه الحاجة، فيدفع به حاجة المحتاجين.. إذ كيف يكون الإنسان إنسانا بارّا بإنسانيته، وفى يده فضل مال أو متاع، وفى الناس من أهله وجيرانه، وقومه، من هو في حاجة إلى بعض هذا المال أو المتاع.
إن ذلك التوزيع للمال يدلنا على فلسفة الإسلام في المال حيث أن المال هو مال الله الذي وهبه للإنسان، ومال الله هنا تعني مال المجتمع كله، يستفيد منه كل خلق الله ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ولكن لما اجتهد وكد بعضهم في تحصيله كان لهم بعض التملك له، على أن يبقى جزء منه في غير ملكهم، يعود للأرض والإنسان التي كونوا بهما ثروتهم، فلم يكن جهدهم فقط هو من كون ذلك المال وتلك الثروة.
إنفاق العفو:
يختلف ركن الزكاة عن بقية أركان الشعائر التعبدية الأخرى، بأن علاقته ليست خالصة بين العبد وربه كما بقية الشعائر، وإنما تتعدى علاقته أيضا إلى العباد، فهو من حقوق الله وحقوق العباد أيضاً، والإنفاق من المال جزء من الزكاة بمفهومها الشامل الذي عرضناه من قبل، وقد جاء التوجيه القرآني ليضع الخط العام في تقدير المال المنفق، فقالت الآية: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو كذلك يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 219]. فبعد أن جاءت الآيات بالحث على الإنفاق والترغيب فيه، لسد حاجات الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الإنفاق، جاء السؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فكانت الإجابة “العفو” أي أنفقوا العفو.
قال الواحدي: “أصل العفو في اللغة الزيادة، قال تعالى: ﴿خُذِ العفو﴾ [الأعراف:19]، أي الزيادة، وقال أيضاً: ﴿حتى عَفَواْ﴾ [الأعراف: 95]، أي زادوا على ما كانوا عليه من العدد”[1].
ويقول ابن عاشور: “العفو مصدر عَفَا يعفو إذا زاد ونَمَا قال تعالى: ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا﴾ [الأعراف: 95]، وهو هنا ما زاد على حاجة المرء من المال أي فَضلَ بعد نفقته ونفقة عياله بمعتاد أمثاله”[2].
فالآية هنا تحدد المقدار في الإنفاق بما زاد عن حاجة الإنسان، في قصد واعتدال، بلا سرف ولا تقتير، وحيث كفى الإنسان حاجته فإن واجبا عليه-ديانة وإنسانية ومروءة-أن يسمح بما زاد عن هذه الحاجة، فيدفع به حاجة المحتاجين.. إذ كيف يكون الإنسان إنسانا بارّا بإنسانيته، وفى يده فضل مال أو متاع، وفى الناس من أهله وجيرانه، وقومه، من هو في حاجة إلى بعض هذا المال أو المتاع؟[3].
لهذا جاءت شريعة الإسلام بهذا التوجيه الإنساني الكريم، الذي يصل الناس بالناس، بصلات المودة والرحمة، ويجعل منهم كيانا واحدا متكافلا تتوزع فيهم خيرات الأرض وأرزاق السماء بحكمة وعدل، كما يتوزع الدم من القلب على سائر أعضاء الجسد عضوا عضوا!. وإنفاق العفو الذي لا يضر الإنسان ولا يجور على مطالبه، هو من البرّ بالمنفق والرحمة له، حتى لا يحمله الدافع الإنساني على أن يجاوز الحد فيتحيّف حقّه في ماله، ويجور على نفسه فيما آتاه الله، فيخرج مما في يده جملة، ويصبح في جبهة المحتاجين بعد أن كان في جماعة المنفقين، وتلك حال لا يرضاها الإسلام من المسلم، إذ الإسلام يريد بهذه المواساة الكريمة أن يستنقذ بعض ذوى الحاجات ليقلّ عددهم، وتضمر أعدادهم. وصاحبنا بفعلته هذه، قد أضاف إلى المحتاجين محتاجا، وربما لم يكن بما فعل قد استنقذ واحدا منهم، وإن كان قد أعطى الدواء المسكن لآلام الكثيرين[4].
أما تفاصيل ذلك الإنفاق من العفو فقد حدده النبي عليه السلام في مقام ولاية الأمر لا مقام الرسالة، وهذا يعني أن تقديره سيعود اليوم إلى ولي الأمر أي السلطة التنفيذية والتشريعية في زماننا، ومن حق تلك السلطة الشرعية أن تلزم صاحب المال إن امتنع عن الدفع، لأن في ذلك حقا للمجتمع وهي من تحمي ذلك الحق.
وما ورد من تحديد للإنفاق بـ 2.5% فهو اجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام في مقام ولي الأمر ويكون في الحالة الطبيعية للمجتمع أما إذا احتاج المجتمع -لسبب ما- أكثر من ذلك فيمكن لولي الأمر (السلطة التنفيذية والتشريعية) أن يرفع تلك النسبة ضمن دائرة العفو بحيث لا يسبب ضررا لصاحب المال، ولهذا قال بعض الفقهاء قديما وحديثا بأن في المال حقا سوى الزكاة، ويقصدون بذلك حق دائم، وهو ما روي عن مجاهد والشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق [5]، فإذا كان ما أنفقه صاحب المال قاصرا عن سد احتياجات المجتمع فيكون لازما عليه أن يستمر في الدفع من ذلك العفو، خاصة إذا حصلت ظروف استثنائية في مجتمعه، كأن تحدث إحدى الكوارث الطبيعية التي تدمر بنية المجتمع، وتزيد من حالات الفقر والمجاعة.
ومن يتأمل تصاعد مقدار الإنفاق في الصدقة الواجبة من ربع العشر في التجارة، إلى نصف العشر في الزروع التي لم تسقها السماء، إلى العشر في الزروع التي سقتها السماء، يجد أنه كلما كان جهد الإنسان أكثر كان ما يدفعه أقل، ويمكن أن نفهم زكاة الركاز بالخمس لأن الجهد فيها يكاد يكون غير موجود لذا وصل لـ 20%، وعليه فيمكن أن نفهم من تلك النسب أنها تمثل الحد الأدنى والحد الأعلى للإنفاق، فما بين ربع العشر والعشر هي المساحة التي يجتهد فيها أهل التشريع في زكاة التجارات المعاصرة، فيرتفع كلما زاد المال بدرجة كبيرة وقل فيها الجهد، ويمكن أن يحدد المجلس التشريعي النسبة بحسب تصاعد المال فيتحقق بذلك التوازن والعدالة الاجتماعية في توزيع المال، وهذا من أهم مقاصد توزيع المال في الإسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التفسير البسيط للواحدي ج4ص156.
[3] التفسير القرآني للقرآن ج1ص246.
[4] التفسير القرآني للقرآن ج1ص246.
[5] التمهيد لابن عبد البر (4 / 211، 212) – شرح مسلم للنووي (7/ 71).