أصولنا في الفقه
القرآن الكريم هو المصدر الوحيد. أما السنة فهي الأحكام التي استنبطها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. أو بمعنى آخر إن السنة هي تطبيق الوحي المنزل بواسطة جبريل عليه السلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لذا لا تعتبر السنة مصدرا مستقلا ومنفصلا عن القرآن الكريم. قال الله تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» (الإسراء، 17/ 9).
والقرآن الكريم كتاب مبين بنفسه ومبين لغيره، قال تعالى: « فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» (القيامة، 75/ 18-19). فالآيات القرآنية يبين بعضها بعضا، وعلينا أن نفهم العلاقات الثنائية بين الآيات. ويدعي الذين لا يعرفون تلك العلاقة؛ بأن الآيات محدودة لا تكفي لحل المسائل غير المحدودة؛ بالرغم من قوله تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» ( النحل، 16/ 89).
1. شرح القرآن الكريم بالقرآن الكريم
قال الله تعالى: «الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (هود، 11/ 1). ذلك أن الآيات القرآنية بعضها محكمات تدل على أحكام قاطعة واضحة. وهي كالفاكهة الناضجة الجاهزة للأكل، يستفيد منها كل من عثر عليها. والبعض الآخر من الآيات القرآنية يقال عنها متشابهات. وقد جعل الله تعالى روابط ومناسبات بين الآيات بالتأويل. فالتأويل: هو ارجاع الشيء إلى مصدره الأصيل. وبه جعل الله تعالى علاقة ثنائية بين مجموعتين أو المجموعات من الآيات.
وقد سمى الله تعالى هذه العلاقة بـ”المثاني” . وتبدأ المثاني بـ “المحكم” و”المتشابه” ثم يأتي بآيتين متشابهتين ثم آيتين أُخريتين متشابهتين. تأتي الآيات في الموضوع مثنى ورباع وسداس وثمان وهلم جرا. ونصل في الموضوع إلى معانٍ دقيقة حسب كثرة الآيات الموجودة فيه. قال الله تعالى: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» (الزمر، 39/ 23).
المتشابه؛ يطلق على شيئين بسبب وجود التشابه والتماثل بينهما. وما تكرر مرتين فمرتين يقال عنه مثاني. المتشابه والمثاني هما من خصائص الآيات القرآنية. يقال إن الآيات كلها متشابهات لمشابهة بعضها بعضا. ويمكن النظر للآيات في مجموعتين وكل مجموعة منهما تعتبر مثانية للأخرى. أي أن المجموعة الثانية تشبه المجموعة الأولى كأنها متكررة.. وهذا معنى قوله تعالى: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ».
والوصول إلى تأويل الآيات – أي فهم المناسبات والعلاقات الثنائية بينها – وشرحها على هذا الأسلوب، هي كاستخراج المعادن من الأرض وتصنيع الآلات المختلفة منها، ولا شك أن هذا العمل يحتاج إلى من العاملين. وكذلك نحن بحاجة إلى لجنة مكونة من العلماء المتخصصين في مختلف العلوم لدراسة القرآن الكريم . يقول الله تعالى: «كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (فصلت، 41/ 3).
وكلمة ” قرآنا عربيا” في الآية، تدل على ضرورة أن يوجد في اللجنة من نبغ في علم القرآن والعربية. كما أن الموضوع قيد الدراسة يحتاج إلى المتخصيين فيه. وعلى سبيل المثال: حين ندرس الآيات المتعلقة بالإقتصاد، لا بد وأن يتواجد في اللجنة من نبغ في علم الإقتصاد. ويدل على ذلك قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (آل عمران، 3/ 7).
ونرى من الضروري الوقوف على كلمة “التأويل”: فهو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه[1]. وهذا مبين في القرآن الكريم في قوله تعالى: «سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا» (الكهف، 18/ 78).
وتفصيل ذلك؛ أن موسى وصاحبه، وهو الخضر[2]، انطلقا لما قبل الخضر اصطحاب موسى معه، واشترط الخضر على موسى على أن لا يسأله عن شيء ينكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، فركبا في السفينة. فلما استقلت بهم السفينة في البحر، ولجت أي: دخلت اللجة، قام الخضر فخرقها، واستخرج لوحًا من ألواحها ثم رقعها. فلم يملك موسى عليه السلام نفسه إلا أن قال منكرًا عليه: « أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا». فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط المتفق عليه: « أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا » يعني وهذا الصنيع فعلته عن قصد، وهو من الأمور التي اشترطت عليك ألا تنكرها عليّ ، لأنك لم تحط بها خبرًا، وفي حقيقة الأمر هو مصلحة ولم تعلمها أنت. قَالَ موسى: «لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا» أي: لا تضيق عليّ وتُشدد علىّ؛ ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كانت الأولى من موسى نسيانًا”. « فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا » ثم انطلقا بعد ذلك، «حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ» فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره إنكارا أشد من الأول، وبادر فقال: «أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً» أي صغيرة لم تعمل الحنث، ولم تحمل إثمًا بعد، فقتلته؟! «بِغَيْرِ نَفْسٍ » أي: بغير مستند لقتله « لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا » أي: ظاهر النكارة. «قَالَ » الخضر «أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» فأكد أيضًا في التذكار بالشرط الأول؛ فلهذا قال له موسى: « إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا» أي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة « فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا » أي: قد أعذرت إليّ مرة بعد مرة. «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. أي: لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانًا. فأجاب الخضر قائلا «… هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا». فبدأ يبين سبب ما حدث «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا» (الكهف، 18/ 79-82).[3]
وحين ظهر تأويل ما حدث؛ أي المواضيع المتعلقة بها ذهبت حيرة موسى عليه السلام.
ويطلق التأويل كذلك على تعبير الأحلام. فهناك تشابه بين ما يرى الإنسان في الأحلام من الرموز وما يحدث في واقع الحياة. والذي يعبر عن الأحلام يعتمد على هذا التشابه؛ فيقيم العلاقة بين الرموز التي يراها الإنسان في المنام والأحداث الواقعية فيصل إلى النتائج الصحيحة. وهكذا عبر يوسف عن رؤيا الملك حين كان في السجن.[4]
وتستعمل كلمة “التأويل” فيما يتعلق بيوم القيامة. لأن كل الأحداث مرتبطة بيوم القيامة. وقد أنذر الناس في الكتب السماوية بهذا الإرتباط. ومن لم يهتم بهذا الإنذار خسر في حياته الأبدية.[5]
ومن المعلوم أن التأويل يشمل ناحتين في الحدث أحداهما الظاهر المشهود لدى كل الناس والآخر خلفية الأحداث المرتبطة بها، وهذه هي الأساس في كثير من الأحداث. والخلفية الأساسية في قصة الخضر هي الخلفية التي ما عرفها موسى عليه السلام من ظاهر الأحداث. ولا يمكن استيعاب حقيقة الأحاداث من ظاهرها بدون معرفة خلفيتها. وهكذا لم يستطع موسى عليه السلام أن يعرف الحقيقة لعدم معرفته خلفية الأحداث.
ونفهم مما سبق بأن التأويل هو معرفة خلفية الأحداث بمعرفة الربط بينهما. كما أننا نبحث فيه وجه التشابه بين ظاهر الأحداث وما نعتبره خلفية لها.
والمتشابهات هي الأشياء التي توجد بينها وجوه الشبه. كالآيات المتشابهات فوجوه الشبه موجودة بينها. فهي يشبه بعضها بعضا، والآية التي تبين الموضوع الأساسي يقال عنها محكمة؛ وقوله تعالى: «.. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ» يعني الذي يأول المتشابهات إلى المحكمات هو الله تعالى. ولا يمكن لأحد فعل ذلك إلا الله. وقد جعل الله تعالى التشابه بين المحكم والمتشابه، ليسهل لنا الوصول إلى تأويل الآيات. والذي يغفل هذه العلاقة بين الآيات فإنه يؤول الآيات حسب هواه، وإذا فعل ذلك ابتغاء الفتنة يأثم. كما قال الله تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ »
والمتشابه يطلق على كل من الآيتين المتشابهتين. وللوصول إلى المعنى المقصود من الآية، يجب أن نأخذ الآية مع متشابهاتها وإلا سيحصل العدول عن المعنى الحقيقي المراد، وربما يفهم من الآية معنى يختلف تماما عن المعنى المراد. فقطع الآيات عن متشابهاتها وأخذها منفردة يسبب في إضلال الناس بإسم الدين. ولا يقوم به إلا من كان في قلبه زيغ يبتغي الفتنة في المجتمع الإسلامي. قال الله تعالى: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا».
والله هو الذي جعل بين الآيات مناسبات وعلاقات ثنائية بحيث تشبه بعضها البعض، وربط المحكم بالمتشابه والمتشابه بالمحكم، و بين تأويله. ونحن لا نقوم بتأويل الآيات بل نحاول أن نفهم الآيات بالرجوع إلى المناسبات والعلاقات الثنائية بينها.
أما الذي اهمل المناسبات والعلاقات الثنائية بين الآيات، قد استنبط من المحكم، والمتشابه، والتأويل والمثاني، معاني تختلف عن المعنى المقصود من الآيات؛ وهو استنباط خاطئ وقع فيه كثير من المفسرين والفقهاء كما هو موجود في كتب التفسير والفقه. كما أن إهمال المناسبات بين الآيات قد أدي إلى تجريد السنة النبوية عن القرآن الكريم، أي عدم اعتبار الأحاديث بأنها أحكام مستنبطة من القرآن الكريم. وبهذا عدت السنة النبوية مصدرا مستقلا إلى جنب القرآن الكريم؛ فزاد الفصل بين السنة النبوية والقرآن الكريم. كما أن هذا الفصل جعل البعض يزعم بأن القرآن الكريم ينظم ساحة والسنة النبوية تنظم ساحة أخرى أو أنهما يحملان معاني متضادة. وهنا ظهرت مصيبة كبرى ألا وهي أخذ الحكم المستنبط من الحديث المخالف للآية وترك الآية الكريمة وراء الظهر. ونحن نريد في هذا البحث أن نبين حقيقة من الحقائق الهامة التي غابت عن أعين الناس؛ وهي أن المصدر الوحيد هو القرآن الكريم. أما السنة النبوية فهي ما استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم أو هي طريق تبليغ الوحي منه صلى الله عليه وسلم. فالسنة تبين كيفية تطبيق الوحي. وما يخالف القرآن من السنة إما أنها لم تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أننا لم نفهم الموضوع على شكل صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة … الخ؛ خير مثال في ذلك. وسنقف على هذا الموضوع إن شاء الله.
2. ما استنبطه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من القرآن الكريم
السنة تابعة للقرآن الكريم لأنها ما استنبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. قال الله تعالى: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ » (الأحقاف، 46/ 9).
وفي آية أخرى يقول الله تعالى: « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (النساء، 4/ 105). وكل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من حركات وأفعال وأقوال وكل تطبيقاته أسوة حسنة لنا؛ كما بين الله تعالى ذلك بقوله: « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» الأحواب، 33/ 21).
وعلى هذا نقول بأن السنة: هي أحكام صحيحة استنبطها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، وهي خالية عن الخطأ، لأنه لو وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطأ نبهه الله تعالى وصححه. لذا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام المستنبطة تعتبر حكمة. ومن المعلوم أن الرسول قد أرسل ليعلم القرآن والحكمة. كما أخبر الله تعالى بقوله: « لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» (آل عمران، 3/ 164).
فيجب عدم فصل السنة عن القرآن الكريم. لأنه يوجد علاقة وثيقة ومناسبات قوية بين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. وهناك أحاديث كثيرة قد تركت بسبب مخالفتها ظاهر الآيات القرآنية. ولكن يرتفع الإشكال حينما نعرف علاقتها بالآيات. وهذا أسلوب قويم وله دور مهم في معرفة الأحاديث الموضوعة، حيث نُقَوِّمُ الأحاديث بعرضها على الآيات القرآنية فنميز السليم من السقيم. ولكن يجب التريث في الحكم بأن حديثا ما موضوع أو ضعيف، لأنه ليس من السهل الوصول إلى آية لها علاقة بهذا الحديث. وحين نطالع أراء المذاهب في “الربا” مطالعة دقيقة نتبين أهمية هذا الأسلوب.
3. الإستفادة من الكتب السماوية السابقة
وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بدين واحد، فالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين جميع الأنبياء والرسل قبله، فأكثر آيات القرآن الكريم هي نفس ما أوحى الله تعالى إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ» (الشورى، 42/ 13).
أما الآيات التي نزلت على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاصة فهي تشتمل على أحكام مخففة. قال الله تعالى: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة، 2/ 106).
والنسخ في كلام العرب هو النقل، كإكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف والأَصل نُسخةٌ والمكتوب عنه نُسخة لأَنه قام مقامه؛ أو هو تبديل شيء بشيء.[6] وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً. وبمعنى آخر أن القرآن الكريم قد نسخ الكتب السابقة كلها. هو كنسخة نهائية مصدقة من الله تعالى. فالإتباع للقرآن الكريم هو اتباع للتوراة والإنجيل وكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. قال الله تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف، 7/ 157).
ويمكن الإستفادة من الكتب السابقة في معرفة أحوال أهل الكتاب؛ لأن ما جاء في حقهم مفصلا في الكتب السابقة جاء في القرآن الكريم مختصرا؛ كما يبصرنا بأسلوب التعامل مع أهل الكتاب فيما يتعلق بعقائدهم الإيمانية وبحياتهم الإجتماعية والسياسية والإقتصادية. قال الله تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران، 3/ 64).
كما نعرف من الكتب السابقة أحوال الأقوام السابقة. قال الله تعالى: «مَا آَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الأنبياء، 21/ 6-7).
والتوراة اكبر حجما بالنسبة للقرآن الكريم، فيها تفصيلات ما جاء في القرآن موجزا. ونستفيد منها في فهم بعض الموضوعات المتعلقة بأهل الكتاب. وعلى سبيل المثال فقد جاء في التوراة أنه كان في المجتمع اليهودي الأول عجلا يسمى أيبس. وفي سورة البقرة يأمر الله تعالى اليهود أن يذبحوا بقرة؛ ولكن اليهود كانوا يتجنبون ذبحها ويبحثون عن أسباب تخلصهم من الذبح. فلو عرفنا ما ذكر في التوراة في هذا الموضوع لسهل علينا الفهم. ونعرف كذلك جيدا لماذا عبد اليهود العجل حين ذهب موسى لميقات ربه. كما نعرف حكمة إراقة الدم في عيد الأضحى المبارك.
ويدل على ذلك قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ: خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قُلْ: بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » (البقرة، 2/ 93).
وكلمتا “سمعنا وعصينا” بمعنى “سمعنا و تمسكنا بالقوة” غير أن كلمة “عصينا” قد فسرت في كتب التفسير بمعنى “العصيان”، فأشكل على كثير من المفسرين فهم الآية، لأنه لا يمكن أخذ الميثاق على العصيان. وإذا نظرنا التوراة نجد أن كلمة “عصينا” بمعنى التمسك بالقوة، وهو أحد معاني هذه الكلمة. (ومن أراد المزيد يرجى الرجوع إلى موضوع “التمسك بالقوة والعصيان”).
ومن خلال المطالعة في الكتب السابقة نعرف الكيفية والكمية في تصديق القرآن إياهم. وهي أهم الجوانب في الإستفادة من الكتب السابقة. كما يمكن بذلك التحرز مما أضيف إليها بأيدى الناس.
4. أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن
قال الله تعالى: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (إبراهيم، 4/ 14).
اللغة العربية لها أهمية بالغة في فهم القرآن الكريم، لأنه نزل بلسان عربي مبين. فقد كثرت اليوم تطبيقات خاطئة لقواعد اللغة العربية. وما قيل في تفسير الآية السابقة لخير مثال على ذلك. حيث إن المفسرين قالوا فيها: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ (اضلاله) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (هدايته) وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » بارجاع فاعل “يشاء” إلى لفظ الجلالة. أي أن المشيئة من الله فقط، ولا دخل للعباد في موضوع الهداية والضلالة. وهنا علينا أن نطرح سؤالا وهو: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا ارسل الله كل رسول بلسان قومه ليبين لهم، وما هي الفائدة من بيان الرسول لهم بلسانهم؟ وهل يصح هذا الأمر التناقضي أن يكون كلام الله وهو العزيز الحكيم؟
ومنشأ التضاد إرجاع الضمير المستتر في “يشاء” إلى لفظ الجلالة، خلافا للقواعد اللغوية. والصحيح أن الضمير المستتر في “يشاء” يعود إلى “من” القريب. وليعود الضمير إلى البعيد لا بد من قرينة توجب ذلك ولا قرينة هنا. والتفسير الصحيح للآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء (أي يصيب الضلالة) ويهدي من يشاء ( يصيب الهداية). أي أن العبد هو الذي يختار الهداية أو الضلالة. والله تعالى خلق الناس وأعطى لهم حرية الإختيار، لذا يستحقون الثواب أو العذاب على ما يختارون. قال الله تعالى: « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً» (الإنسان، 76/ 1-5).[7]
5. القرآن الكريم وعلاقته بالفطرة
الفطرة، تعني مبادئ وقوانين الخلق والتغيير والتطور، وهي التي تكوِّن البِنيةَ الأساسية للكائنات. أي أن السماوات والأرض والبشر والحيوان والنبات وغيرها من الموجودات تتكون وتعمل وفق تلك القوانين والمبادئ. كما أنها المبدأ الأساسي في العلوم والتكنولوجيا والعلاقات الإجتماعية، ومخالفة الفطرة يفسد التوازن الإجتماعي. قال الله تعالى: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » (الروم، 30/ 41).
«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » (الحج، 22/ 18).
والذي جعل الإنسان يخالف الفطرة هي المنافع والأمال والرغبات. وإلا فإن الإنسان ينزعج بمخالفته للفطرة وهذا في بداية الأمر، ثم يتعود ويأخذ طبعا جديدا فيبدأ يرتاح ويتلذذ بفعل ما يخالف الفطرة. وأحيانا تلوح إمارات الإنزعاج عليه، فهو يعلم أن تصرفاته تخالف الفطرة، ولكنه يتجنب المحاسبة النفسية ويهرب إلى رغباته المأمولة.
ونعرف الفطرة من آيات الله المنشورة في الكون، فآيات الله ليس محدودة بكتابه المنزل أو المسطور. وهي موجودة في كل مكان وزمان.[8] قال الله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت، 41/ 53).
والمعرفة التي نحصل عليها من خلال الدراسة في آيات الآفاق والأنفس، نستحضرها في أذهاننا ونجعلها مستعدة للإستفادة منها. وهذه المعرفة تسمى «الذكر» واستحضارها في الذهن يسمى أيضا «الذكر»[9] وتلك المعرفة متناسبة في أتم التناسب مع كتاب الله تعالى. لذا كل من يقرأ القرآن الكريم ممن نسميهم بعلماء الطبيعة يحصل لهم الثقة والطمأنينة عند مقارنتهم آيات القرآن الكريم بما درسوا من الظواهر الطبيعية.
وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى التذكر. والتذكر هو تنشيط وتفعيل ما هو موجود في الذهن. وعندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه «أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ» (الأنعام، 6/ 80). معناه؛ ألا تقارنوا ما قلته لكم بما عندكم من المعارف التي حصلتم عليها من خلال دراستكم لطّبيعة، فتعرفوا ما ارتكبتم من الخطايا، فتعودوا إلى رشدكم. فهذه دعوة لهم إلى المحاسبة النفسية.
والذكر كذلك اسم مشترك للكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء. قال الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » (الرعد، 13/ 28).
وقال تعالى عن القرآن الكريم: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » (الحجر، 15/ 9).
فالقرآن الكريم، فطرة فصلت من لدن حكيم خبير. قال الله تعالى : «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، 30/ 30). بعض آيات الآفاق والأنفس لا يعلمها إلا المتخصصون والخبراء؛ قال الله تعالى : «وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» (الذاريات، 51/ 20-21). ولو أن علماء الرياضيات والتقنيات قرأوا هذه الآيات (الآيات الكونية) جيدا، وبذلوا الجهد لكشفوا ما في الآيات من القوانين، وبالتالي فإن ما يقوم به العلماء هو كشف ما هو كامن في الطبيعة وليس اختراعا لشيء جديد وهذا هو المقصود من اتباع الفطرة. كذلك من الإجتماعيين الأخصائيين من يكشف عن تلك القوانين بقراءته لتلك الآيات، ومع ذلك فإنّ البعض منهم يحاول إعطاء المجتمع صورا خاصة على حسب هواهم. وهذا الموقف منهم يؤدي إلى التطبيقات المخالفة للفطرة؛ فتظهر آثارها السيئة بعد حين، وتفسد التوازن الإجتماعي والإقتصادي والسياسي. وبالتالي فإن الضرر الذي يترتب على مخالفة الفطرة قد يكون جد عريض ومستمر على مدى العصور. والنتائج المعرفية التي وصل إليها العلماء، يمكن استعمالها خلافا للفطرة لإفسادها وإفساد البيئة من حولنا، كما نعيش اليوم من مفاسد بيئية من جراء مخالفة الفطرة، وتعدي الحدود والإبتعاد عمّا جاء به القرآن الكريم من الفطرة السليمة.
إنّ كلَّ ما جاء به القرآن الكريم متناسب مع الفطرة تمام التناسب، فلا خلاف بينهما؛ لأن الإسلام هو دين الفطرة. فيستفاد من الفطرة في فهم القرآن، كما يستفاد من القرآن الكريم في معرفة الفطرة. ومظن الخلاف بين القرآن الكريم والفطرة هو عدم فهم القرآن الكريم على شكل صحيح، وعدم رعاية الروابط والعلاقات بين القرآن الكريم والفطرة. والأمثلة على ذلك كثيرة. ويكفينا مطالعة موضوع «الطلاق في القرآن الكريم»[10] بمقارنة ما قاله العلماء فيه.
[1] المفردات للراغب الاصفهاني، مادة: (أول).
[2] ولم يذكر في القرآن اسم صاحب موسى إنما ذكر بأنه عبد صالح. وروي اسم “الخضر في البخاري. (البخاري، علم 44).
[3] تفسير ابن الكثير، عند تفسير الآيات 79-82 من سورة الكهف.
[4] انظر من الآية 43 إلى الآية 49 من سورة يوسف12.
[5] انظر؛ الأعراف، 7/ 52-53؛ والنساء، 4/ 59.
[6] لسان العرب لإبن منظور، مادة : (نسخ) بيروت، 1410/ 1990. (بالتصرف).
[7] يذكر في القرآن الكريم كلمتي “الإرادة والمشيئة” مع مشتقاتهما المختلفة، ويوجد بينهما الفرق في المعنى، فالإرادة هي طلب شيء ، أما المشيئة هي الطلب والإيجاد. وكلمة المشيئة إذا أسندت إلى لفظ الجلالة “الله” كان معناها طلب الشيء وإيجاده. وهي من العبد الطلب والإصابة. وتحقق المشيئة بالنسبة للإنسان متعلق بالأسباب، علما بأن موجد الأسباب هو الله وحده، فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن”. وإرادة الشي لا يلزم تحققه على عكس المشيئة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «وَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً» (النساء، 4/ 28). و تتحقق إرادة الله تعالى بقوله “كن” وهي بهذه الحالة بمعنى المشيئة أي إيجاد الشيء. قال الله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» ( يس، 36/ 82).
وعلى هذا فمعنى الآية: أن الله تعالى أرسل الرسل إلى الناس بلسانهم ، ليفهموا منهم ما أراد قوله لهم، وليوضحوا لهم ما أرسلوا إليهم به، لتقوم عليهم الحجة، وينقطع العذر. وبعد أن يقوم الرسل بمهمة الدعوة والإيضاح والبلاغ، وإقامة الحجة على الناس، يضل الله من يشاء أي من أتى بأسباب الضلالة واختارها على الحق والهدى، ويهدي من يشاء أي من بذل جهدا للهداية وأتى بأسبابها إلى صراطه المستقيم ، والله هو العزيز الذي لا يقهر ، ما شاء كان، وهو الحكيم في شرعه وأفعاله.
[8] انظر في هذا: آل عمران، 3/ 58؛ الأعراف، 7/ 63؛ الحجر، 15/ 6، 9؛ النحل، 16/ 44؛ الأنبياء، 21/ 2، 50، 105؛ الفرقان، 25/ 18؛ يس، 36/ 1؛ ص، 38/ 8؛ القمر، 54/ 25.
[9] الراغب الاصفهاني، المفردات لألفاظ القرآن ، ما دة: (ذكر).
[10] مفاهيم ينبغي أن تصحح
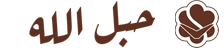


تعرفت حديثا على هذا هذا الموقع فوجدت فيه علما غزيرا، وكنت لا اتفق معكم في بعض ما تطرحونه ومع ذلك لا يملك الشخص الا ان يحترم رأيكم لانكم لا تصدرون الاحكام من جزافا وانما تستندون الى القرآن الكريم. يجب ان تتضافر الجهود من أجل المضي قدما لتطوير المنهج الذي تنطلقون منه واتمنى ان يشارككم العلماء والمفكرون هذه الاراء لعلنا نصل الى مستوى من الرقي والتقدم يستحقه من يؤمنون برسالة القرآن الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الآية التالية :
{وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا }
هناك تساؤلات :
1-هل الخضر نبي ام لا واذا كان نبينا ما الدليل على ذلك ؟
2-واذا لم يكن الخضر نبيا كيف يجوز لنبي أن يأتمر ويتبع شخص عادي ؟
3-هل يحق لنبي أن يقتل غلام لمجرد الخشية من أن يرهق والديه طغيانا وكفرا وهل هذا الحكم الذي طبقه الخضر كان من ذاته ام كان يتبع شرعا ما ؟
واذا كان هناك تفاصيل تبين الموضوع أكثر ارجوا منكم توضيحها وبيانها وجزاكم الله خيرا .
ورد في سورة الكهف في الآيات 60_ 82 قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح (الخضر عليه السلام)، والعبد الصالح هو ملك أرسله الله تعالى إلى موسى على هيئة إنسان ليعلِّمه ما لم يستطع تحصيلُه من معلِّمٍ بشر، وكيف يكون معلمُ كليمِ اللهِ بشرا؟ هذا مستحيل عقلا.
الملَك سيعلِّم موسى عليه السلام دروسا في الصَّبر، واحتمال الأذى، والتضحية، والثقة بوعد الله تعالى:
ينطلق موسى مع الخضر، فما إن يركبا السفينة حتى يقوم الخضر بخرقها، وكانت السفينة لمساكين يعملون في البحر، وهذا الرجل الذي ينبغي أن يكون عونا للمساكين يخرقُ سفينتهم، والعجيب أن أصحاب السفينة لم يحاولوا ثنيّه عن فعلته الظاهر ضررها بهم، حتى إنهم لم ينكروا عليه ولم يعاتبوه بالقول لقد أكرمناك وحملناك وها أنت تخرق سفينتنا، كلَّا لم يقولوا شيئا من ذلك، وربما موقفهم هذا دفع موسى إلى مزيد من الإنكار على الخضر ما فعله.
ثم ينزلان من السفينة فيمشيان في الطريق؛ فإذا بهما يلتقيان بغلام، ليبادر إليه العبد الصالح فيقتله دون سبب ظاهر، ولا عجب أن يغضب موسى من قتل غلامٍ بريء لم يفعل ما يوجب قتله، لكن العجيب أن أيّا من أولياء المقتول لم يطالب بدم الفتى، ومرّ الأمر كأنه لم يكن، ولم يتغير شيء سوى ازدياد دهشة موسى واقتراب نفاد فرص بقائه مع الخضر.
ويستمر الخضر في غرائبه عندما دخلا القرية التي رفض أهلها إكرامهما ولو بكسرة خبز ليبادر الخضر إلى إصلاح جدار متصدع آيل للسقوط. ويستغرق موسى بحيرته من أمر الرجل، فقد خرق سفينة من حملوهما وقتل غلاما بريئا، وها هو يقيم جدارا في بلد لم يكرمه أهله. والأعجب أن هذا العبد الصالح قد أقام الجدار دون نقضه، ومعلوم أن الجدار المتصدع الآيل للسقوط لا يقوَّمُ، بل يُنقض ويُبنى من جديد.
لقد نفدت فرص موسى كلها عند احتجاجه على تقويم الجدار، لأن موسى قد اشترط على نفسه عندما قتل الغلام أنه إن سأله _معترضا_ عن شيء مرة أخرى فستكون خاتمة رحلته معه.
ولم يصبر موسى أكثر كي نتعلم المزيد من تلك الرحلة، وقد تمنى نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان صبر بقوله: (وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ)
إن من حق التلميذ على المعلم أن يبين له أين أخطأ، والخضر لم يفتْه ذلك، فقد بيّن لموسى السبب في عدم قدرته على الصبر، وهو عدم معرفته الخلفية الكامنة لتلك الاحداث، وهو المعروف بالتأويل، لذا شرع العبد الصالح بتأويل الأحداث قبل افتراقهما، وكانت دهشة موسى تتبدد شيئا فشيئا كلما عرف خلفية كل واحدة من تلك الاحداث.
ولا شك أن الملَك (الخضر) قد أدى دوره كمعلم لموسى ولمن قرأ قصتهما إلى قيام الساعة. وقد ذكرتُ في بداية حديثي عن القصة الدروسَ المستفادةَ منها، وأضيف عنصرا غاية في الأهمية، وهو تعليم التأويل ، وهو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، وذلك بربط الأحداث بما تؤول إليه، وقد جاءت عبارة الخضر صريحة بذلك:
{قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} (الكهف، 78) ثمّ بين له أخيرا أنه عبد مأمور بما فعل {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} (الكهف، 82)
جزاك الله خيرا اخي جمال على التوضيح