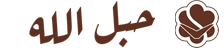السؤال:
لدي سؤال هام، انا أؤمن بأن القرآن يُفسر من داخله، ولذلك فإني معكم تماما في الحديث عن “ملك اليمين” ومعنى “واضربوهن” وقتال المعتدين وغيرها، ولكن يأتي من يقول بأن القرآن نزل بلسان العرب بالرغم أن تدبر كلمة عربي في القرآن لا يمكن أن يعني لسان القبائل العربية.
فإن قلت هذا يقولون إذًا أين المعجم الذي نزل مع القرآن لكي نعرف معاني الكلمات؟
وأن قبيلة معينة عندها كلمة رغدا لذلك استخدمها القرآن… إلخ
والسؤال، بالتأكيد يجب الاستعانة بالمعجم لفهم أصل الكلمات، ولكن هل هذا هو الطريق الأول والوحيد لفهم كلام الله؟ هل علي أن أبحث وأدقق في لغة قريش وقتها أو لغة القبائل وقتها حتى أفهم معنى كلام الله؟
والسؤال الأخير فيما يتعلق بالقول بأخطاء نحوية في القرآن.
أعلم أن علم النحو جاء بعد القرآن ولا يمكن أن نحاكم القرآن عليه
ولكن ماذا نقول في رفع (الصابئون) في سورة (المائدة) بالرغم أن قبلها حرف “إن”؟
قرأت له أكثر من وجه ويقولون أنه كان مستخدمًا عند العرب، ولكن مرة أخرى هل أحاكم القرآن للغة العرب وعليه يجب أن أبحث وأحقق في كلامهم؟
وكذلك النصب مدحا أو ذما كما في (والموفون بعهدهم والصابرين)
وجدت أساتذة لغة عربية يقولون أن النصب مدحا وذما ليس له أصل في اللغة وأن ذلك خطأ قراءة لعدم تطور الخط وقتها.
لقد اختلط الأمر علي، نعم لا يوجد اختلاف معاني بسبب ما ذكرته ولكن كيف أحل هذه المعضلة التي تؤرقني. وشكرا جزيلا
الجواب:
هذا السؤال يحتوي على عدة مسائل من وجوب البحث في المعجم ولغة قريش والقبائل، وهي تدور حول محور واحد ألا وهو سبب وجود اختلافات بين ما هو موجود في كتاب الله تعالى أحيانا مع (ما هو مشهور في كتب النحو والصرف) وتؤول إلى نتيجة واحدة حول ما إذا كان هناك أخطاء نحوية في القرآن الذي يعني بالضرورة الريب والشك في قلب المؤمن.
وخاصة أن الأمر لا يقف عند ما جاء ذكره في السؤال حول اختلاف المواضع الإعرابية لقوله تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ﴾ البقرة (177) وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ..﴾ الحج (17) واختلافها عما ورد في موضع آخر رغم اتفاق الموقع الإعرابي في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ..﴾ المائدة (69)
وقد قال أهل اللغة أن الاختلاف هنا يعود لأسلوب المدح والذم، أو كما قال البعض الآخر أنها جاءت مختلفة الإعراب لجذب انتباه السامع لها أو أنها جملة جديدة مستأنفة أو أنها مرفوعة أو منصوبة على المحل وأيدوا كلامهم بأمثلة على وتيرتيها استعملت عند العرب واستشهدوا عليها بنماذج من الشعر والنثر القديمين.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، أنه إذا وجدت للاختلافات الإعرابية أمثلة ونماذج شعرية تؤكد صحتها، فماذا عن اختلافات أخرى ليس لها علاقة بالإعراب وليس لها استخدامات في كل كتب اللغة وليس لها مثيل من الشعر وأقوال العرب قديمًا أو حديثًا، والأمثلة كثيرة نذكر منها جزءًا يسيرًا – دون الوقوف على الحكمة منها – حتى لا يتشعب الموضوع ويخرج عن نطاقه، فنجد على سبيل المثال لا الحصر:
- اختلاف كلمة (إبراهيم) في سورة البقرة عن بقية سور القرآن كله ومجيئها بالرسم (إبراهــــــم).
- رسم الضمة بدلًا الكسرة في لفظ (عليه) في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ الفتح (10) بخلاف قواعد النحو ما جاء في الكتاب نفسه.
- مجيء كلمة (ننجي) بـــ (ن) واحدة في موضع واحد بخلاف المعتاد في الكتاب نفسه في قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُــجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأنبياء (88)
- مجيء كلمة (أيد) بزيادة (يـــ) في موضع واحد بخلاف بقية الآيات في قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ الذاريات (47) وكأنه تعالى يقول أن قوته وسلطانه لا يشبههما قوة ولا سلطان.
- مجيء كلمة النبيين بياء واحدة في كل مواضعها في كتاب الله تعالى على خلاف كتابتها في كل كتب اللغة: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّـــنَ﴾ النساء (69)
- اختلاف لفظ (جِيء) في القرآن عن كتب اللغة ﴿وَجِائ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ الفجر (23)
- اختلاف أشهر لفظين في القرآن عن كتابتهما في كتب اللغة وهما (الصلاة والزكاة) ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ البقرة (43)
هذا بالإضافة إلى الاختلافات التي بُينت على تعدد القراءات نذكر منها:
- اختلاف قراءة كلمة (مالك) في قوله: ﴿مَلكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ الفاتحة (4) فهي مكتوبة في المصحف بألف خنجرية وهي تقرأ على الأشهر (مالك) و في رواية تقرأ (ملك).
وعلى الرغم من اختلاف اللفظين لكن كليهما لا يناقض بعضه البعض إذ أنه تعالى ملك ومالك يوم الدين.
- اختلاف قراءة: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ البقرة (102) بفتح اللام وكسرها.
وكذلك الاختلافات التي ظهرت بعد التنقيط:
- كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاس﴾ البقرة (219) فقبل التنقيط لا فرق بين لفظ (كبير) و(كثير) إذ أن كليهما يكتب هكذا (كىىر) وما جعل كبير هي الأشهر أن الإثم الكبير جاء من الكبائر ويؤيده: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ..﴾ النساء (31) ولا يوجد في القرآن كثائر.
وقد لا يكون هناك اختلاف في الرسم ولا في الإعراب ولا في التنقيط لكن هناك اختلافًا من نوع آخر في التفسير مترتب على علامات الوقف والوصل فنجده مثلا
- في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ آل عمران (7) حيث اختلفوا هل (الراسخون) معطوفة على لفظ الجلالة أم أنها جملة جديدة مستأنفة؟! وهو ما يترتب عليه اختلاف المعنى حول ما إن كان تأويل الكتاب لله تعالى وحده أم الراسخون يعلمونه كذلك.
والأمر لم يقف عند ذلك وإنما امتد إلى المعاني التي حسم الله تعالى فيها الأمر ونهى المؤمنين عن التأسي والاقتداء بمن كانوا يقولون بعض الكلمات التي تحمل معاني أخرى لسد الطريق أمام التلاعب بالألفاظ وقلب المعاني:
- كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ البقرة (104)
- وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ﴾ النساء (46)
وما زال الاختلاف يدور حول الأحرف المقطعة في بدايات بعض السور ﴿الٓمٓ﴾ البقرة (1) ﴿طسٓمٓ﴾ الشعراء (1) في بداية السور ولم يجزم برأي أحدهم إلى الآن.
والسؤال يتجدد مرة أخرى حول ما أسباب هذه الاختلافات؟ وإلام تؤول؟! أتعني تحريفًا أم أخطاء واردة؟ وهل حقيق بها أن تثير الشك أم أنها تسير بنا نحو اليقين!!
والأهم من ذلك؛ هل هناك إجابات لتلك التساؤلات المتعلقة بالناحية اللغوية من الكتاب نفسه أم أننا أو بمعنى أدق (أنه) – أي القرآن – هو الذي في حاجة إلينا للدفاع عنه وإثبات صحته عن طريق الاستدلال بكتب اللغة التي تشير إلى العصر الذي نزل فيه القرآن لإيجاد مبررات وأعذار نتدارك بها تلك الاختلافات حفاظًا على قدسية الكتاب في نظر المؤمنين به وعدم المساس به بسوء أمام المشككين فيه.
للوقوف على حقيقة الأمر فعلينا أن ندرك أن تلك المسائل ليست وليدة اللحظة ولم تقف عند عصر من العصور، وإنما وجودها منذ العصور القريبة من نزول القرآن والأمثلة عليها كثيرة سواء الاختلافات الخاصة باللفظ أو الإعراب أو القراءات أو النقط، فقد بلغت المئات وأُفردت لها كتب ومجلدات تخصصت في البحث والتدقيق في ألفاظ القرآن وظلت محل اتفاق واختلاف بين النحاة أنفسهم وانقسموا على أثرها إلى مدراس عدة كمدرستي البصرة والكوفة وغيرها من المدارس القديمة والحديثة التي عنيت بألفاظ كتاب الله تعالى وبذل فيها العلماء السابقون والمحدثون جهدًا كبيرًا وقد زخرت بها المكتبة الإسلامية.
ولذا علينا العودة إلى الوراء إلى زمن البعثة لنوجه تلك الهواجس والتساؤلات إلى الكتاب نفسه الذي وصفه منزله بأنه قد أنزله: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ النحل (89) وسوف نسأل ونترك الجواب له.
- ولنبدأ بسؤال، من الذي نزل بالكتاب، وعلى من أنزل؟
يجيب علينا أنه قد: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ الشعراء (193) على رسول كان وصفه: ﴿الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ الأعراف (157) وكلمة الأميّ تعني عدم العلم بالكتب السابقة واستخدمت لاحقا في عدم معرفة القراءة والكتابة.
- يليه، هل تعلّم هذا النبي الأميُّ القراءة والكتابة وتعلم كتب السابقين أم أنه ظل على أميَّته؟
يجيب علينا قوله تعالى ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ….. .الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ العلق (1: 4) فمن المخاطب الأول بتعليم القراءة والكتابة بالقلم؟ أليس الرسول نفسه؟ أم أنه استثنى من الخطاب الموجه إليه بعد أن قيل له (اقرأ)؟!
- يليه، وإذا كان النبي قد قرأ وكتب فهل كتب ودوَّن القرآن حال حياته أم أنه – كما زعموا – مات وتركه منثورًا في صدور الرجال وعلى رقاع الجلود وجذوع الشجر؟ يجيب علينا قوله تعالى:
﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ العنكبوت (48) والمعنى واضح أن الرسول أصبح يقرأ ويتلو القرآن ويخط بيمنه وهو ما لم يكن يفعله قبل بعثته.
وأنه قد بلغ رسالة ربه امتثالًا لأمره: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ المائدة (67).
مما يؤكد تبليع الرسول ما أنزل إليه من ربه قولًا وفعلًا قراءة وكتابة ليترك لنا ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۛ فِيهِۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (2) مكتوبًا منه وبإشرافه على من كتبه معه تحت سمعه وبصره لفظًا ورسمًا وتسمية للسور وترتيبًا لها وللآيات مصداقًا لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَام﴾ المائدة (3) أم أن اليوم الذي كمل فيه الدين قد جاء بعد وفاة الرسول، وأن هذه الآية قد نزلت على الخلفاء الراشدين الذين بلغوا من الرشد والحكمة أكثر من رسولهم ونبيهم الصادق الأمين مما جعلهم يجمعون القرآن خوفًا عليه من الضياع وهو ما غفل عنه رسولهم؟!
- يليه، من هؤلاء القوم الذين بُعث فيهم هذا النبي الأميَّ؟ فهل كان كل أهل مكة من القرشيين بالفعل أهل اللغة والفصاحة بدليل تلك المعلقات السبع التي تتبارز في وصف الليل والخيل والبيداء والنساء والخمر!! تلك هي الأشعار التي جعلناها حكمًا ومرجعًا للحكم على صحة ما جاء في كتاب الله الذي أنزل من فوق سبع سماوات؟!
وهل لهم مؤلفات في علم النحو والصرف نستطيع العودة إليها للحكم على الصحة اللغوية للكتاب الذي أنزل إليهم؟!
يجيب تعالى علينا أنه: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ الجمعة (2)
إذًا فالحكم على فصاحة قوم يترتب على علمهم بكتبه تعالى وليس بشعرهم ومعلقاتهم.
- ما حقيقة القول بأن القرآن الكريم قد نزل على سبعة أحرف كما جاء في الرواية (أن القرآن نزل على حرف واحد وأن الرسول ظل يستزيد جبريل حتى قرأه على سبعة أحرف) وبغض الطرف عن القول الذي لا يليق بقول رسول كريم وكأنه يفاصل ربه ويطلب منه أن ينزل كتابه على أحرف سبعة وكأنه أعلم بخلقه تعالى منه وأدرى بما ينفعهم وما يضرهم – مثلها كحادثة تخفيض الصلوات من خمسين إلى خمس – ولكن السؤال المتبادر إلى الذهن:
هل نزل الروح القدس على النبي وقرأ عليه الآية الواحدة بسبعة أحرف وحدد له لكل قبيلة قراءة؟
وماذا عن القبائل الأخرى، أليس لهم قراءات؟ أم أنه نسيهم؟ أم أن قبائل العرب كانت سبع فقط؟
وماذا عن غير قريش الذين يأتون إلى زيارة المسجد الحرام، وماذا عن غير العرب؟
فإن كانت قريش هم الفصحاء وأن القرآن قد نزل عليهم متحديًا فصاحتهم ولسانهم المبين وأنه نزل مستعملًا نفس الألفاظ التي استعملتها قبائل القرشيين العرب فإننا بهذا الزعم لا نستطيع القول بأن القرآن قد أنزل لغيرهم، وهذا يناقض قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ص (87)، وكذلك فإن التحدي بالإتيان بسورة من مثله الوارد في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ البقرة (23) _يكون قد انقضى زمانه وأن كل الآيات الواردة في هذا الشأن تاريخية خاصة بقريش وقبائلها ولم تعد لها قيمة الآن حتى للقرشيين الذين لم يعودوا يتكلمون ذات اللغة التي نزل بها القرآن.
وفي هذه الحالة يستوجب علينا أن نأتي بكل مؤلفات الشعر الجاهلي لتلك القبائل أصحاب الأحرف السبع التي اشتهرت بالفصاحة والتبيان التي تدور أشعارها حول الخمر والغزل في محاسن النساء وتشن الحروب والمعارك وتقطع الرؤوس ثأرًا من أجل ناقة أو سباق وتستمر إلى سنوات وعقود التي تحتاج إلى المعاجم لفهمها وفك طلاسمها لنجعلها جنبًا إلى جنب لتشرح لنا (تلك الأشعار الجاهلية) مفرداتِ وألفاظ وتراكيب وغريب القرآن الكريم وفهم كتاب رب العالمين الذي قال أنه: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فصّلت (3).
﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ الأنعام (148)
وعلى القائلين بهذا الكلام أن يأتوا لنا بعدد الألفاظ المستخدمة في الشعر الجاهلي التي نزل على غرارها القرآن الكريم الذي ذم أكثر الشعراء: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ الشعراء (225) ونفى تعالى عن كتابه أن يشبه الشعر: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ الحاقة (41) ونفى أن رسوله تعلم كلام الشعراء: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ يس (69).
لعل السائلة الكريمة فهمت الآن كيف ينبغي لها أن تعكس السؤال بأن تسأل هل توصل علماء النحو والصرف والبلاغة إلى فهم وإدراك الحكمة مما جاء في كتاب الله تعالى من ألفاظ وعبارات وهل ألفوا أدبهم وفنونهم من الشعر والنثر على غرار البيان والبديع الذي أنزل الله تعالى؟
وهل قال تعالى ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ الشعراء (195) أم قال (بلسان العرب المبين) وفرق بين المعنيين كبير، إذ لو قال بلسان العرب فإنه يعني نزوله على قوم النبي دون غيرهم من العرب، أما قوله (بلسان عربي مبين) يعني نزوله بأفصح العربية.
ولنضرب على ذلك مثالًا بجامعة الدول العربية حين يصدر عنها مرسومًا، فكيف سيكتب هذا المرسوم؟ هل بلهجة دول الخليج أم بلهجة دول شمال أفريقيا أم بلهجة بلاد المغرب أم بلاد الشام، مع ملاحظة أن كل بلدة تتحدث بلهجة مختلفة عن مثيلاتها في نفس القطر، بل الأشد من ذلك أن البلد الواحد تختلف لهجاته بين كل محافظة ومحلة ومنطقة، وكل تلك اللهجات تندرج تحت التحدث بالعربية، ولكن أكثرهم بعيدون عن اللسان العربي في حديثهم حتى ولو كانوا يفهمونها، ولو كٌتب المرسوم بلهجة أحدهم فلن يفهمه الجميع على أتم وجه؛ ولهذا فإن المرسوم الصادر من تلك الجامعة ينبغي أن يصدر باللسان العربي الفصيح وليس بلهجة بلد معين حتى يتفق على فهمه الجميع.
وهذا بالضبط ما حدث مع كتاب الله تعالى إذ نزل باللغة العربية شديدة التبيان والبيان حتى يشمل الجميع، والاختلافات التي حدثت من القراءات العشر والأحرف السبع ما هي إلا نتيجة حتمة لاختلاف لهجات العرب وقبائلهم، فليست لهجة العربي من بلاد المغرب كلهجة العربي من سكان جزيرة العرب وليس كلهجة العربي من سكان البيت الحرام – وإن كان هؤلاء على دراية واسعة باللهجات لأنهم عمَّار المسجد الحرام الذين تأتي إليهم القوافل التجارية قاصدين زيارة البيت والتجارة من كل حدب وصوب.
وقد ظهرت تلك اللهجات بشكل جلي بعد عقود من نزول القرآن، والسبب في ذلك يعود إلى اختلافهم في نطق الحروف وكتابتها؛ فمنهم من لا ينطق الهمزة ومنهم من يزيدها على الكلام ومنهم من ينطق ويكتب الــ (ع) بدلًا من الــ (ح) فيقولون (عين وليس حين) وهناك اختلاف عند نطق الحروف المتقاربة المخرج كالظاء والضاد والذال والزاي والكاف والقاف، بالإضافة إلى غير العرب الذين لا يستطيعون نطق الحروف العربية كما هي، ونرى ذلك واضحًا في نطق الــ (هــ) بدلًا من الـ (ح) فيقولون (مهمد وليس محمد) والـ (ك) بدلًا من الــ (خ) فيقولن (كالد وليس خالد) لصعوبة نطقها لديهم إذ لا توجد ضمن حروف لغاتهم.
إن القول بالاستدلال بأقوال البشر وضرب الأمثلة من الواقع لبيان معنى عبارة أو جملة جاءت في كتاب الله تعالى أمر وارد ومطلوب لتقريب الصورة وخاصة لغير الدراسين أو حتى للمتخصصين في علوم اللغة، ولكن هناك فرق بين أن تكون تلك الأقوال تساعد على الفهم وبين أن تكون دليلا على صحة القرآن أو أنها تمنحه شهادة صلاحية لعباراته وكلماته التي قال عنها جل وعلا: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الزمر (28)
ومما لا شك فيه أن القرآن الكريم نزل بلسان قريش:
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ..﴾ إبراهيم (4)
ولكنه بالطبع لم ينزل بلهجاتهم التي قد يكون فيها ما هو أقل فصاحة، لأن كلمة عربي في وصف القرآن ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ يوسف (2) تدل على أنه نزل بأفصح كلمات وألفاظ وتراكيب اللغة العربية التي من شأنها أن تُعرب وتفصح وتبين مقاصده وأحكامه.
وذلك بدليل أن أهل مكة اتهموا الرسول بأنه لم يصبح فصيحًا قارئًا معربًا عن تلك الآيات من تلقاء نفسه وأنكروا أن يكون معلمه هو الروح الأمين، بل زعموا أنه يلجأ إلى مُعلم من البشر علمه كل تلك الفصاحة والطلاقة، فجاء الرد عليهم:
﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ، وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ النحل (103)
والذي يعني أنه مهما كان الشخص الذي قصدوه معلمًا للرسول فصحيًا فلن يستطيع أن يعلمه تلك العربية المُعربة عن المعاني والمفصلة والمبينة التي نزل بها القرآن إذ مهما بلغت فصاحته فهو أمام كلامه تعالى أعجمي.
فاللغة هي أداة التواصل ووسيلة التعبير عن مكنونات النفس، ومن هنا فكل لفظ مستخدم في كتابه تعالى له غاية ومقصد يعلم به خالق تلك النفس، وهو يخاطبها بما يمس قلبها ويقنع عقلها، فعربية القرآن وما جاء فيه كفيل بتحقيق تقوى النفس وذكراها:
﴿وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ طه (113)
والقرآن الكريم قول يتسم بالثقل:
﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ المزّمّل (5)
وهذا الثقل يتطلب أن يكون مادة خصبة للبحث والتدقيق والتأليف بكل المستويات العلمية، ولا يقتصر ثقله على علماء اللغة فحسب إذ يتنافس في علومه وكشف آياته علماء الطب والفلك والجيولوجيا والفضاء… إلخ
ونحن نرى كل يوم أبحاثًا لا حصر لها في تلك المجالات مسترشدة بهديه؛ فمنها ما أثبتت التجارب صدقها ونجاحها، ومنها ما أثبت العلم نفسه فشلها وعدم صحتها، وكل ذلك دون الإساءة للكتاب، وإنما باب الاجتهاد مفتوح على مصارعيه فقد يصيب المجتهد وقد يخطئ.
والمسألة نفسها على المستوى اللغوي للقرآن إذ تشعبت فيه الدراسات والبحوث؛ فمنها ما أظهر جزءًا من جماله وبديعه وبيانه ومنها لم يرتق إلى عظمته.
وعدم فهمنا لمعنى كلمة أو عجزنا عن إدراك الحكمة في كتابه تعالى لا يحملنا على الشك والريب أنه من عند الله تعالى أو أنه قد حدث فيه أخطاء لغوية، وذلك بدليل قوله تعالى:
﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يونس (37)
فالآية واضحة في أن القرآن لا مجال فيه للتحريف والافتراء لأن تفصيله وتفاصيله الدقيقة لا ريب أنها من رب العالمين، ومن يدعي وجود أخطاء في القرن فقد كذب بما لم يحط به خبرًا:
﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ يونس (39)
فلا حاجة لشهادة أحد له بعد شهادته جل وعلا:
﴿لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ، أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ النساء (166).
وأن السبب الحقيقي وراء هذه الاختلافات وتشعبها هو ما فعله أكثر أهل اللغة حين يستشكل عليهم فهم بعض العبارات أو التراكيب في القرآن، فبدلًا من العودة للقرآن نفسه الذي يفصل بعضه بعضًا فقد لجأوا إلى البحث عن استخدامها في الشعر أو النثر قديمًا عند العرب، وكأن ذلك الاستخدام قد أجاز لله تعالى القول بها في كتابه، وهذه المسألة تطرح سؤالًا هامًا، ماذا لو لم نجد اللفظ أو التركيب مستعملا منذ القدم؟ فهل نحكم بعدم جواز مجيئه في كتاب الله تعالى!!
ولهذا نقول بأن القرآن يأتي أولًا ثم علم اللغة ثانيًا، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى:
﴿الرَّحْمَٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ الرحمن (4)
فقد جاء علم القرآن حتى قبل خلق الإنسان ثم بعد ذلك عُلم منه البيان.
ولكن ما يحدث غالبًا هو العكس، وقلة قليلة من تستشهد بالقرآن على كتب اللغة فتجيز استعمال ما جاء فيه ليكون دليلًا على صحته وفصاحته عند الاستعمال، وربما يعود هذا الاعتقاد بأن القرآن الكريم عندما نزل فقد نزل على أهل الفصاحة واللغة والبيان وأنه قد تم شرحه وتفسيره وتفصيله من قبل علماء وفقهاء ذاك العصر والعصور التي تلته أي زمن الصحابة والتابعين، وأنهم قد قاموا بيبان كل ما استشكل من الآيات فلا حاجة بعدئذ لعلماء ومفكري العصور المتأخرين وصولًا إلى زماننا الحالي، وهذا ظلم كبير لكتاب الله تعالى الذي لا يقف إعجازه على زمن النبوة وما تلاه من أزمان قريبة، إذ الخطاب فيه موجه للناس إلى أن تقوم الساعة:
﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فصّلت (53)
ولن تستطيع أيدي المحرفين أن تصل إليه بوعد رب العالمين:
﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ فصّلت (42)
يخاطب القرآن كل من ارتاب أنه من عند غير الله تعالى أو أنه قول البشر بما يلي:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ البقرة (23)
فكل إنس وجان مخاطب بهذا الحديث حتى قيام :
﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ الإسراء (88)
فالقرآن الكريم ليس في حاجة إلينا لحفظه بعدما تكفل من أنزله بحفظه:
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الحجر (9)
وإنما نحن الذين في حاجته لحفظنا من اتباع خطوات الشيطان، وقد نبأنا العليم الحكيم أن نوره تعالى لم ولن يطفأ وسوف يظل الملجأ وسبيل الهدى ما دامت السموات والأرض:
﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ الصف (8)
﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ الصف (9).
إن اختلاف الإعراب لبعض الكلمات قد يتولد منه معان جديدة تظهر جانبًا من جوانب الإعجاز اللغوي فيه، والاختلافات التي تتفق مع معنى وسياق الآيات فلا تعارض بينها وهي لا تدعو إلى الريبة وإنما تعين على الاستنباط من طرف أولوا العلم، وقد حذر تعالى من اتباع الشيطان حين يستشكل علينا أمرا جاء في كتابه:
﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ النساء (83)
ومن هنا فلا ينبغي أن يثار الشك في قلب المؤمن، فعظمة القرآن أكبر من أن تهزه أقاويل وشبهات مهما بلغت.
فقد نزل القرآن قولًا واحدًا ﴿قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ وليس أقوالا وأقاويل تناقض نفسها، وذلك من أكبر الأدلة على أنه من عند الله تعالى:
﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ النساء (82)
أما الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق إلى الشيع والطوائف فقد نبأنا تعالى أن رسوله ونحن من بعده لسنا منهم في شيء:
﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ الأنعام (159).
وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة
الموقع: حبل الله www.hablullah.com
الباحثة: شيماء أبو زيد